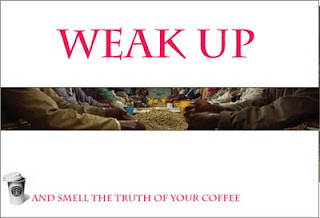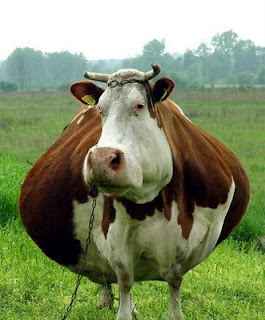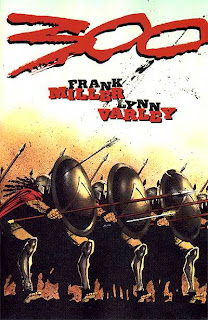-
محمد وعلي
جعفر حمزة*التجارية ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٨م
كانا يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق، ويعملان بشغف لم يغب عنهما للحظة، كانا وما زالا يحبان اهتمامهما المشترك، والذي جمعهما من على صفحات الإنترنت. فتولدت تلك الصداقة التي ما فتأت حتى كبرت وكبر حلمهما معاً، فصار محمد وعلي أكثر من صديقين بل أخوين يشاركان الطعام والأفكار والعمل، فما الجديد في علاقة محمد وعلي؟
قد لا يكون في الأمر جديد بالنسبة لهما، إلا أن كلاً من محمد وعلي من بيئتين مختلفتين، بكل ما للكلمة من معنى، فمحمد يعمل في جهة حكومية ويسكن إحدى المدن، في حين يعمل علي في إحدى الشركات الصغيرة، ويقطن قرية صغيرة. هذا فضلاً عن اختلاف في مذهبهما، والذي لم يكن عائقاً البتة في عملهما وتواصلهما الأخوي المتين أبداً.
ما جمع محمد وعلي هو الإبداع والاهتمام والشغف في العمل المحترف، وكفرا بكل الحواجز التي بينهما، كفرا بوهم الفرق بينهما، وكفرا بوهم المسافة والتقاطيع المبرمجة للسكن، وكفرا بكلام الناس، واستمرا في المضي عملاً وإبداعاً من ٧ سنوات سمان بينهما، وتركا عجل السامري الطائفي والعُرفي وحيداً بعيداً عنهما।
وما إن كفرا بكل ذلك حتى آمنا بما لديهما من قدرة تتزاوج بينهما، ليكون “العالم الافتراضي” وتوابعه من برامج الأبعاد الثلاثية هو “البُعد” الجامع بينهما وبقوة، فاحترفا تلك المهارة في “صناعة” العالم الافتراضي للعديد من الشركات والجهات، فأصبحت لمساتهما بارزة كشابين يافعين اعتمدا على نفسيهما في شحذ تلك المهارة لتكون احترافاً، وتركا بصمتهما في إحدى المسلسلات الخليجية، وغيرها من الدعايات والفواصل الإعلانية، ولم تخل المنتديات المتخصصة في برامج الثلاثية الأبعاد من مشاركتهما والإدلاء بدلوهما فيها.
يعملان بجد وضمن خطة للقيام بمشاريع متعددة مشتركة.هما مصداق عملي بعيداً عن أي تنظير يتم طرحه هنا أو هناك في مجال نبذ الطائفية والتي تخمت قاعات المؤتمرات والصفحات من الكلمات والخطب والمقالات، هما -ومن على شاكلتهما- أنموذج وطني يستحق الافتخار بهما، لأنهما آمنا بأن تخصصهما وعملهما المحترف فوق كل اعتبار مناطقي وطائفي وعرقي، فتولّد من بينهما إبداع مشترك مميز.
هما مثالان يضربان عرض الحائط واقعين سوداويين، واقع تمارسه بعض الجهات الحكومية من خلال تمييزها الوظيفي وواقع يرسمه العُرف يُبعد من كان في “الفئة” الأخرى في المجتمع عن أي عمل مشترك بغض النظر عن إبداعه .
وبين نار التمييز الحكومي والإبعاد الشعبي قد يموت الإبداع أو ينكمش، وذلك بعد أن ضاقت بهذه النماذج الوزارات التي بدأت تُصنف مثل الكانتونات لتكون هذه الوزارة للفئة الفلانية وأخرى لتلك الفئة، وبعد أن انسحب فيروس التمييز إلى القطاع الخاص، والذي يجب أن يكون الأبعد عن مثل هذا الداء العضال، أصبحت المساحة المشتركة الممكنة والتي لم يقترب منها ذلك التمييز بعد هو في مجال العمل الحر
“Free lancing”أنموذج محمد وعلي المصغر يمكن أن ينتشر ويكسر طوق بدأ البعض بشد لفه حول عنق المجتمع، ليبدأ بالإنتاج المستند على الموهبة والكفاءة بعيداً عن انتماء هذا أو ذاك.
وهذه هي الرؤية الحقيقية التي ينبغي السير عليها، رؤية الكفاءة والعمل الوطني الموحد، رؤية نموذج يجب أن يُحتذى به في العيد الوطني للوصول إلى إنتاج حقيقي وتقدم ملموس في المجالات التي تنشدها المملكة في خضم التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة في المنطقة والعالم، عليها أن تهيأ الجو وتشجعه لمحمد وعلي معاً، وكل محمد وعلي آخرين.
فلا مجال للتمييز إن أردنا التقدم وتحقيق رؤية اقتصادية فاعلة. فمحمد وعلي أنموذج حي يعيش بيننا، في ظل ترهلات في النظرة الاقتصادية الفاعلة والمنتجة، وتحت ظل اصطفافات عقائدية انسحبت على الجانب المعيشي بصورة لا يخطأها ناظر أو فاحص بسيط.
فاتركوا العقال الذي يربط كل محمد وفكوا قيد كل علي لترو أن محمداً وعلياً هما أنموذج وطني وبجدارة ينبغي أن يُحتفى بهما، تزامناً مع كل فرحة للوطن، ومع كل رفة علم للبحرين।هذه هي صورة حقيقية للبحرين مجتمعاً واقتصاداً وعملاً، صورة ينبغي أن لا تتحول إلى أنموذج يُذكر وكأنه الاستثناء بدل أن يكون القاعدة، صورة نخشى أن تتحول إلى المتحف، بدل أن تكون واقعاً نلمسه، نريد أن تكون تلك الصورة لمحمد وعلي نعرفهما ونشاهدهما كل يوم.
* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.ملاحظة: فضل كل من محمد وعلي علي عدم الكشف عن اسميهما ليبقيا رمزا صافيا بعيدا عن كل حسابات السياسة النازعة لللرحمة والمزيلة للصداقة.
-
Wake Up
جعفر حمزة*
التجارية ١٧ ديسمبر ٢٠٠٨م
اشتدت رغبته في لقاءها، فطفق مُسرعاً إلى محل تواجدها الدائم في ذلك المكان الموعود، وما إن جلس معها حتى اقتربت من شفتيه، وأحس بسخونتها المعهودة। ولمسها بكلتا يديه “متشبثاً” بها في ظل شتاء اقترب। فهي إلى كونها رفيقته الدائمة، فلها ميزة أخرى، فهي تُريح أعصابه من الكم الهائل من ملفات “كابوسية” تُلاحق كل فرد من أقرانه من أزمة سكن، وضنك من العيش وسياسة توجع الرأس وتكسر الظهر.
وكانت سريعة الاستجابة له، فلبت طلبه في غضون دقائق معدودات، فجلس معها مستفرداً مستأنساً، وما إن “شربها” حتى “ارتاحت” أعصابه. أتخدعه، أم يخدع نفسه بها؟ أو ربما الإثنين معاً! كانت تلك قهوة “ستاربكس” على يمينه والصحيفة اليومية على شماله، وما إن وقع بصره على ذلك الخبر حتى انشرحت أساريره وكبرت “عشيقته” القهوة في عينيه। ومفاد الخبر أن “ستاربكس” تطرح مشروبات جديدة لدعم مكافحة الأيدز في أفريقيا، وذلك عبر تبرعها بخمسة سنتات لقاء كل كوب يتم بيعه. (1)
فرفيقته ذات شأن، وتهتم بالجانب الإنساني، حالها كنجمات السينما الشهيرات ك”أنجلينا جولي” وغيرها ممن يهتم بالفقراء والناس البسطاء। فاختياره لها رفيقة كان موفقاً وفي محله। وقد أطراها أمام صاحبه في مساء ذلك اليوم، إلا أن نشوته بها لم تكتمل، فصاحبه يعلم “خبايا” و”أسرار” صاحبته “ستاربكس” الخفية، فرفض ما سمع في البداية، وبعدما قدم صاحبه له الدليل تلو الدليل تحول ذلك “الشغف” إلى “تردد”، و”الحب” إلى “شك”।فما هي الحكاية؟ وما الذي تُخفيه “ستاربكس” عن “عشاقها” و”روادها”؟، والذي امتد عشقها إلى أن تتكون جماعات ضمن “الفيس بوك” تيمناً باسمها. وما سر القهوة السمراء التي أخذت ترمي بخيراتها على القارة السمراء، بل وأصبحت تساهم وبسخاء ملحوظ في مشروعات كبرى كتلك التي تدعم مكافحة الأيدز في أفريقيا؟
قد يختصر الأجوبة فيلم وثائقي أحدث ضجة في أمريكا وبريطانيا، بل ودفع مسؤولين كبار في أثيوبيا للمطالبة بحقوق المزارعين التي تحصد شركة “ستاربكس” من وراءهم ثروة ضخمة، ولا يحصل مزارعو البن في تلك الدولة إلا أقل من فتات فتات “الفتات”. فما هو الفيلم الذي فضح رفيقة صاحبنا العاشق؟ Black Gold هو اسم الفيلم، وعنوانه الفرعي التفاعلي هو Wake up and smell the coffee وقد أخرجه الأخوان” نيك ومارك فرانسيز”، ويتناول الفيلم تجارة البن واستغلال المزارعين من قبل الشركات الضخمة “الهوامير” ، ويقول أحد مخرجي الفيلم ” نيك فرانسيز”: إن فكرة فيلم “الذهب الأسود” انبثقت من اهتمامه بقضايا فقر مزارعي البن في أثيوبيا، في الوقت الذي تحصد فيه شركة مثل “ستاربكس” ملايين الدولارات من جراء بيع القهوة في فروعها المنتشرة في كافة أنحاء العالم.
ومن الجدير بالذكر أن شركة “ستاربكس” والتي تتخذ من مدينة سياتل الأمريكية الجميلة مربعاً لها، تجني أرباحاً سنوية تُقدر ب ٧.٨ مليار دولارأمريكي، وهو -أي المبلغ- ليس بأقل من ناتج الدخل القومي الإجمالي لأثيوبيا! ويتضمن الفيلم العديد من المعلومات والحقائق التي تتحرك خلف صورة العلامة التجارية لإحدى أكبر سلسة المقاهي في العالم، والتي تتعدى مساحة عملها مكان بيع تلك “القهوة المميزة”، لتصبح في مصاف العلامات التجارية التي تظهر في الكثير من الأفلام صورة وكلمة. بل تضع بصمتها “الإنسانية” خلال بعض مشاريعها، ومن ضمنها ما ذكرناه بخصوص “دعمها” لمكافحة الأيدز في أفريقيا، وهي القارة التي تحرث من وراء مزارعي البن فيها ثروتها الضخمة.(٢)ولو لم يحدث هذا الفيلم فرقاً، لما بادرت شركة “ستاربكس” بالتحرك للدفاع عن سمعتها وعلامتها التجارية والمبالغ الطائلة التي دفعتها لتنوء بنفسها عن ما ذكره الفيلم عنها। وذكرت وكالة “الآسوشيتد برس” بأن شركة “ستاربكس” رفضت مقابلة المخرجين أثناء قيامها بعمل الفيلم، ولكن بعد عرض الفيلم في مهرجان أفلام “Sundance” السينمائي، دعت “ستاربكس” المخرجين إلى مقرها الرئيسي في” سياتل”. ويعتقد “نيك فرانسيز” أن فيلم “الذهب الأسود” ساهم في التعجيل بعقد اجتماع بين كبار المديرين التنفيذيين في شركة “ستاربكس” وبين رئيس وزراء أثيوبيا.
وللعلم، فإن مقدار الباوند الواحد من البن، والذي يستلمه المزارعون في أثيوبيا هو ١.١ دولار أمريكي، في حين يبلغ مقدار الباوند الواحد الذي يستلمه تجار التجزئة ١٦٠ دولار أمريكي. وبحسبة أخرى، فإن ما يتم دفعه مقابل فنجان قهوة وهو ٣ دولارات تقريباً، يتقاضى مزارعي البن في المقابل ٣ سنتات فقط! وتعقيباً على “المبادرة الإنسانية” التي أطلقتها “ستاربكس” لدعم مكافحة الأيدز بأفريقيا، وهي ليست الأولى من ضمن مبادرات الشركة، حيث قامت بالتبرع في عام ٢٠٠٥م بالتبرع بمبلغ ١.٥ مليون دولار أمريكي للعالم الثالث. وتعقيباً على ذلك نقول ما قاله أحد الذين شاركوا في الفيلم، وهو أثيوبي :”نحن لا نريد هذا النوع من الدعم، نحن نريد سعراً عادلاً لمزارعينا. إنهم يجنون من وراءهم أرباحاً طائلة، وإعطائنا جزءً من حقنا لا يساعدنا البتة”. (٣)بعد هذه الجولة الصغيرة في دهاليز علامة القهوة الشهيرة، يبقى السؤال متوقفاً في إحداث الفرق والتغيير في سلوكيات كبرى الشركات الأجنبية، والتي تقوم باستغلال رخص الأيدي العاملة، فضلاً عن تهميش حقوق العمال في بداية سلسة إنتاجها।
والفرق يأتي مني ومنك، من الطرف الأخير في السلسلة وهو المستهلك، إذ بدون المستهلك لا تكتمل الحلقة، وبالتالي لن يكون هناك عائد لمثل هذه الشركات التي “تقتل القتيل وتمشي في جنازته” كما يقولون. وهذا غيض من فيض من “جاذبية” العديد من العلامات التجارية الشهيرة، والتي تمتد من المشروبات الباردة والساخنة، مروراً بالمأكولات والملابس، وانتهاءً بمستحضرات التجميل، والتي تمر عبر العديد من التجارب على حيوانات لا حول لها ولا قوة وبطريقة بشعة.(٤)وكوننا في نهاية الحلقة، ويتم إخفاء الحلقات السابقة، فإننا نساهم بطريقة أو بأخرى في استمرار الاستغلال السيء للعمالة ذات الأجر المتدني من مزارعين، وعمال نساء وأطفال في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وبعض دول أوروبا الشرقية. إنّ العلاقة “الودية” بين الفرد والعلامة التجارية التي تخفي الكثير من ملفاتها عن “محبيها” ينبغي أن تتوقف من المستهلك نفسه، فلا يستمر أي ود بعد ذلك، أرأيت حباً يستمر إن كان من طرف واحد فقط؟ لقد باتت العديد من الشركات الكبرى باستغلال الأيدي العاملة الرخيصة جداً في البلدان النامية وما دونها، لتدور “تروس” مصانعها من بلدان النفط “الغنية” و”الفقيرة” باكتفاءها الذاتي، ليتم تصدير تلك المنتجات ذات العلامات التجارية والشهيرة و”ذات السمعة” من ثروات شعوب النفط وعرق شعوب أخرى إليهم من جديد، وتكون النتيجة حصد أموال مضاعفة من الشعوب التي لا تستأنس بجلوسها إلا عند شربها ل”ستاربكس”، ولا تشعر بالراحة إلا عند لبسها هذه الماركة أو تلك، والتي عليها الكثير من الإشكالات الأخلاقية في صناعتها. وبصريح العبارة، يتم استخدام ثروات شعوب وتعب شعوب أخرى ليتم بيع منتجات تلك الدول “المتقدمة” لنفس تلك الشعوب لصرف ما تبقى في جيوبها لهذه العلامة أو تلك। ما نحتاجه هو وقف تلك التروس الضخمة للعديد من المصانع التي “تحرث” من ظهور المعوزين والعاملين من نساء وأطفال، ليس بمظاهرة أو رفع يافطات أو الامتناع عن أساسيات العيش “الكريم”، ما نحتاجه هي وقفة إنسانية مستمرة قد تُعيد النصاب إلى ميزان مختل أصلاً غذته قوانين واتفاقيات مُحاكة بليل لضمان مصلحة “هوامير” الدول من اتفاقيات التجارة العادلة واتفاقية التريبس وغيرها.
ما نحتاجه هو أن نستيقظ من شرب عرق العمال في زجاجات وعلب معدنية أصبحت جزءً من حياتنا اليومية، وأن نستيقظ من لبس أحذية من عمر الصغار في آسيا وأمريكا الجنوبية، وأن نستيقظ من لبس ثياب تم إجهاد المئات بل الآلاف من النساء في صناعتها وحياكتها لي ولك، وأن نستيقظ من وضع بعض المساحيق التي تُضفي جمالاً على نسائنا على حساب دماء حيوانات بريئة يتم استغلالها ببشاعة مفرطة। ما نحتاجه هو فنجان قهوة قوي “سادة”، ولكن من نوع آخر، فنجان قهوة يوقظنا من سبات نمط حياة مزيف ندعيه، ونحرث من أجله على ظهور المستضعفين من داخل أفريقيا إلى أطراف آسيا ومن شرق أوروبا إلى أمريكا الجنوبية، لنشعر بأننا نحدث فرقاً كأفراد يعيشون إنسانيتهم دون الدخول في برمجة الأقنعة التي تصنعها العديد من الشركات العالمية। ما نحتاجه ليست قهوة صاحبنا الذي طلقها ثلاثاً وعاهد نفسه بأن يكون مستيقظاً، ما نحتاجه هو أن نقول لأنفسنا وللآخرين Wake Up
(1) صحيفة الوقت، ١٢ ديسمبر ٢٠٠٨م.
2)
http://www.blackgoldmovie.com/
3)
http://www.guardian.co.uk/business/2007/jan/29/ development.filmnews
4)
http://www।peta.org/فكرة الصورة المرفقة مع الموضوع مقتبسة مع تعديل يتناسب مع سياق الموضوع من الوصلة التالية
http://adsoftheworld.com/media/print/wake_up_coffee_mountains -
رافعة الأثقال
جعفر حمزة *
التجارية ١٠ ديسمبر ٢٠٠٨م
ما إن وطأت قدماها عتبة سكناها بعد يوم دراسي طويل حتى افتتحت فصل آخر من فصول العمل التي تبدأ قبل طابور الصباح، ولا تنتهي عند جرس إنتهاء الدوام المدرسي. حتى باتت “مهنتها” منهكتها صبحاً ومساءً.
هي معلمة في إحدى المدارس الابتدائية، ربما “جنت” على نفسها بامتهان التدريس، وربما جنت لنفسها في ذلك. وبين الجني على النفس والجني لها، لا بد من استعراض جو التدريس العام الحاصل في مدرستها، وهي أنموذج مصغر لعامة “مصانع الأجيال القادمة”، إذ يُعتبر تطور وقوة النظام التعليمي في أي دولة مؤشر على تطور الدولة وسيرها الواثق نحو النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي من أحد أكبر أبوابه، وهي تربية الأجيال وصياغة السلوكيات للجيل النشء.
كلام جميل، أليس كذلك؟ وماذا بعد؟هل مبادرة تحسين أداء المدارس لها صدى قريب من المعلمين كما للطلبة في تغيير واقع يكتنز بين جنبيه الكثير من السلبيات والنواقص؟ وهل مشروع تطوير التعليم في البحرين له ذلك البُعد التغييري الملموس لأطراف العملية التعليمية (الإدارة المدرسية، المعلم، الطالب، أولياء الأمور وموظفي الوزارة)؟ وقبل كل هذا وذاك، هل وصل “مد” التغيير في العملية التعليمية إلى العقلية التي تتعامل مع الأجيال الجديدة؟ أم أنها تحولت إلى ما يشبه “الطقوس” التي يجب على إدارات المدارس الإلتزام بها نصاً، دون الاقتراب من “روح” التغيير الفعلي في فهم العملية التعليمية، حتى باتت بعض الإدارات المدرسية متمثلة في مديراتها باتباع “النص” لنظام الجودة وكأنه قرآن منزل، دون الإلتفات إلى طرفي العملية من الأساس وهما الطالب والمعلم. بل أصبح “ترتيب الملفات” وإعداد التقارير لتبييض واجهة هذه المدرسة أو تلك أهم من المعلم في وقته الممنوح، ليقضي وقتاً عادلاً مع الطالب ؟
وعوداً إلى “معلمتنا” التي ما إن أغلقت باب سُكناها، حتى فتحت كراسات الطالبات، لينتظرها بعد ذلك “طابور” من كراسات التصحيح والتحضير، وإعداد الأنشطة واللجان المكونة داخل المدرسة. فبالتالي سيكون “وقتها” زهيداً لمنزلها، فكأنها وهبت نفسها للمدرسة في وقت الدوام، وما بعده.
وتبعات ذلك تلقي بظلالها على العائلة والأبناء والزوج والمجتمع، لتتحول “المعلمة” إلى إحدى “تروس” مشروع تم “تغييب” أحد أهم عناصره فيه ، وهي “هي” أي “المعلمة”.
فهل ما ندعيه هو “افتراء” لا أساس له؟ وإن كان عكس ذلك، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإليك بعض براهيننا التي نرجو من القيمين على مشروع “تطوير التعليم في البحرين” وضعه في عين الاعتبار. والذي يترك أثراً غائراً لا يمكن غض النظر عنه في نفس المعلم، وذلك عندما يتم خدش “رسالته” و”إثقاله” بما لا يُطيق، وبالتالي يتحول من حامل رسالة للأجيال إلى حامل لهمٍّ لا قبل له به.
البرهان الأول: عندما تُثقل لا تحصل
تخيل أنك معلم لصف يزيد عدد طلابه عن ٣٣ طالباً وقد يصل بعضهم إلى ٤٠ طالباً، ونصيبك من الصفوف التي تقوم بتدريسها يتراوح بين ٥ إلى ٦ صفوف، أي بما يساوي تقريباً في المعدل ٢٠٠ طالباً، والوقت المخصص لكل حصة هو ٤٥ دقيقة، وتكون هناك بمعدل حصتين “فرصة” لك، بالإضافة إلى “الفسحة” -التي يكون في معظمها مناوبة مراقبة فيها-، ومع وجود ذلك “الجيش” من الكراسات والامتحانات للطالبات، والتي يستلزم التصحيح والرصد والتقييم، ستكون الحصتين و”الفرصة” وقتاً ثميناً للقضاء على “جبل” الأوراق التي على المعلمات متابعتها وتصحيحها ورصدها وتقييمها. فبالتالي لن يكون هناك وقت مخصص للطالبات المائتين في وقت الدوام المدرسي، وهنا تنفصل عروة أساسية من ضمن معادلة الرقي بالتعليم، وهي العلاقة المباشرة والوطيدة بين المعلم وتلميذه.
وإن كانت مبادرة إنشاء “كلية البحرين للمعلمين” بتوصية من معهد التعليم الوطني بسنغافورة، وذلك ضمن تعاونه مع مجلس التنمية الاقتصادي جيدة بل ومطلوبة، إلا أن المعادلة ناقصة هنا وبوضوح، فالإعداد للمعلمين في المستقبل مطلوب، إلا أن تحسين أوضاع المعلمين الحاليين ورفع كفاءتهم ومنحهم الوقت لتقديم رسالتهم الأساس للطالب لا يقل عن هدف إنشاء الكلية نفسها.وما ذكرناه “ثقل” من ضمن “أثقال” أخرى توضع على كاهل المعلمات، من بينها الاشتراك في لجان داخل المدرسة، والمتابعة والعمل في أنشطة تقدمها الإدارة. وبالتالي يكون هناك أكثر من ٢٠٠ ثقل على المعلمة. وفي مثل هذه الحال، هل يتوقع “عطاء” من المعلمة للطالبات؟ فضلاً عن إيفاء لشروط الجودة في التعليم، في ظل غياب أساسيات الجودة من وقت لا تملكه المعلمة، وفروض والتزامات تتعدى مكان وزمان الدوام المدرسي، لتلاحقها حتى في عقر دارها وتشاطرها حتى وقت العائلة ونفسها.
البرهان الثاني: في صلب المعادلة وخارجها
يمثل المعلم أحد أهم ركائز العملية التعليمية، والأخذ برأيه والاستئناس به يمثل رافداً يهب لأي عملية استراتيجية لتطوير التعليم “مصداقية” وواقعية، فضلاً عن أن ما سيُقدم من اقتراحات وتوصيات سيكون أول من يأخذ بزمامها ويطبقها هو المعلم نفسه.
والملاحظ وجود خطابين في ساحة التعليم المحلية، أحدهما تقدمه وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادي لتطوير التعليم، عبر مشاريع متنوعة ومبادرات ككلية البحرين للمعلمين،وبرنامج تحسين أداء المدارس ومشروع تطوير التعليم في البحرين. في قبال خطاب آخر يسرده المعلمون من ملاحظات عدة على نمط إدارة دفة التعليم في المدارس، والحديث عن كادر المعلمين، ما يضع فكر المعلم/المعلمة على أساسيات يتطلعان إليها (زيادة في الراتب والرتبة وتوزيع عادل للمهام الموكلة إليهما كماً وكيفاً). فهل إلى ذلك من سبيل؟
البرهان الثالث: معلمة بسبعة أرواح
إنّ الناظر المنصف للإلتزامات المُلقاة على عاتق الكثير من المعلمات، يتعجّب من القدرة المتوقعة والمنتظرة منهن، فعدد الطالبات “الكبير” في الصفوف الدراسية، والتي لا يتناسب مع أساسيات العملية التعليمية المنتجة، فضلاً عن حجم المسؤليات التي تتولاها المعلمة، سيعكس إثره بصورة مباشرة على العلاقة المفترضة والمهمة بين المعلمة والطالبة، فلا الطالبة يمكنها التفاعل المباشر مع المعلمة ومتابعتها بعد الصف، ولا يمكن للمعلمة الجلوس مع الطالبة ونقاش نقاط ضعفها وقوتها، إلا في يوم وحيد فقط، وهو اليوم المفتوح، ووقته ضيق أيضاً نظراً للعدد الكبير للطلبة التي تشرف عليهم المعلمة.
فهل نتوقع أن تكون لدينا معلمات بسبعة أرواح، لكي تعمل ضمن رؤية تطوير التعليم في البحرين، وإيفاء كل المتطلبات عليها من الإدارة والطالبات وأولياء الأمور والوزارة. هذا مع عدم نسياننا بأن المعلمة تعمل في دوام ثابت -ما يعادل ٨ ساعات-، ولها حياتها الخاصة من منزل وعائلة وحياة اجتماعية. فأنّى لها عمل كل ذلك؟والمعلمات الاحتياط يكنّ “فريسة” جِدتهنّ في العمل وحماستهنّ، بأن يتم الضرب على هذا الوتر بإيكال العديد من المهام والأنشطة، بل وأخذ بعض نصاب معلمات أُخريات للقيام بها وإيفائها كاملة دون نقصان، وبالتالي تتحول المعلمات الجدد إلى “عاملات” في خط سير التصنيع “”
Assembly Lineبدل أن يكنّ مشاركات ومنتجات فاعلات في العملية التعليمية. فما عليها إلا أن يفعلنّ ما يؤمرن ، لا غير!
ليس هناك أسهل من وضع الخطط لو تمت مقارنتها بتفعليها والنزول إلى الساحة والعمل عليها، وفي ظل مبادرات مجلس التنمية الاقتصادية الداعية إلى تحسين وتطوير أداء المدارس في المملكة، وذلك من خلال مشروع تطوير التعليم في البحرين، وتقديم خطط لرفع المستوى التعليمي في المدارس الحكومية في المملكة من خلال “هيئة ضمان الجودة”، ووحدة مراجعة أداء المدارس، وغيرها من المبادرات، في ظل كل ذلك، لا بد من نزول حقيقي ومراجعة شفافة لواقع المعلمين بصورة عامة، والمعلمات بصورة خاصة للوقوف على مقدار الفجوة الحاصلة بين المُعلن والواقع.
فهل ترجع صاحبتنا المعلمة إلى “طبيعتها” ، لتهب ما لديها لطالباتها ما يستحقن من وقت واهتمام، لتصل إلى سكناها لتعيش حياتها كزوجة وأم ومربية وفاعلة في المجتمع؟ أم أنها ستبقى “مُجهدة” بالوصول إلى ما يسطره الآخرون ، وتدور ك”الروبوت” لتقوم بما يتم إملاءه عليها تبعاً دون سؤال أو نقاش؟
ومع حجم الأثقال المُلقاة على عاتق المعلمات، تزداد التبعات النفسية والجسدية والاجتماعية، ونخشى أن تتحول المعلمات إلى رافعات للأثقال في ظل الموجود، وفي غياب حقيقي للتغيير من الداخل.
وعندما تصل صاحبتنا المعلمة إلى سكناها، يتبين أنها بدأت دورة أخرى من العمل في رفع الأثقال التي يجهزها الغير.* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.
-
مؤسسة إماراتية تبادر ببث الروح في دمية جعفر حمزة
كتب: محمود النشيط
أخبارالخليج ٥ ديسمبر ٢٠٠٨م
حصل الكاتب البحريني الشاب جعفر حمزة على موافقة مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتبني كتابه الجديد الموسوم «أنا أحب دميتي«، وذلك ضمن برنامج «اكتب«، والذي يشجع الكتاب من الشباب العرب على الكتابة والإبداع. حيث يهدف هذا البرنامج «اكتب« إلى توفير التشجيع المعنوي، والدعم المادي، للشباب المبدع والطموح لدخول عالم الكتابة والتأليف في مجالات شتّى. ويعدّ البرنامج رافداً مهماً في سياق مسعى المؤسسة لإرساء دعائم مجتمع المعرفة. وبرنامج المؤسسة وضع استراتيجية خاصة لتقييم الأعمال المرشحة، وتتألف لجنة تقييم برنامج «اكتب« من تسعة خبراء عرب، يجتمعون بصفة منتظمة؛ لمراجعة الطلبات المقدمة التي استوفت
شروط الدخول في عملية التقييم। وتتم عملية التقييم وفق معايير دقيقة وهي: يجب أن يكون الموضوع جديداً ومبتكراً، وليس مكرراً وتقليدياً، يجب أن يثبت الكاتب مقدرته على التعبير عن منهجية الكتاب وأهميته، يجب أن يكون الطرح واضحاً، واللغة سليمة وسلسة، كما تنظر اللجنة في التقييم العام لأعمال الكاتب السابقة، حيث توافرت كل هذه الشروط في الشاب البحريني جعفر حمزة من خلال أعماله الإبداعية السابقة، وكتاباته في هذا المجال। وجاء ملخص كتاب «أنا أحب دميتي« للكاتب البحريني الشاب جعفر حمزة ليصور سيرة عشق الإنسان لصورته الدمية والتي يعرفها المؤلف قائلاُ: مازالت «الدمية« رفيقة الإنسان في صغره، بل ويستمر تواصلها معه لحين كبره، لتكون له زينة أو مقتنىً خاصاً على شكل هدية أو ما شابه ذلك। وتبقى الكثير من الأسئلة تدور حول ماهية تلك العلاقة التي لم يُعرف منبتها في الزمن، لتكون حاضرة بألوانها وأحجامها وقيمها وثقافتها وصورتها في عالم اليوم، عبر العديد من المنتجات والحملات الإعلانية والإعلامية، لتكون أكثر من مجرد لعبة يتسلّى بها الأطفال، وكفى। ويواصل جعفر تعريفنا ما هي سيرة تلك الدمية؟ قائلاً: يتناول الكتاب من خلال الفصول الستة، وقد أسماها المؤلف «أغلفة« ليكشف القارئ في كل «غلاف« إحدى الصور الناقصة عن سيرة الدمية وعلاقتها بشريكها الإنسان، وكانت الأغلفة كالتالي: الغلاف الأول: تم تناول «شجرة العائلة« للدمية، من حيث ولادتها غير معروفة الزمن، إلى حين تنقلها من عصر إلى آخر، لتتحول وتتقلب إلى رمز ثقافي هنا أو صورة دينية هناك، وبين كل تلك الخلفيات الذهنية للعديد من المجتمعات، بقيت الدمية صامدة حتى أثناء الحروب، لتصبح أكبر من مجرد أداة لتسلية الأطفال لا غير. الغلاف الثاني: كانت أرضها في كل مكان، ولم يهدأ لها بال لتستقر في قطر دون آخر. لذا عرض الكاتب تنقلات الدمية وتجاربها التي شكلت فيها نقاط تحول رئيسية فيها شكلاً ومادةً وفكراً وتسويقاً، ومن بين تلك الأقطار، الصين، واليابان. وأنّى لهذه الصغيرة أن تمتلك زمام العقول والمصانع في دول تحت القصف ومازالت مصانع الدمى تعمل دون توقف. إلى هذا الحد أصبح عشق هذه الدمية أعمى وذا أولوية. الغلاف الثالث: يُسهب الكاتب في هذا الغلاف، حيث يمثل أسمك غلاف مقارنة بغيره، وذلك طبيعي نتيجة حديثه عن الدمية المُعمرّة «باربي« ذات الخمسين عقداً أو يزيد. فمن كونها جنيناً إلى أن شبّت وكبرت، كان الكاتب ملازماً لها كالظل يقرؤها ويلامسها، ليقدم للقارئ سيرتها الحقيقية، ومقدار قوتها التي بسطته على الخلائق شرقاً وغرباً، حتى بات يُباع منها في كل ثانيتين دمية «باربي«. والفرح «الباربي« لم يستمر، إذ دخلت عليها «صاحبة العيون الناعسة« «براتز« وزاحمتها ضيقاً في تسويقها ومناكفتها في السوق، لتكون نداً لدمية خمسينية المولد. ويستعرض الكاتب تينك التجربتين تحليلاً ونقداً وعرضاً، لتكتمل صور الصراع بين الشقراء «باربي« والناعسة «براتز«. الغلاف الرابع: دوام الحال من المحال، وهذا ليس لسان حال الكاتب، بل لسان حال سوق الدمى في العالم. ففي هذا الغلاف (الفصل) يتناول الكاتب تجارب عديدة من لدن دول إسلامية وأخرى عربية في مجال صناعة الدمى، ومقدار حضورها إن كان قوياً أو ضعيفاً أو حتى موؤداً منذ لحظة ولادة التجربة. ويولي الكاتب أهمية لتجربة عربية ملحوظة في مجال الدمى، وهي الدمية «فلة«، حيث يستعرض سيرتها وهويتها ومكانتها نقداً وتحليلاً، مُفرداً مساحة لا بأس بها عنها. الغلاف الخامس: لا يكتفي الكاتب بعرض تجارب عالمية أو «معولمة«، ولا عرض تجارب محلية ليُنهي الأغلفة التي أحاط بها دميته التي يحاورها على طول الكتاب وعرضه، بل يمد عينيه إلى أكثر من ذلك، من خلال عرضه لتجارب أو أفكار قائمة يمكن أن تتحول إلى تجربة دمية يمكنها أن تتخطى ما هي عليه حالياً، ومن تلكم التجارب: مسلسل بكار المصري. الـ 99، وهي التجربة التي قدمها الدكتور نايف المطوع ضمن سلسلة مجلاته. مسلسل فريج. وعند وصول الكاتب للغلاف الأخير، ونزعه عن آخر ما يغطي الدمية، يصل لاستنتاجات وقراءات ملخصة عن رحلة الأغلفة المتعددة للدمية. ويستفز من خلال ملخصه المقتضب الأفكار والهمم لبناء تجارب بديلة بل وقوية تعكس القيم والثقافة والفكر المحلي، في ظل عالم تمخضت عنه «الكوكلة«-نسبة إلى شراب الكوكا كولا، وتمثيلاً بالعولمة. فهل إلى ذلك الحضور من سبيل؟ لم لا؟. -
البقرات السمان بين روبن هود وعلي بابا
جعفر حمزة*
التجارية الثاني من ديسمبر 2008م
كان من حُسن حظ الأول تواجده في تلك اللحظة، لتكون له باباً واسعاً لتنقلب حياته رأساً على عقب، ويتمتع بعدها بثراء فاحش وغنىً ينتهي عمره قبل أن تنتهي نصف أو ربما ربع ثروته التي “جناها” من وراء معرفته لكلمة سر الغنى والثروة। فعاش لنفسه في قصر فخم. وأما الثاني فقد كانت علاقته بالثروة من نوع آخر، حيث يظفر بالمال من أناس ليوزعها على آخرين، وكانت الغابة منزله ومأواه.
“علي بابا” هو الذي حصل على الثروة لنفسه من خلال معرفته لكلمة السر للكهف الذي تودع فيه عصابة الأربعين حرامي غنائمهم من ذهب وفضة ومجوهرات ونفائس، فما كان منه إلا أن “تمتع” بها دون تعب منه أو إجهاد।و”روبن هود” هو البطل الأسطوري في القرن الثالث عشر، الذي كان يسرق من الأغنياء ليوزعه على الفقراء، وكانت غابة “شيروود” مكان سكناه وانطلاقته ل”تحصيل” حقوق الفقراء.
وبقدر بُعد هاتين الشخصتين في الظاهر، حيث كان الأول مغدقاً المال على نفسه، في حين كان الآخر يوزع ما يسرقه من الأغنياء على الفقراء والمحتاجين، بقدر ما كان التشابه بينهما لا يخطأه العاقل المتبصر المنصف।ويتكرر هذين النموذجين بقوالب مختلفة في مختلف المجتمعات، ولكون مجتمعاتنا عربية فالميل إلى “علي بابا” أقرب وحركة سيرته فينا أشد.فهناك من يريد أن يكون ك”علي بابا” في معرفته لكلمة السر في توظيف علاقاته ونفوذه للوصول إلى الكهف والظفر بما فيه، وإنعاش “رغبته” حتى “التخمة”.وهناك من يجهد ليكون “روبن هود” في مقارعته للهوامير، وإن لم يكن بمقدروه أخذ شيء منهم، فلا أقل من الحد من “نهمهم” في أكلهم للأخضر واليابس.
وبين تلك الرغبة العارمة ليكون البعض مثل “علي بابا” الذي أخذ الأموال بالراحة، وبين البعض الآخر وهم قلة ممن يسعون للحد وتوزيع الثروة بمعيتهم الخاصة كما فعل “روبن هود”، تكون معادلة التوازن الاجتماع مفقودة। وذلك بين شد وجذب لا يحقق العدالة الاجتماعية ولا التنمية البشرية المطلوبة، ويكفي لذي عينين أن يشاهد الهوة الحاصلة بين المواطنين، في ظل ترهل وتفتت لطبقة ذوي الدخل المتوسط من جهة، وإنعاش أصحاب الطبقات المرفهة، سواء كانوا ممن عاشوا في هذه الجزيرة أو الآتون من وراء البحار، وذلك ضمن مشاريع ضخمة تُقام على أرض هذه الجزيرة من رمال الجزيرة وماءها دون حساب يحفظ المال العام.
البعض يعشق “علي بابا”، ليعرف كلمة السر ويضع يده على كل تلك الكنوز لينعم “وحده” بتلك الثروة دون تعب أو إجهاد فكر أو قطرة عرق।وهناك من يعمل ك”روبن هود”، والذي يسعى لأخذ ما لدى الأغنياء وإعطاءه الفقراء. إلا ان الفرق هنا أن ما يتم تقديمه هو خطابات نارية أو توصيف للحال دون العمل في الميدان أو تقديم شيء ملموس للفقراء.
وبين سيطرة “علي بابا” على الثروة لوحده، وبين خطابات حماسية ل”روبن هود” دون الحصول على شيء ملموس، يضيع المواطن بينهما، ليختار إما التزلف ل”علي بابا” لعلّ وعسى يحصل على بعض من فتات مائدته، أو العيش بكرامة “كما يعتقد” في ظل خطابات “روبن هود” الحماسية، التي لا تُسمن ولا تغني من جوع।وكما تتعدد خطابات “روبن هود” الحماسية طولاً وبلاغة و”جرأة”، فهناك إصدارات مختلفة ل”علي بابا” وبأحجام مختلفة.والمواطن العادي لا يسعى ليتزلف إلى “علي بابا”، ولا يريد أن يحصل على ما يظفر به “روبن هود”-إن وُجد-. فهو يريد حقه الدستوري المتوافق عليه، وهو المتعارف عليه في الدولة التي تسعي لبناء ذاتها عبر إيفاء حقوق المواطنين، وبالمقابل تنتظر الدولة أن يقوم المواطن بواجباته إزائها.
وفي خضم ذينك النموذجين بين ما يُقال على لسان حال “علي بابا” للناس كما قالت “ماري إنطوانيت” عندما أخبروها بجوع الشعب الفرنسي :”عليهم بتناول البسكويت”، فناولوها بالإعدام شنقاً। وبين ما يُثيره “روبن هود” من خطب نارية وحماسية، ولا يحصل الفقراء منه إلا على خبز من ورق وكلمات تدغدغ مشاعرهم وتجعلهم ينتظرون الخبز من الأغنياء بدلاً من البدء بحرث الأرض والزرع والاعتماد على الذات بما هو متوفر، لا لرفع العتب والحق من الطرف المعني بالمسؤلية، بل لتحقيق معنى التغيير الذي هو بداية كل إصلاح حقيقي في المجتمع.
وبين بسكويت “علي بابا” المرتفع الثمن، وخبز “روبن هود” الكلامي، تظهر من بينهما “البقرات السمان” التي ظهرت في حقل الاقتصاد بالبلاد في سنوات ارتفاع أسعار النفط، ليتم البحث عن تلك “البقرات السمان” اللاتي وضعهن “علي بابا” في الفناء الخلفي لقصره ولم يتحدث عنها للناس، في حين كان من الصعب على “روبن هود” سرقتها أو –استردادها- “كما يحب أن يسمع منا”، فاكتفى بذكرها في خطبه الحماسية وكفى। ولتكون جزء من أحلام الفقراء لعل وعسى أن يستيقظوا وبقربهم نصيب من حليبها المليوني.
إنّ ما يُوصل أي مجتمع للإضطراب وعدم الاستقرار، هو القبول إما بأسلوب “علي بابا” في تحصيل الثروة من جهة، أو التنفيس لدى الكثيرين عبر خطابات “روبن هود” الحماسية।والحل هو في إعمال القانون وتنفيذه على الجميع، على “روبن هود” و”علي بابا” على حد سواء. وفي غير تلك الحالة سيكون الاضطراب المجتمعي فضلاً عن توتر العلاقة بين فئات المجتمع والدولة باقياً. وتبعات ذلك لا تخفى على ذوي بصيرة.
ما العمل مع تلكم البقرات السمان؟
اخرجو البقرات السمان من قصر “علي بابا”، وادعو مريدي “روبن هود” ومتزلفي “علي بابا” للاستفاد منها بدلاً من أن تكون حكراً على فئة، والخشية أن ينقسم المجتمع بين “علي بابا” و”روبن هود”، وفي كلا الحالتين هما بعيدان عن إنصاف قضيتهما، فأحدهما وصل للثراء الفاحش عبر “كلمة السر” التي باتت أبعد من “افتح يا سمسم” في هذا الوقت، ।والآخر امتهن طريقاً تلون حياة الناس بسوداوية قاتمة لا منتجة، وذلك لاستحصال ما يظنه حق له وللمظلومين.ففي حين غفل الأول عن وجود حقوق ومطالبين لحقوقهم، ولن يطول الزمن حتى تصبح ثروة “علي بابا” مغارة أخرى لمتنفذين أو متضررين. وامتهن الآخر “روبن هود” الخطابة دون الفعل المخطط في خطواته في المجتمع، مما جعله “رمزاً” للمظلومبن كصورة دون فعل حقيقي يمكن الاعتماد عليه.
وبين النموذجين الشرقي والغربي كمثال تم ضربه هنا، ينبغي الوقوف والتفكر قليلاً، فمع استمرار “علي بابا” بجني ثروته بكلمات سر لا تعب فيها ولا نصب، وعدم توقف “روبن هود” عن حماسته وإلقاء الخطب، سنصل إلى مرحلة تفتت داخلي في المجتمع لا يمكن رأب صدعه ولا رتق فتقه، لأنها ببساطة سيكون كلاً من نموذجي “علي بابا” و “روبن هود” هما المطرقة والسندان للسلم المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، ومهددة للصورة المطلوب تسويقها داخل كل مواطن قبل أن يتم تسويقها في الخارج ويتم صرف أموال سواء من أموال “علي بابا” أو من أموال الأغنياء الذي يسعى “روبن هود” لأخذها منهم।اتركوا البقرات السمان للناس، ليتم هجران كلاً من “علي بابا” و”روبن هود”، ليتم العمل الجاد عند إعطاء كل ذي حق حقه. وفي غير تلك الحال سنرى بقرات عجاف والعشرات من “علي بابا” ومثل عددهم وربما أكثر من “روبن هود”، ولا نعلم أي الأنموذجين سيحظى بحليب البقرات السمان!
* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي. -
illusion
جعفر حمزةالتجارية السادس والعشرين من نوفمبر 2008ملم يطل صاحبي في النظر لها حتى أشاح بوجهه عنها لا منجذباً ولا مستأنساً، ولم يكن مني إلا السؤال عن السبب في غض نظره عن الإعلان المرفوع على الرؤوس في الشارع। فكان رده البديهي السريع جواباً: (الإعلانات مثل بعض، ما فيه شي جديد، وما تشدني أصلاً)।فتولد إثر تلك الإجابة اسئلة لا تستطيع حملها هذه المساحة المخصصة للكتابة،وأهم تلك الأسئلة هي أين العلاقة المفترضة بين العلامة التجارية والفرد؟أين “حرارة” تلك العلاقة التي على الإعلان “إذكائها” وضمان استمرارية وجودها؟ لتصل الأسئلة إلى “عين” السبب। بل أين وكالات الإعلان الكفيلة بتوطيد العلاقة بين العلامة التجارية والفرد؟ لتكون “مميزة” لتٌضفي عليها مسحة من “ود” و”قرب” يشعر معها الفرد قولاً وفعلاً وصورة؟فالإعلان هو الصورة التفاعلية بين الفرد والعلامة التجارية، سواء كانت منتجاً أو خدمة، وألف باء الإعلان هو تقديم العلامة التجارية للفرد لتكون بينهما علاقة ود وارتباط قوي، لتصل العلاقة في أوجها عندما تتحول إلى حاملة لصفات يميل لها الفرد ويتبناها جزء من سلوكه، ليقع في “غرامها” حباً ووداً। والعلامة التجارية الناجحة هي تلك التي تحتفظ بمكانة خاصة في قلب وعقل الفرد، ليرتبط بها سلوكاً وتفاعلاً।ويبدو أن تلك العلاقة المفترضة كالبحث عن الحب العذري في زمننا هذا، فهل هناك حب “قيس وليلى”؟ بل هل توجد علاقة “روميو وجوليت”؟قد يوجد، لكن ما نراه في واقع الإعلان في المنطقة، وخصوصاً على أرض جزيرتنا هو خلاف ذلك تماماً، وذلك لأسباب لا يعلمها صاحبي، بل وقد لا يدرك نتائجها الكثيرون। فالإعلان الفاقد للجاذبية والإبداع يؤثر في مستوى الرواتب للعاملين مباشرة-دون كبار القوم في تلك الصناعة بالطبع- في صناعة الإعلان ويؤصل ثقافة “مافيا” العلاقات الشخصية، وبالتالي انتشار الإعلانات “المستهلكة” كالفطر، ولا يمكن تناول ذلك الفطر أو الاستفادة منه حتى للزينة।فما هو “المغيب” من وراء تلك الإعلانات؟الخدع البصرية، هي من وراء صناعة الإعلان في المجتمع، وأتحدث هنا خصوصاً عن تلك الصناعة في البحرين। وتتمثل تلك الخدع في الإيهام بوجود شيء لا أساس له। وهو الإيهام بوجود إعلان وإبداع وصناعة إعلان قائمة على الحرفية والإبداع। وكما تكون مهمة الخداع البصري بإرسال معلومات إلى الدماغ لتكون النتيجة في النهاية لا تتطابق مع المعلومات المقدمة في العنصر المرئي، فالأمر لا يبدو مختلفاً عند الحديث عن مستوى الإعلان في السوق المحلية। فما هو الموجود، وما هي الأسباب، وكيف تكون النتيجة؟ وهل من حل؟
هل الخدع البصرية موجودة في صناعة الإعلان المحلية؟هي موجودة بنسب متفاوته وواضحة، ويتمثل خداعها البصري في التالي:أولاً: لقد أخذ الإبداع إجازته في الإعلانات، حيث أن التكرار في الفكرة، والقيام في الكثير منها بعملية “قص ولصق” من إعلانات أجنبية، بل حتى محلية أصبح “العملة الرائجة” في الكثير من الإعلانات (١)ثانياً: ضعف في لغة التواصل مع الفئة المستهدفة من الإعلان، سواء بصرياً أو لغوياً। وبالتالي فقدان الإعلان هدفه ورسالته। حيث يلحظ في الكثير من الإعلانات “الزحمة البصرية” في وضع الصورة أو تركيبها، وخصوصاً تلك الموضوعة في أماكن يجب أن يتمتع الإعلان فيها بالبساطة والقدرة على لفت الإنتباه في لحظات، ونقصد بها إعلانات الطرق। فضلاً عن التواصل اللغوي الضعيف الذي يأتي من ترجمة مباشرة من اللغة الأم للإعلان دون “تعريبها”، وفرق بين الإثنين في الخطاب। (٢)ثالثاً: فتور في الإعلانات الموجودة، حيث تغيب عنها كا يسمونه ب”الفكرة الكبرى” أو “الفكرة الأم”، والتي تكون مصدر التواصل مع الفئات المستهدفة للإعلان، وتضمن تفاعلهم ومعايشتهم للعلامة التجارية لفترة أطول।
وما الأسباب التي تجعل من تلك الخدع البصرية تأخذ مفعولها في الواقع؟أولاً: مافيا العلاقات بين الجهة المعلنة ووكالات الإعلان، والتي تستند على العلاقات الشخصية بغض النظر عن الكفاءة وأهمية التقدم وتوطيد قاعدة “العلامة التجارية-البراند”، وذلك باتباع سياسة ما هو موجود “يفي بالغرض” ولا حاجة للبحث والجد في البحث عن مخرجات رفيعة المستوى في الإبداع بالإعلان।والعامل في هذه الصناعة يرى ويسمع ويلمس هذا الأمر। ليكون ترويج وتثبيت العلامة التجارية رهين بالعلاقات الشخصية، بعيداً عن الكفاءة وهدف العلامة التجارية في ارتباطها “الوثيق” بالفرد المتعامل معها।ثانياً: غياب أهل البيت من البيت، بمعنى غياب الكوادر المحلية بصورة ملحوظة في هذه الصناعة، وإن وجدوا فهم تابعين لرؤية المدير الأجنبي أو العربي “الخبير” بالثقافة البحرينية المحلية أكثر من البحريني نفسه، وبالتالي تكون لغة الخطاب البصرية واللغوية ركيكة وبعيدة عن ملامسة قلب “قيس” في الإعلان।ثالثاً:الخوف الذي يعتري وكالات الإعلان، وهم طوع أمر “من يدفع” أي الشركات صاحبة العلامات التجارية। ويحدد السيد ” Kevin Roberts” وهو المدير التنفيذي الرئيسي لشركة ” Saatchi and Saatchi” هذا السبب بالقول بأن مستوى الإعلان في مجال العقارات أصبح متدنيا وفقيراً في الإبداع। “انظر فقط إلى كل تلك الأموال التي يتم إنفاقها في مجال العقارات। ومن ثم انظر إلى كل تلك الإعلانات، فهي تبدو متشابه। هل تمزح معي؟ فهي تدفعني للضحك”।ويرجع السيد ” Roberts” السبب في ذلك إلى الخوف الذي يعتري وكالات الإعلان في هذه المنطقة من أخذ المخاطرة في تقديم الجديد، وهو ما يشكل عائقاً في جودة العمل الذي يتم تقديمه।(٣)وما هي نتيجة تلك “السيطرة” التي تتمتع بها الخدع البصرية، لتكون هي ما نعيشه يومياً؟
أولاً: إنتشار الإعلانات التي تفتقد الإبداع والتواصل العملي مع الفرد المستهدف، كانتشار النار في الهشيم، وهي نتيجة انتشار “أكشاك الإعلان”، سواء كانت “دكاكين الإعلانات” أو “وكالات الإعلان العالمية” والتي تتخد من اسمها “مركباً” للظفر بإعلانات هذه الشركة أو تلك، دون تقديم حقيقي لمستوى تلك الوكالات كما هو في خارج المنطقة। والنتيجة مستوى “مستهلك” و”ممل” من الإعلانات، لتكون مباشرة مع غياب الإبداع فيها كتلك التي تنشر في المجلات الدعائية المجانية.ثانياً: نتيجة لمافيا العلاقات الشخصية، وتدني مستوى الأفكار المقدمة، تصبح الكوادر المطلوبة في هذه الصناعة ليست بالضرورة موهوبة، بل سيكون المطلوب “ماكنة إنتاج”، حالها كحال من يعمل في خط سير الإنتاج والتركيب “إسمبلي لاين”। والنتيجة توظيف كوادر “تمشي الحال”، وتوفر في “الميزانية”، قكلما كانت الكوادر أقل إبداعاً كانت أفل تكلفة.وبالتالي يكفي لوكالات الإعلان كوادر أن تكون قادرة على عمل “التصميم” و”الكتابة”، وكفى، ويتم نسيان الحرفية والإبداع من ضمن المعادلة.ثالثاً: تعزيز المستوى المتدني من الإبداع المقدم في الإعلانات، نتيجة التدفق المالي “السخي” من لدن الكثير من الشركات، وخصوصاً الشركات العقارية التي أصبحت إعلاناتها “إجتراراً” لنفس الأفكار دون تقديم شيء جديد في الإعلان। ويكفي أن تنظر للمشاريع الكبيرة في البلد لترى أن “العنوان الأفضل والمفضل وعنواني و…” هو ما خرجت به قريحة “المبدعين” في وكالات الإعلان، وهو الذي توافقت عليه الشركات العقارية واقتنعت به. هذا فضلاً عن بقية الشركات والوزارات، فحدث ولا حرج.بعد كل هذا، هل من سبيل لاستبدال تلك الخدع بصور حقيقية؟أولاً: السعي نحو الحرفية والإبداع بعيداً عن حسابات “العلاقات الشخصية”، والذي سيعزز هذا الاتجاه، طبيعة المنافسة في السوق، والتحرك الجاد نحو “المختلف” للتميز عن بقية المنافسين، والوصول إلى ذلك لن يأتي إلا من خلال خلع “رداء” العلاقات الشخصية و”الواسطات”، وإن كان الأمر صعباً إلا أن شدة المنافسة وانفتاح السوق ستفرض معادلة جديدة।نأمل ذلك।ثانياً:تهيئة الكوادر المحلية، لتكون مؤهلة لدخولها بقوة في سوق صناعة الإعلان وإثراء هذه الصناعة بما هو مفقود فيها الآن، من لمسة محلية محترفة، وخطاب قريب من الفرد فكرة وصورة وكلاماً।ثالثاً: ارتفاع وعي واطلاع الفرد، من خلال “عيونه” المتعددة عبر الفضاءات المفتوحة له، وذلك عبر الإنترنت والفضائيات وغيرها، وبالتالي لم يعد الفرد المتلقي أقل إبداعاً ممن يصنع الإعلان। وهذا يحتم العمل الجاد على التعامل مع الفرد بكونه مدركاً، وليس فرداً يعيش في جزيرة نائية عن العالم الحديث في صناعته وتقنيته وإبداعه।رابعاً: إدراك الكثير من أصحاب الأعمال إلى نوع الخطاب المقدم للفرد، وبالتالي سعيهم إلى التعاون والعمل مع من يتقن لغة أهل البيت، فأهل البيت أدرى بما فيه। ولن تنفع أفضل الإعلانات في العالم إن أٌخذت كما هي ووضعت في مجتمع يختلف ثقافة وفكراً عن أساس وضع الإعلان لمجتمع آخر।خامساً: إقامة فعاليات تبرز القيم المغيبة في الإعلان، ورفع مستوى كفاءتها، والطرح الجاد للمواضيع ذات العلاقة بالعلامات التجارية ودور وكالات الإعلان في رفد هذا المضمار। على الأقل للتقليل من حدة سيطرة الإيهام البصري.وإلى حين وقت “اليقظة” يبدو أن ما سنشاهده هو تكملة لمسلسل المافيا والقص واللصق. أتمنى أن أكون مخطئاً وأرى ما ليس بخدعة بصرية. أتمنى!(١) من مقال للكاتب بعنوان ” Copy & Paste” بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٠٨م।(٢) من مقال للكاتب بعنوان “على الطاير” بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٠٨م।(٣) من مقال للكاتب بعنوان” ضحكة Kevin Roberts” بتاريخ ٧ مايو ٢٠٠٨م।* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي। -
الحمار والكرات والزهايمر
جعفر حمزة*التجارية ١٩ نوفمبر ٢٠٠٨م
أراد تيمور لنك أن يعلم حماره القراءة والكتابة، فأمر العلماء بذلك وهددهم بقطع رؤوسهم إن لم ينجحوا في ذلك। وتصاعدت الشكاوى إلى جحا والذي وعدهم بحل الأمر। فأخبر تيمور لنك أن باستطاعته أن يجعل الحمار يقرأ ويكتب جيداً، ولكن بشرط وهو أن الأمر يتطلب وقتاً يصل إلى خمس سنوات، فوافق تيمور لنك على الشرط। وعند خروج جحا من القصر لامه العلماء على ذلك وأخبروه باستحالة الأمر ولو بعد مئة سنة، فرد عليهم جحا بالقول: للخروج من تحقيق مطلب تيمور لنك، كان لا بد من اللعب على عامل الوقت، وخلال خمس سنوات، لا ندري ما سيكون، قد أموت أنا، أو الحمار أو تيمور لنك، وفي كل الاحتمالات لن يكون هناك مجال لمزيد من القتل।
لقد استند جحا للخروج من المحنة على عامل “تقادم الزمن”، والكفيل بتغيير الأمور والتوجهات، وترجع الكثير من السياسات القائمة في المجتمع البشري، سواء منها ما هو مرتبط بسياسة الدولة أو المجتمع في قوته الاجتماعية أو الدينية أو الثقافية، ترجع إلى عامل الزمن والرهان على نسيان ما رفعت الراية من أجله، أو على الأقل إضعاف “التمسك” بما يطلبه المجتمع والناس.
ويبدو أن خطة جحا قائمة على قدم وساق في مجتمعتنا وبصور عديدة، تتخذ من أسلوب “الكرات الكثيرة” عاملاً مساعداً لإشغال الناس عن الكثير من الملفات التي تمثل حقاً أصيلاً لهم في المعرفة والتغيير والتفاعل। ويقوم ذلك الأسلوب على “إشغال” اللاعب بالكرات والذي يحمل عدداً معيناً منها في يديه، بقذف كرات جديدة إليه، ليضطرب ويفقد السيطرة على التحكم بالكرات، ويصل إلى مرحلة “الفوضى الواقعية”، حيث لا سبيل له سوى التسليم بالأمر الواقع وكفى। لتسقط الكرات من بين يديه. والمواطن كحامل الكرات، لا يستطيع التعامل مع الكرات السابقة، ولا الكرات اللاحقة। ومع الوقت تكثر الكرات ويفقد مهارته في التقاطها، لينشغل في كل مرة بكرات جديدة، وهكذا।
وتمثل تلك السياسة استنزافاً للجهود والقدرات، فضلاً عن توهين للقوى والعقول، لنصل إلى مرحلة التشبع بالقضايا دون الوصول إلى حلول ناجعة مستندة إلى خطة قابلة للتطبيق وبالإمكان رؤية نتائجها، ولو على مدى متوسط. ويمكن سرد بعض الكرات “الملفات” التي توالت على الساحة المحلية دون وجود حلول جذرية لها، وتم اعتماد “تقادم الزمن” كما فعل جحا مع تيمور لنك، واتباع أسلوب “الكرات الزائدة” كما يفعلها من يريد أن يفشل ماسك الكرات. ومن تلك الكرات:الكرة الأولى: إفلاس مغارة علي بابا
فلا جديد تحت الشمس، بالرغم من خطورة الملف التي تعني كل مواطن بحريني بلا استثناء، ويبدو أن الفيروس الذي أصاب الهيئة قد نشط من جديد مع قضية قرض شركة “ممتلكات”। ألم يكن الإفلاس قبل فترة ليس بالطويل؟ صحيح إن النسيان نعمة. مع ذلك أتت الضربة الثانية مع “ممتلكات”. يبدو أننا مصابون بمرض “الزهايمر”-الشيخوخة المبكرة-، لننسى ضربتن في نفس المكان!الكرة الثانية: النفوس الرخيصة
هل تم وضع استراتيجية لمواجهة الكوارث، سواء الطارئة منها والطبيعية؟وهل لدينا في الوزارات والقطاع الخاص، فضلاً عن المنشآت المختلفة من المدارس مروراً بالمستشفيات وانتهاء إلى المصانع والمجمعات وحتى المساجد والحسينيات. هل لدينا في كل ذلك ثقافة مواجهة الأزمات وآلياته، لكي لا تتكرر الحوادث والمآسي؟ قد يكون أسلوب جحا هو الأفضل، سواء لدى المعنيين بالحكومة أو في المجتمع! الكرة الثالثة: الإثنين الأسود يبدو أن أسلوب جحا هو المتبع في هذه الكرة “الملف”، حيث يتكفل “الزمن” بنسيان هذا الملف ليتم تذكره في موسم الصيف فقط، ومع مرور “موسم الأزمة”، كأن شيء لم يكن। ويستمر الزمن في نخر الملف لنصل إلى درجة “الإنهيار”، والذي سيتوقف عندها الزمن، ولكن بعد فوات الأوان।
الكرة الرابعة: الفيروس القاتل بعض صور الفساد في ألبا وطيران الخليج وغيرها من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية أصبحت تراهن على من “يقذف” كرات أخرى لينشغل الرأي العام بها، ويغفل الكرات السابقة. ويتم هذا الأمر بصورة تدعو للإعجاب لا التقدير، نتيجة الرهان على القدرة المحدودة للذهن البشري في الاستيعاب وتحليل الأمور في وقت واحد. وللعلم فإن حجم الفساد المالي في ألبا كافٍ لبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، كما ذكرها الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف في برنامج “في الميزان”। فما بالك بغيرها؟
هذا فضلاً عن “التمييز الوظيفي” الذي ينكره البعض وهو يعيشه، ويخاف الحديث عنه. وبين فساد وتمييز ولد “فيروس” يقطع الأوصال ويخرج الرجال من الساحة.الكرة الخامسة: الردم والتحويل يمثل الزمن عاملاً مهماً في تثبيت الصور المغلوطة واعتبارها واقعاً، ويساعد ذلك تكرار العمل. وما عمليات ردم البحر غير القانونية، بالإضافة إلى تحويل الأراضي العامة إلى خاصة، بل وتحويل “المقابر” إلى وحدات سكنية للأحياء. وما كل ذلك سوى صور متكررة أثبتت واقعاً وسلوكاً غير “مستهجن”.
الكرة السادسة: ملفات “إكس” الطبية لقد ضرب التلوث الصناعي بأطنابه في قرى ومناطق مختلفة من البلاد، وألقى بظلاله السوداء على عوائل عانت الأمرين في أفرادهم، فأصيب بعضهم بالسرطان، وآخرون بتشوهات خلقية. هذا فضلاً عن الملفات الطبية التي تملأ الصحف بين فترة وأخرى، مما يعكس قصوراً في إحدى أهم أسس المجتمع المدني الحديث، وهي “الحرفية الطبية” بعد تحقيق “الرعاية الصحية”.
الكرة السابعة: المداس أم المدارس إن تكرار الحوادث التي تصيب الجسم التعليمي سواء في جنبته الإدارية أو المكانية “المدارس”، والتي تعددت أسبابها بين إدارية وسياسية واجتماعية، بعيدة عن الحرفية في بعضها، وقريبة من الارتجالية في بعضها الآخر، وبين هذا وذاك تتجذر الكثير من المشاكل لتصبح جزء من هوية وأساساً من سلوك. ليكون السؤال في أصل تحويل المدارس إلى معترك صراعات قد يستخدم فيها المداس أو أكثر. ولو أردنا تعداد الكرات لملأت ملعب كرة قدم أو أكبر، ولكننا اكتفينا بذكر سبع منها كسبع سماوات। ويبقى السؤال بعد تحليل المشكلة هو عن ماهية العلاج। فهل يمكننا وقف “قذف” الكرات، ليمكن بعدها التعامل معها بحرفية عالية وبواقعية بعيداً عن الإرتباك؟
وكما لا تستطيع العين البشرية إلتقاط الصور المتتابعة التي تزيد عن ٢٥ صورة في الثانية، فكذلك كثرة الملفات وتسارع وتيرتها في الظهور والنسيان يؤدي إلى تأصيل سلوك التراكم المنظم والنسيان السلبي، والمولد للكثير من تلك الملفات المعيقة لتطور المجتمع، فضلآ عن استقراره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي।
وللتعامل بحرفية مع كل تلك الملفات، لا بد من استخدام الآليات التالية، لنصل إلى مرحلة الحل بدل التخدير والنسيان:
أولاً: توزيع الكرات إن لم يكن هناك مجال لإيقاف تقاذفها। وذلك عبر تخصيص لاعبين مختصين لالتقاط الكرات، وعدم إنشغال الناس بتفاصيل مسار الكرات، فما يهم الناس هي النتيجة، وأما التعامل مع الكرات فيجب أن تترك لأهل الاختصاص، ولينشغل الناس بأوليات حقوقهم.
ثانياً: لتعرف هوية الصورة السريعة المقدمة إليك. لا بد من التقاط الصور بصورة أبطأ، لتدرك تفاصيل الصورة وملامحها، والوصول إلى ذلك يتطلب مهارة واحتراف من مختصين، وإعادة عرض “الفيلم” باللقطات البطيئة ليدرك المشاهدين “الناس” خبايا ما يشاهدونه، بعيداً عن “المؤثرات البصرية” التي تأخذ بالألباب وتشتت الناس وتدخلهم من باب إلى باب.
ثالثاً: توثيق دقيق لتوزيع الكرات وإبطاء الحركة، ليتوجه الناس إلى لقمة عيشهم وتطوير ذاتهم، في الوقت الذي يدركون فيه “الأولويات” التي تعيد ترتيبها بالقوة “لعبة الكرات المتعددة”، وبالتالي تكون لهم القدرة على “التحليل” و”الإدراك” و”الفعل”।
ويمكن القول بضرورة تكبير سعة الذاكرة أو على الأقل تنشيطها، لتتسع لهم حجم المشكلات، والسعي لحلها أو الحد من تفاقمها، وتحولها مع الزمن إلى “واقع”। وفي غير ذلك ستكون خطة جحا مع تعليمه للحمار سارية المفعول، وتواصل قذف الكرات موهبة والتقاطها صعوبة، لنكون بين هذا وذاك معرضين للإصابة بفقدان الذاكرة بسبب الشيخوخة المبكرة، بسبب كثرة الملفات وتواليها।* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.
-
من يصنع الخبز؟
جعفر حمزة*
التجارية ١٢ نوفمبر
كانوا جياعاً بل أكثر، وقد تركوا وثير ودفء الفراش من الصباح الباكر في يوم إجازة، ليلتحقوا بركب تأملوا فيه خيراً كثيراً، فأتوا زرافات وأفراداً لعل وعسى أن يجدوا “خبزاً” يأكلونه بعد أن يصنعوه. فهل وجدوا ما أملوا؟
“الشباب والإبداع” كان العنوان للمؤتمر الذي عقده مركز شباب الوفاق، وكانت ثيمته المميزة “حتى نُلهم الإبداع”. فهل كان العنوان ذو قدرة على توفير “خبز الإبداع” للحضور، أم أن “الشح” في توفير الخبز كان سيد الموقف؟
لسنا بصدد الإجابة والتعليق على المؤتمر بما حواه، بقدر ما كان كمفتاح لأبواب لا يحب البعض الحديث عنها، بل نريد أن نعرف معادلة “مغيبة” في صنع الإبداع الذي يجب أن يكون كالخبز لا غنى عنه. إبداع باتت السياسة تغطيه بظلال كالجبال وأكثر، مما جعل جياع المبدعين يبحثون عن “خبزهم” بدلاً من انتظار “كعكة السياسة” بحلاوتها اللاذعة والتي تسبب ارتفاع “السكر”.
فكيف نصنع الخبز؟
أولاً: توافر الأرض الزراعية
ضرورة توافر الأرض الزراعية وآلات الزرع والحصاد، فبوجودهما مع نظام ري جيد يمكن زرع القمح، وتلك الأمور هي بمثابة توفر آليات نمو الإبداع، والتي تتمثل في التقنية والمعلومات. وقد أصبحت كالمشاع في معظم بلدان العالم، وذلك نتيجة “الإنفجار المعلوماتي والتقني” في العالم، حيث لم تصبح التقنية “حكراً” على مجتمع دون غيره أو لدولة دون أخرى.
ومنها على سبيل المثال لا الحصر “مدينة السيليكون” وهي مدينة بانغلور الهندية، والتي تتميز بصناعتها لرقائق السليكون والعديد من مراكز الأبحاث والتطوير والتقنية العالية الدقة. والتي باتت بمنزلة “وادي السليكون” في أمريكا، بل وتنافسها.
وليس ببعيد عنها وعنا، فهناك إيران، والتي تطلع علينا الأخبار باكتشافات واختراعات علمية في السنين العشر الماضية. وذلك بالرغم من وضعها السياسي إزاء ملفات معقدة.فلم تعد التقنية مرتبطة أو “حصرية” على الرجل الغربي، بل قد أصبحت “مشاعاً” ومتوافرة، وينبغي على الأفراد كما على المجتمعات الاستفادة منها ومعرفة الوصول إليها أولاً والاستفادة منها ثانياً والاحتفاظ بها وتطويرها ثالثاً.
ثانياً: الزرع للخبز لا للسلطة
عندما تتوفر أرضية الإبداع من تقنية ونية مبيتة، لا بد أن يكون ما نزرعه في تلك الأرض هو من أجل الحصول على الخبز فيما بعد. وعندما يتحول الإبداع لدى البعض إلى كونه “سَلَطَة” أي كونه أمراً هامشياً، عندئذ ينتشر “فيروس التحبيط” ليحد الإبداع من النمو، وليُبدله بنظرة تشاؤمية تساهم فيها كل من الدولة والوالدين والأصدقاء ومؤسسات المجتمع وعالم الدين والمثقف-أو مدعيها- كل بنسبة معينة، لتتحول إلى عقلية سلبية لا تنتج وإذا أنتجت تم الحد من إنتاجها، وإذا أنتج غيرها انتقدت وثارت. وهكذا يتحول الإبداع من حل لحاجة إلى همًّ لا حاجة لنا فيه، وبالتالي يتحول المجتمع إلى “مجتر” للأفكار والأشياء دون نتاج ذاتي أو تغيير في عملية الإنتاج الفنية، والتي تمثل إحدى أهم صور التغيير في المجتمع.
لذا، عندما يتحول تعاملنا مع الإبداع إلى كونه “حاجة” ستتغير سلوكياتنا وتعاملنا مع أنفسنا والآخرين، ليكون الإبداع حلاً أساسياً لا هامشياً. هو حلٌ مادي وثقافي وفكري وديني وسياسي.وعندما يتعامل المجتمع مع الإبداع كحاجة، سيكون الاهتمام أكثر،وذلك عبر تخصيص وقت ومال وجهد له، لأن المنتج الإبداعي في آخر المطاف من فنان أو مخرج، ومن مصور أو مصمم، أو من كاتب أو خبير إضاءة، سيكون له مردودٌ مالاً ووقتاً وجهداً يشكل المجتمع بسلوكيات جديدة وبتعامل جديد مع المتغيرات.
ما نريده كلمة مشجعة من عالم دين تعبر عن التزامه وانفتاحه في نفس الوقت، وما نريده هو تفكير استثماري في الموارد البشرية المبدعة من قبل تاجر أو صاحب عمل أو مستثمر، وما نريده هو دعم عملي من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وما نريده قبل كل ذلك هو أن يؤمن المبدع بأن ما لديه أكثر من مجرد موهبة. هي مسؤولية يجب عليه أن يدرك أنها لا يمكن أن تتوقف بمجرد أن يسمع كلمة من يائس هنا أو من محبّط هناك، أو من تجاهل حكومي أو من تهميش مجتمعي. لأنه لا يمكن للإبداع أن ينمو إن لم تكن للنبتة قابلية للنمو أصلاً.
لقد حولت الحاجة العدسة الإيرانية إلى فن إنساني ملتزم وجعلها مدرسة عالمية في السينما، وحولت الحاجة شركات الرسوم الثري دي بماليزيا إلى فن إسلامي وجعلتها منتجة لأفلام الأنيميشن، وباتت تنافس كبرى الشركات العالمية في هذه الصناعة।
فأي حاجة نريد لنكون؟
ثالثاً: من الحقل للمخبز
بعد أن يتحول الإبداع إلى حاجة، لتكون الأخيرة صانعة له، علينا تحويل تلك الحاجة إلى الخطاب الذي يعيشه المجتمع، وذلك عبر التالي:
أ. تشجيع الكوادر الموهوبة بشقيها المُعلن والمخفي لضرورة إخراج نفسها من دائرة “الخوف” أو “العيش في جزيرتهم الخاصة”، وتسخير إبداعهم لأجل رفع العديد من المشاكل والعقبات وإيجاد الحلول عبر تشجيعهم مادياً ومعنوياً، وإفساح المجال لهم لتقديم إبداعهم بما يخدم المجتمع وقبله أنفسهم مادياً ومجتمعياً.
ب. عندما يكون المخبز مغلقاً فلا فائدة في الخبز الموجود بداخله، وكذا الأمر بالنسبة للمبدعين، فإن وُجدوا ينبغي أن يكونوا في مواقع التغيير، وأن لا يتم تحجيم تحركاتهم بـ”تابوات” يصنعها البعض، مرة بغطاء ديني وآخر بغطاء سياسي، وهكذا تتعدد الأغطية ليتم حجب “المخبز” عن الناس. وهنا تحتاج شجاعة دينية من لدن العلماء ونزولهم من “مكانتهم” إلى المبدعين الذين تمثل لهم موقف العالم لهم دعماً وقوة. وتحتاج شجاعة سياسية من لدن السياسيين عندما يتم توجيه الدفة للمبدعين لينتجوا.
ج، اقتناص المواهب الموجودة، والتي لها القابلية للاحتراف، وتطويرها لتكون منتجة مغيرة في المجتمع، ويمكن ذلك عبر ابتعاث موهوبين في مجالات مختلفة، وبالتالي يمكن الحصول على مبدع محترف بعد أن كان مبدعاً هاوياً، فالأول يُنتج على نطاق ضيق وقد يكون على نطاق شخصي وينقصه الاحتراف، في حين ينتج الآخر على نطاق مجتمع وتكون نظرته أوسع. وشتان بين الاثنين.
د. تزويد المجتمع بمعاهد متخصصة في مجالات الإبداع المختلفة، وتغيير أسلوب البذل المجتمعي، والذي بات حكراً على اتجاهات عبادية بحتة، ولم يعِ بعد قيمة الإبداع في التغيير الإيجابي، والذي يمثل الترجمة الحقيقية للعبادة، وهي الخلافة في الأرض لإعمارها.
فالدعم الحقيقي للإبداع لن يأتي من خلال “تعليق” الحجج على الدولة وإن كانت ساحتها ليست ببريئة عن التقصير الكبير في هذا المجال. إلا أننا نؤمن بأن قدرة المجتمع على التغيير ليست بأقل من قدرة الدولة. وما دام المجتمع لا يؤمن بأهمية الإبداع في الفن -على سبيل المثال- من جهة، وتتجاهل الدولة بطريقة أو بأخرى المبدعين من جهة أخرى، فسيكون نمط التصدي للأفكار الجديدة والغريبة عن المجتمع ضعيفاً، وبالتالي وإن كان اللوم جاهزاً والخطب العصماء معدة مسبقاً، عندها لن ينفع البكاء على اللبن المسكوب.
ويمكن أن تكون المعاهد المذكورة متعاونة مع أخرى متخصصة خارج البلاد أو الاستعانة بالمحترفين في البلد، منها على سبيل المثال لا الحصر: في مجال الرسوم ثلاثية الأبعاد، التصميم المحترف، كتابة السيناريو، الإخراج السينمائي، تصميم الملابس، والقائمة تطول.هـ. تعزيز الاتجاه في الاستثمار البشري للأفراد المبدعين، حيث سيكون ذلك بمثابة التعاون الثنائي بين المستثمر “جهة أو مؤسسة” والكادر المبدع، إذ يدعم المستثمر المبدع مادياً، ويقوم الأخير بتقديم إبداعه من أجل المستثمر ضمن اتفاقية لا يتم احتكار المبدع فيها، ولا يتم صرف مال المستثمر فيها دون عائد.
وإذا ما زالت القدرة المالية والتقنية موجودة الآن ولم تتم الاستفادة منها، فسيكون اللحاق بركب التطورات فضلاً عن التحصين والظهور الإبداعي سواء على مستوى الدولة أو المجتمع أصعب.
وبالتالي لن يكون هناك لا خبز ولا سلطة ولا هم يحزنون..ملخص ورقة تم تقديمها في مؤتمر الشباب والإبداع الذي نظمه مركز الشباب التابع لجمعية الوفاق البحرينية السياسية بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٠٨م صمن عنوان “معوقات الإبداع في البحرين”.
* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.
-
صندوق وبالونين
جعفر حمزة*
التجارية ٥ نوفمبر ٢٠٠٨م
بعد تناولنا لأطراف حديث شائك عن مدى ثقة الناس بما يسمعون أو يقرؤون على أرض هذه الجزيرة-ولم تعد كذلك-، خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع “المستقبلية” والرؤى “الطموحة”، بل والصورة المقدمة عن وطني البحرين في الخارج. بعد أن أوشكنا على رسم “خارطة الطريق” التي نحلم بها، بعد كل ذلك انقدح في ذهني سؤال لم أشأ أن أخفيه عن صاحبي الآتي من بريطانيا “العظمى”، فبادرته بالسؤال: مستر (إكس)(1)، ما هي مشكلتنا هنا؟
سؤال أردت الإجابة عليه ببساطة السؤال نفسه –لغوياً طبعاً-، فقالها “ببساطة” لم أتوقعها منه: لديكم مشكلة غياب ثقة.
وقد شكلت إجابته “مفاجئة” لي، لا لأني لا أعرف الإجابة بقدر أنها تأتي من شخص مثقف ومحترف يعرف “دهاليز” السياسة كما يعرف كل شبر من لعبة الاقتصاد في المنطقة.
ولم أكتفِ بهذه الإجابة، وكيف يكون ذلك، وقد سنحت لي الفرصة بالحديث مع شخص قد وضع يده على الجرح مباشرة ودون خوف أو وجل -ولا مجال لمساءلته بالمرة-، فقلت له وما الذي يجعل الثقة غائبة؟
فأكمل إجابته بصراحته الأولى قائلاً: عندما توعد ابنك بشيء وتكرر إخلافك بوعدك، فلا تتوقع أن يصدقك ابنك مرة أخرى.
واعتقد أن المشكلة الخاصة بالثقة تتفاقم إذا دارت حول أساسيات معيشية لا غنى لأحد عنها، بل حتى الحيوان لا يمكنه الاستغناء عنه، وهو السكن.
وليس بهرم “ماسلو” ببعيد عن ذاكرتي عندما يخطرني هذا الحديث، ففي هرم “ماسلو” يمثل الأمان والسكن قاعدته الأساسية، والتي تمثل احتياجات الإنسان الفسيولوجية. في حين يتم الحديث هنا عن قمة الهرم من “تحقيق للذات ” على مستوى الدولة.
ويقع في الصميم المثل الشعبي القائل “ما عنده ياكل، عنده يغرم”. حيث يتم الحديث عن العتبة العاشرة من سلم الدول التي تريد أن تترك بصمتها في العالم، في حين أن العتبات الأولى لم يتم وضع القدم عليها بثبات بعد.
لقد أصبح الحديث عن السكن، وهو أمر معيشي إنساني دستوري أساسي، أصبح الحديث عنه “هماً” في حين يجب أن يتحول إلى مرحلة “نحصيل حاصل”، ليتم الحديث بعدها عن بقية العتبات القادمة ضمن سياق التطورات والتحديات التي تواجه العالم يوماً بعد يوم في العديد من المجالات.
ولم تكن “مطالبات القرى الأربع” بالمشروع السكني “لها”، ولم يكن المدينة الشمالية والمطالبات بتحقيق حلم قد “تلاشى”، ولا العديد من الطلبات ورفع الأصوات هنا وهناك للحصول على “قُطيعة” أرض للسكن فيها، لم يكن كل ذلك “مُسيساً” أو “موجهاً من الخارج” أو تم تحريض أولئك المواطنين من قبل جهات تريد سوءً للبلد.
بل هي مطالبات أساسية أصبحت تستنزف من وقت الناس وتفكيرهم وجهدهم ما لا يوازيه “صرف” ميزانية يستحق المواطن أن يوجه اهتمامه للتطوير والإبداع والإنتاج، بدلاً من البحث عن مصادر دخل إضافية لعل وعسى أن يسدد دينه، ليدخل في حلقة جديدة من الديون دون اقترابه من احتمالات الحصول على أرض أو منزل، واللذين باتا كسراب يحسبه المواطن ماء.
فهل تستطيع نفخ بالونين معاً وهما في صندوق صغير؟ مع ضمان أن لا ينفجر أحدهما أو كليهما؟
ليست هذه بأحجية أو تجربة علمية، بل هي واقع نشهد “انتفاخ” بالونيه معاً، فمع تصاعد موجة الغلاء وبطأ –إن لم يكن توقف- في حل مشكلة الإسكان، ستتهاوى الطبقة المتوسطة لتنضم إلى الطبقة الفقيرة لتتوسع تلك الطبقة “أفقياً”، في قبال “انتفاخ” الطبقة الغنية وتوسعها “عمودياً”، ومع ذينك “الانتفاخين” في “صندوق” السكن، ستكون الاحتمالات التالية:
أولاً: إما أن “تنفجر” إحدى الطبقتين وتتناثر.
ثانياً: أو “تنفجر” الطبقتين معاً، نتيجة الاحتكاك الشديد.
وللحد من أي “انفجار” قد يحصل، لا بد من تحقيق أحد أمرين:
أولاً: وقف “النفخ” في البالونين.
ثانياً: وضع صندوق أكبر، ليأخذ كل بالون مكانه و”راحته”.
لقد وقعت الدولة في أخطاء جمّة لن تكون نتائجها “صورية” متمثلة في اعتصام هنا أو ندوة هناك، بل ستساهم تلك الأخطاء في تكوين سلوكيات اجتماعية جديدة “ستنفجر” نتيجة “الصندوق الضيق”.
فما تلك الأخطاء التي ندعي وقوع الدولة فيها، وهل يمكنها وضع حل لها:
أولاً: استملاك غير قانوني للكثير من المتنفذين لمساحات شاسعة، وغياب الآلية القانونية للحد من “انتفاخهم”.
ثانياً: الاستملاك الحر للأجانب، دون تحديد المناطق التي يمكنهم استملاكها، مما سمح لهم بالانتفاخ في كل اتجاه، ومضايقة المواطنين في “بالوناتهم” الصغيرة.
ثالثاً: غياب “الهواء” لبالونات المواطنين، عبر “فتات” الموازنة المرصودة للإسكان، بالرغم من فائض الميزانية نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
رابعاً: التجنيس خارج إطار القانون والدستور، وغياب الأرقام الحقيقية لذلك، وتبعات ذلك بالاستمرار في “نفخ” أزمة الإسكان بالبحرين.
خامساً: غياب التطبيق العملي لأي خطة “طموحة” قد يتم طرحها للحل من مشكلة الإسكان أو على الأقل التخفيف منها عبر مراحل معلنة بشفافية.
وما يتبع كل ذلك من آثار لا تخفي على مواطن، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
أ- تكدس سكاني كثيف، وتبعات ذلك في تشكيل الهوية البحرينية وتغيرها مع نمط المعيشة السكني، فضلاً عن السلوكيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، والتي لا تعبر بالضرورة عن هوية “الإنسان البحريني”، فضلاً عن دخول الكثير من “المعاملات” غير القانونية في تلك السلوكيات لتأمين مستوى دخل “محترم” لدى الأفراد.
ب- ترهّل في الطبقة الوسطى، مما يعني وضع ميزان استقرار المجتمع في ظرف حرج.
ت- حركة البنوك “الشرهة”، والتي تستغل “الحاجة إلى السكن” في عروضها وسياستها وإعلانها. حتى باتت تلك البنوك تتجه للنفخ في إحدى البالونين، فبنوك “تنفخ” في بالون الطبقة المتوسط عبر عروضها “الوردية”. وبنوك تنفخ في بالون الطبقة الغنية عبر مشاريع وتجمعات سكنية للصفوة الذين لا يُساوون مع أحد أبداً. وبين ذلك النفخين تتفاقم مشكلة الأرض والقرض.
وعوداً إلى أحجية الصندوق والبالونين، فالحل ذكرناه، وتطبيقه يتمثل إما في دعم “واقعي” لحل مشكلة الإسكان عبر خطة عملية يلمسها المواطن. أو من خلال الحفاظ على الطبقة الوسطى في البقاء في “وسطيتهم” المادية.
وهناك حل آخر، وهو “توسيع” الرقعة السكنية، وفتح “الأسوار العالية المغلقة” للناس، وما أكثرها، لا ليعيش الناس في “بلاد العجائب” كما كانت “أليس”، وإنما ليعيشوا في بلد يمكنهم أن يناموا ويفكروا كيف نبني بلداً قوياً ومميزاً، بدل التفكير، هل سآخذ القرض أو اعتصم للحصول على “منزل” أو قطعة أرض؟
ففي حين يتم السباق على الأدمغة والتطوير، يكون السباق والهم هنا هو القروض والحصول على أرض، وهي في الحقيقة حق كفله الدستور والعقل والمنطق والواقع.
فهل يستمر النفخ أو يتم تكبير الصندوق لتتم “الثقة” الغائبة التي حدثني عنها صاحبي البريطاني؟
مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.
(1) لا أتذكر اسمه، فضلاً عن الاحتفاظ بخصوصيته.
-
300
التجارية ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٨مجعفر حمزة *
كانوا ٣٠٠ فقط قبال جيش جرار يحجب الشمس إن رمى السهام، ومع ذلك بقيت اسطورة أولئك النفر باقية لحد الآن، بغض النظر عن كل الملاحظات التاريخية عن القصة، والذي ترجمها الفيلم السينمائي الذي حمل عددهم اسماً له. ويشهد التاريخ تجارب من مختلف الديانات والحضارات أن العدد ليس هو الرهان الوحيد الذي يمكن الاتكال عليه للمضي قُدماً في تحقيق الانتصارات، سواءً على الصعيد العسكري أو الاجتماعي، أو الاقتصادي.
ومن الحكمة قراءة تلك التجارب، وأولها تجارب من حضارتنا الإسلامية، والتي تقدم أساساً للتنمية والتغيير، وتعتمد تلك المعادلة “المنتصرة” على مثلث تتمثل أضلاعه في التالي: الضلع الأول: وجود الرؤية. الضلع الثاني: وجود آليات تطبيق الرؤية. الضلع الثالث: وجود الكوادر التي تؤمن بالرؤية وتأخذ الأدوات لتطبيقها.
ولو لم تكن هناك رؤية واضحة للجنود ال٣٠٠، ما تحركوا شبراً واحداً من مكانهم، وكانت لهم الآليات الكفيلة بثباتهم في المعركة، عبر ما استفادوا منه من أدوات وذكاء। وقبل كل شيء كان هناك الجنود المؤمنون بما يقومون به، وبالتالي تحققت رؤيتهم، لتصل عبر آلاف السنين إلى يومنا هذا ليكون فيلماً سينمائياً بعد أن كان له حضور في القصص المصورة.
وفي العديد من تجارب العصر الحديث أمثلة أخرى للأخذ بمثلث التغيير، منها على سبيل المثال لا الحصر اليابان، فخلال ٦٠ عاماً تحولت من دولة منكوبة بقنبلة نووية مطأطأة الرأس مهزومة إلى ماسكة وبشدة اقتصاد قوي لا يُستهان به. وكذلك هي سنغافورة وهونج كونج وإيرلندا، والعديد ممن آمنوا برويتهم واستعملوا الأدوات اللازمة، وبين هذا وذاك كانت الكوادر التي طبقت الرؤية فظفرت مجتمعاتهم بالتميز والتغيير الإيجابي.وفي جزيرتنا الصغيرة، فإننا نتطلع إلى٢٠٣٠، إذ تمثلت عبر رؤية وطنية تمت صياغتها ومشاركتها مع المختصين والخبراء والمعنيين، وذلك من أجل رفع مستوى الوطن والمواطن عبر ملفات عدّة ستضع البحرين عبر إنسانها على طريق العالم، بدلاً من الجلوس على جانب الطريق।
وليس ذلك ترفاً أو “مظهرة” كما يحسبها البعض والذي اختلف معهم بشدة، فوضع رؤية اقتصادية للدولة مع وجود خط زمني لتحقيقه أمرٌ أصبح ضرورياً لتلك الحكومات التي تريد أن يكون لها موضع قدم في خضم التغييرات الدولية والتي تتسارع بوتيرة لا مجال للتنظير والكلام، فالقطيع الإلكتروني لا ينتظر أحداً أبداً.(١)إنّ رؤية البحرين ٢٠٣٠ هي حلم كل بحريني، لأنها تعكس أكثر من مجرد مطالب أساسية له، بل تتعدى ذلك إلى خطوات متقدمة في المجال الاقتصادي، والذي بات أمراً لا يمكن غض الطرف عنه، في ظل ظروف متغيرة بوتيرة سريعة جداً. وما نرمي إليه هنا ليس في مناقشة الرؤية، فواضعوها أولي خبرة واختصاص، بل إن ما نود طرحه هو إمكانية تحقيق تلك الرؤية عبر مثلث الإنجاز الذي ذكرناه بالمقدمة.
الضلع الأول: الرؤية إن الرؤية المقدمة قد تم صياغتها بعد تشاور من قبل المختصين والمعنيين في البلد، وبما هو مطروح منها، فهي تمثل غاية كل مواطن ينشد حياة كريمة يستحقها، فضلاً عن دوره التغييري في عالم اليوم. وخصوصاً مع تصاعد التحديات في مجال الطاقة والاستثمار، وغيرها من الملفات التي تمثل تحدياً متواصلاً للدول، وليس البحرين ببعيدة عنها.
الضلع الثاني: الآليات قد تكون حجة ضعف الآليات وارداً قبل ٣٠ إلى ٤٠ سابقة، أما الآن فإن التقنية والتطوير في آليات التنفيذ وأخذ المشاريع وتطبيقها على أرض الواقع أصبح ممكناً، بل ومتاحاً لدى الكثير من الدول النامية. وبالتالي تسقط حجة غياب الآلية أوضعفها، بل أن تلك الآليات أصبحت في متداول أيد الدول عبر مفاوضاتها الثنائية ومعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم المختلفة. وعند الحديث عن دولة خليجية كالبحرين، فإن الآليات والتقنية تتمتع ببيئة يمكن أن تكون أكثر من مميزة ومعلماً في منطقة الشرق الأوسط. ولا أدل على ذلك من توافر التقنيات وعقد الاتفاقيات مع كبرى الشركات في العالم في مجال الحاسوب والاتصالات، والتقنيات الصناعية المبتكرة، وما يمكن الحصول عليه أكثر مما هو موجود حالياً. وبالتالي يتحقق الضلع الثاني في تنفيذ الرؤية. فمن التالي؟
الضلع الثالث: الكوادر وتتمثل الكوادر في صفين، هما الصف الأول المتمثل في القيادات وماسكي الرؤية والمطالبين بتطبيقها والأخذ بها، والصف الثاني هو في الكوادر الوطنية التي يٌعتمد عليها في معايشة تلك الرؤية عبر عملهم وإبداعهم وابتكارهم وتفانيهم، بل وتنفس تلك الرؤية في كل يوم عمل، بل وفي كل سلوك يومي، لتصبح عقلية ممارسة بدلاً من رؤية اقتصادية مطروحة في المحافل الداخلية والخارجية.
وما يهمنا هو الضلع الثالث، والذي سيكون “الورقة الرابحة أو الخاسرة” لهذه الرؤية، بل ولكل مشروع يتم طرحه. فهل هناك كوادر مؤهلة لتبني الرؤية المطروحة للبحرين ٢٠٣٠م؟ تذكر التقارير من ديوان الرقابة المالية والتي تظهر قدراً واضحاً من الشفافية مقدار الخلل في العديد من الدوائر الحكومية، مما يسبب ضعفاً لا في الرؤية الموجودة ولا في الآليات المستخدمة، بل في الكوادر الماسكة بزمام الأمور، فالفساد المالي أو الإداري، لا يأتي من الرؤية ولا من الآلية التي ترسمها الرؤية، بل تأتي من الكوادر. لذا تم توضيح ذلك وبجلاء عند تدشينه للرؤية، عندما قال الملك بأن هذا البرنامج ملزم لجميع الدوائر الرسمية، مع أنه لها الحق أن تناقشه وتطوره… ونحن وجدنا أن الأفضل أن تكون لدينا آلية التواصل لإنجاز الأمور بصورة مشتركة، فالمسافات في البحرين قريبة، ومكاتبنا قريبة من بعضها بعضاً، ولدينا وسائل الاتصال المختلفة، فلا عذر لأي شخص أن يعمل في مسار لوحده خارج إطار الرؤية المطروح”.
وبالتالي، تم وضع النقاط على الحروف وبصورة واضحة جداً، ليكون العنصر البشري هو المسؤول عن تطبيق الرؤية من أجل العنصر البشري نفسه أي المواطن، حيث تابع الملك قوله: «الهدف من هذه الرؤية الاقتصادية للعام 2030 هو المواطن، الفرد البحريني، فالتنمية التي لا يكون المواطن هدفها لا فائدة منها ولا نريدها… إن المواطن هو الثروة الحقيقية في البلد، والمواطن البحريني اثبت ذلك في مختلف المجالات»।
وللوصول إلى ذلك، لا بد من نزع العقبات التي يشكلها بعض الأفراد، لتتحول إلى عرف مُعاش ومعوق أساسي في التنمية، ومن تلك المعوقات التي لا يمكن إنكارها، مع الاختلاف في طريقة معالجتها، هو التمييز الوظيفي، فلا يمكن التنمية مع وجود تمميز وظيفي يوصلنا إلى وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، وتبعات ذلك المالية والوظيفية والتطويرية وغيرها على الوطن والمواطن في نفس الوقت.ويمكن الرجوع إلى تقرير منظمة “إنترناشونل كرايسز غروب” حول التمييز الوظيفي في البحرين، فضلاً عن معاينة يومية بسيطة تتوضح عبرها الكثير من صور التمييز التي تهدر الطاقات البشرية المؤهلة على حساب فئوي أو عائلي أو مذهبي أو سياسي. إذاً هناك خلل في مثلث المضي نحو الرؤية بالرغم من وجود الأخيرة، وهي الآن أوضح من ذي قبل، وبالرغم من إمكانية توفير الموارد، ومع ذلك يبقى السؤال حول إزالة عقبات التفكير الذي يقدم للمواطن الصورة السلبية ويُفقده الثقة بما هو مطروح، حين يرى أن لا بيت يؤيه، ولا يعمل يتناسب مع دراسته، بالرغم من وجود العديد من الفرص، حيث تكون الأبواب مغلقة ولا يمكن فتحها إلا برقم سري لا يملكه، نتيجة تكاثر تلك العقلية التي تريد أن تجر النار لقرصها فقط. ملفات التمييز، الفساد الإداري والمالي، والتحرك خارج إطار القانون والمسائلة لبعض الأفراد، يشكل تحدياً كبيراً في تطبيق رؤية نؤمن بها ونسعى لتحقيقها، فلا بد من إنزال “الهاند بريك” لتسير السيارة، فلا يكفي شحنها بالبنزين والضغط على دواسة السرعة إن لم يكن “الهاند بريك” قد تم إنزاله.
فهل تسير البحرين كما مضى ال٣٠٠، في خضم تحديات لتبقى؟ أم أن بعض قادة الجيش باتوا ينشرون التفرقة بين أفراده، لينقسم ال٣٠٠ إلى عشرات هنا وهناك، وبالتالي تضيع وحدتهم على الرؤية।، ولنصفى على فرقة تؤمن نظرياً بما هو مكتوب، وأخرى تسعى بإخلاص وهي قليلة لتطبيقها، وفرقة ثالثة تسابق الزمن لوضع أكبر قدر ممكن لمصالحها الخاصة
وللابتعاد عن سيناريو الفرق الثلاثة، ينبغي وضع كافة الدوائر الحكومية بلا استثناء في حالة تأهب وتغيير في بيئة العمل للقيام بتطبيق الرؤية، ويكمن ذلك من خلال تأسيس مكتب متابعة لتطبيق رؤية البحرين ٢٠٣٠ في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية، فضلاً عن مساندة القطاع الخاص في تنفيذها، وذلك بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية. ومع وجود جيش جرار من التحديات والعقبات على المستوى الداخلي والخارجي، ينبغي أن تكون لنا روحية ال٣٠٠ لتتم الرؤية وتُستخدم الآلية وتعمل الكوادر
فهل يكون؟ أم سيكون الرقم ٢٠٣٠ مثل الرقم ٣٠٠، مجرد عنوان وسيناريو فيلم استمتعت بمشاهدته واستذكرته الآن،بعد أن صرفت سعر تذكرة المشاهدة وحسب؟(١) مثال ذكره توماس فريدمان في كتابه” السيارة لكزس وشجرة الزيتون”، بما يتعلق بضرورة اللحاق بالمتغيرات المتسارعة في عالم اليوم.
*مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.