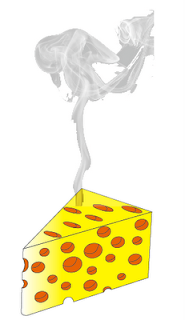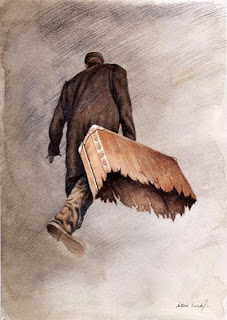-
صلاة “غوتشي”
جعفر حمزة*
التجارية ١٣ أغسطس ٢٠٠٨م
شدتنّي بالرسم الموضوع عليها، فكانت بيضاء وما زاد بياضها وشمٌ أسود، فلا عتب على الناظر إن تأمل فيها ونظر، وكانت من بين أخريات “عاديات”، فهي “المُلفتة” -على الأقل بالنسبة لي-، فاقتربت بُغية “التعرّف” عليها، فصافحتها بيدي، فكانت رقيقة وخفيفة، فطمعت أكثر، فنظرت إلى ذلك الرسم، وتعجبت، أنّى لها بذلك الرسم لماركة معروفة، وتضعه عليها وتُعلنه؟
قلبتُ تلك “الشيلات” الموجودة على الرف في سوق “شعبية” بالسالمية في الكويت، تراءى لي العديد من تلك “الموديلات”، بين “شيلات” و”حجاب” و”ثياب نسوية محتشمة”
، فما الرسالة من وراء ذلك؟ وهل “تلتفت” تلك الماركات العالمية إلى السوق المحلية، سواء المسلمة أو غيرها لتقدم “المنتج الثقافي المحلي” بعلامة جودة ماركة عالمية؟ وهل يمثل “التقرب” الذي تقوم به تلك الماركات خطوة سُتضيف لها الكثير في ميزانيتها التي تُعد بالملايين بل أكثر؟
غني عن القول أن الماركات العالمية لا تصل إلى صورتها الحالية، إلا بعد تثبيت مكانتها في العقول عبر تثبيتها البصري، والذي يصل في الأخير إلى مرحلة السلوك المندفع للشراء، والحصول على “الصورة المرتبطة بالماركة”، وما يتم دفعه للماركة هما عنصرين أساسين، قيمة المنتج وصورته المقدمة।
وعوداً إلى مكانة الماركات العالمية في المجتمعات المحلية ومكوناتها الثقافية المختلفة، فإن العنصر الثاني هو الذي يتحرك ليقدّم صورة “مقربّة” من المجتمع فيما يؤمن وفيما “يسلك”، وبالتالي يكون دخول الماركات العالمية بنكهات محلية شيء طبيعي، بل ومطلوب في كثير من الأحيان، وخصوصاً إذا تعلق الأمر بمجتمع له تمثيلات ثقافية متعددة. كالإلتزام بالحجاب -بصورة عامة، لا بالمعنى المحافظ- والبحث عن الطعام “الحلال”، وتلك السلوكيات في المجتمعات العربية والمسلمة يسري أمر الأخذ بها بطريقة مختلفة في مجتمعات مختلفة، فالمجتمع الذي لا يأكل اللحوم-على سبيل المثال- تكون ماركات الطعام النباتي خياره الأول، وبالتالي تكون فرص بقاء تلك الماركات وتميزها وحساب الأرباح أوفر حظاً من مثيلاتها من اللحوم أو المأكولات البحرية.
وبعبارة أخرى، فإن الماركات العالمية تبحث عن “حضور” في كل مجتمع يمكن لها أن تتحدث بلغته، لتكون قريبة منه، وبالتالي تتحول إلى جزء من حياتهم اليومية، والوصول إلى تلك المرحلة هو نجاح مستمر، ما دامت الناس تؤمن وتسلك ما تعتبره هوية كامنة فيه، ولا تنفك عنه।
والسؤال الأهم، هل هناك ماركات تبحث عن هوية المجتمعات و”تراعي” لها؟ ربما نعم، وربما لا، فهناك ماركات تبحث في أسواق المجتمعات ذات الطبيعة الثقافية المعينة، والتي -بشرط- تشكل سلوكياتهم الشرائية، فتدخل تلك الماركات لتحجز “مساحتها” عبر يافطات متعددة، منها:أولاً: المعروض مباشرة والذي لا “تلاعب فيه”، كأن يكون الطعام المقدم مذبوحاً وفق الشريعة الإسلامية، أي أن يكون “حلالاً”، وتنظر الكثير من سلاسل مطاعم الوجبات السريعة “فاست فود”إلى هذا الأمر بجدية وبخطة متكاملة في مراحل متقدمة، ليس في البلدان المسلمة فقط، بل في المجتمعات المسلمة في الغرب أيضاً. فهم قوة شرائية قبل كل شيء.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، قدّمت “ماكدونالد”الكثير من الأطعمة مع وجود كلمة الجذب “حلال” على منتجاتها والعديد من أطباقها في الدول العربية।
ثانياً: تتسع دائرة المظلة الثقافية، لتصل إلى “المذاق المحلي” عبر تقديم منتجات وأطعمة بنكهة عربية، كالذي فعلته “ماكدونالد” وبعض سلسلة المطاعم السريعة العالمية، بتقديم بعض منتجاتها بالخبز العربي مثلاً.ثالثاً: هي خطوة متقدمة عندما تقدم الماركة “نمطاً” ثقافياً جديداً يتواءم مع الشخصية المحلية للمجتمع। من خلال صياغة “كلام محكي” تستأثره لنفسها، أو من خلال صورة ثقافية محلية يتم تقديمها مع الصورة الأم للماركة. ولم نرَ ذلك الثقل لأي ماركة عالمية وصلت لهذا الحد إلى الآن في الوطن العربي.
وما ذكرناه آنفاً، يسري على تلك الماركات العالمية التي تريد حضوراً يومياً وتسعى إليه. وليست كل تلك الماركات تقدم “تمثيلاتها الثقافية المحلية” وهي تقصد ذلك، فهناك ماركات تظهر على الصور الثقافية المحلية دون أن تدري هي أصلاً، حيث يقوم طرف ثالث بـ”استغلال” قوة الماركة ويتم طرح بضائع باسمها في الأسواق، وما على البائع إلا انتظار “الانجذاب” الطبيعي لتلك الماركة متمثلة في “حجاب، شيلة، حقيبة، إلخ”.لقد رأيت الكثير من “الشيلات” التي تحتضن ماركات مشهورة في الحقائب “غوتشي”، بل ووصل الأمر إلى أن تتحول ماركة “كاديلاك” للسيارة الأمريكية إلى “موضة” في الكويت للفتيات، حيث بات موضوعاً على ثياب نسائية مختلفة، و”شيلات “وحقائب يدوية وغيرها، ليصل سعر إحدى قطع الثياب إلى ٤٥ ديناراً كويتياً فقط! وعند سؤالي للبائعة عن السبب في هذا “الاندفاع” إلى ماركة سيارات موجودة على مستلزمات نسائية، قالت وبثقة، لأن ” كاديلاك” معروفة بفخامتها واسمها، وتحب النساء أن يلبسن شيئاً يرمز إلى ذلك، فهو يعكس “مقامهم” وقبل كل شىء، فهي “موضة”، ولا يحتاج الأمر إلى سؤال أو تحليل.
ونرى أن هناك حركتين تُشكل حضور الماركات العالمية في الكثير من المجتمعات ذات الطابع الثقافي السلوكي عندها، كالمجتعمات العربية والمسلمة، وكل تلك المجتمعات ذات السلوك الثقافي المميز لها يومياً في هويتها من أقاصي شرق الصين مروراً بالهند وأفريقا وأوروبا وانتهاءً إلى مدن أمريكا اللاتينية. وتلكم الحركتين هما:
الأولى: من المجتمع إلى الماركة: متمثلاً في قوة الشراء الحاضرة في ذهن المستهلك، والنتيجة تقديم الماركة لنماذج تتناسب مع “مجموعات شرائية” لم يشملها الخطاب العام، لذا تقدم “دعوة خاصة” لتلك المجموعات عبر التحدث بلغتها، لتشملهم دائرة الاستهلاك، وتلك هي الطريقة الرأسية، فهي من الماركة إلى المجتمع مباشرة।
الثانية: من الماركة إلى المجتمع: حيث يبدأ “خطاب الود” بين الطرفين من الماركة عبر تقديمها لنماذج متعددة ومتنوعة ليقترب منها المجتمع، ومن بعدها تتوسع “اجتماعياً” أي بالطريقة الأفقية. وفي كلتا الحركتين، يكون مقياس النجاح ليس في انتهاء البضاعة من على الرفوف أو الصحون، إذ يكون الربح “مؤقتاً”، بل النجاح يكمن في بقاء صورة الماركة في ذهن المستهلك لينجذب إليها الآن وغداً وما بعد غد.
وذلك الأسلوب في الخطاب أي التحدث بلغة المخاطب ثقافة وصورة، هو مكمن سر العلامات التجارية المعولمة-كما يسميها “جوزيف س। ناي”وهو رئيس مجلس المخابرات الوطني ومساعد وزير الدفاع في إدارة “كلينتون”، حيث يذكر في كتابه “القوة الناعمة، وسيلة النجاح في السياسة الدولية”، بأن تغيرات السوق (ومن بينها ما ذكرناه بالأنماط الثقافية في المجتمعات) قد أنتجت تجزئة متزايدة للعلامات التجارة المعولمة للشركات الأمريكية. فقبل عقد من الزمن ومع سقوط الحواجز المعيقة للتجارة فإن العلامات التجارية ذاتالنطاق العالمي سوف تطرد العلامات المحلية. والواقع أنه عندما تقاطعت حالات القلق على الاستقلال الذاتي المحلي مع التقنيات التي تتيح تحقيق اقتصاديات ذات منتجات كبيرة وواسعة النطاق في تميزها وتخصصها، راح توحيد مقاييس العلامات التجارية يتعرّض للتحدي. فلشركة الكوكا كولا أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية (كثيراً ما تكون غير مرتبطة مع الشركة الأم بشكل مكشوف)، بينما تغير “ماكدونالد” قوائم أطعمتها بحسب المناطق.واستجابات شبكة “إم تي في” ببرامج مختلفة للبلدان المختلفة.
وإن بدا من الأمر الحضور الفاعل والقوي للثقافة المحلية، إلا أن التعويل عليها لن تكون نتيجة ما نود قوله، فهي “عامل حفّاز” وفي بعض الأحيان هي “المادة الخام” وفي أحيان أخرى هي “كماليات”، لذا تقوم الماركات العالمية بضبط استراتيجيتها واستخدام كل الصور المتاحة بما يتناسب مع رفع علاقة الجذب بين الماركة والفرد. ونعتقد أن من الأمثلة الحية في استخدام الأنساق الثقافية المحلية وتوظيفها عبر تقديمها بمستويات احترافية هو الدمية “فلة”. وستستمر عملية الخطاب والتقديم للمجتمعات المختلفة ذات الهوية الثقافية السلوكية ما دام ذلك يشكل “تقرباً” من الفرد المستهلك ويحعله يمد يده لجيبه ويدفع ما يراه “مناسباً و”ملائماً” مع ثقافته في أكل وشرب وملبس، في الوقت ذاته الذي يكون جزءً من العالم في صوررته المعولمة. وهذا ما يبحث عنه الكثيرون، مسك العصا من النصف، الاحتفاظ بالهوية والظهور بالعالمية. فهل نرى الفورمولا ون على حجاب المرأة، أو “غوتشي” لغطاء الصلاة؟ ربما॥ -
نشاز
جعفر حمزة*
التجارية ٤ أغسطس ٢٠٠٨مجاءني صاحبي – وهو من أحد البلدان الأوروبية- سائلاً إذا شاهدت الدعاية التلفزيونية لتشجيع الاستثمار في البحرين على قناة البي بي سي البريطانية. ففرحت كثيراًبمجرد سماع أن هناك إعلاناً تلفزيونياً تم بثه في قناة عالمية، ولم يجعل فرحتي تكتمل، حيث علّق على الإعلان وهو مختص في ذلك، بأن الفكرة جيدة إلا أن التنفيذ لا يرقى لمستوى وجودة الرسالة والهدف من الإعلان، وهو تشجيع الاستثمار في مملكة البحرين، حيث تعرض المادة الإعلانية أشخاصاً تبدو على سماتهم بأنهم بحرينيون وتصور الكاميرا وجوههم دون إظهار عيونهم ويتحول فمهم بالتدرج من الوضع الذي هو عليه إلى ابتسامة. (١)
وكانت تلك المادة الإعلانية من ضمن حملة إعلامية ينفذها مجلس التنمية الاقتصادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر FDI وذلك تحت عنوان Bahrain, Business Friendly”.
وبغض النظر عن ملاحظات صاحبي في تنفيذ الفكرة-بعدما شاهدتها على الإنترنت- لتلك الدعاية والتي تحمل نسبية في النقد قد أتفق معه أو اختلف، إلا أن الشيء المهم هو وجود توجه رسمي لترويج صورة البحرين في الخارج كمحطة مميزة وفرصة للاستثمار।ونعتقد بأن تلك الخطوة مهمة جداً وفي محلها، خصوصاً إذا علمنا بأن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يقارب تريليون دولار أمريكي، في ٢٠٠٧م، وأدى إلى خلق فرص عمل تقارب ٣ ملايين فرصة عمل في مختلف الشركات في العالم.(٢) وتنامي الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد نتاجات المنافسة التي خلقتها التغيرات الاقتصادية التي أتت للأسباب التالية:
أولاً: تكوين تكتلات اقتصادية لا تجهد في البقاء ورص الصف فيما بينها فحسب، بل تسعى للتفوق والتميز والحصول على حصة كبيرة من السوق.
ثانياً: إبرام الكثير من الدول الصناعية منها والنامية عقوداً للدخول في المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية WTO والبنك الدولي WB ، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO مما يجعل من المنافسة تشتد بنفس الشروط على كل الدول الموقعة، وهو ما يستدعي جر النار لقرص كل دولة.
ثالثاً: البحث عن التنوع في الاقتصاد، فضلاً عن تنشيط الاقتصاد المحلي نتيجة الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يشكل عنصراً مهماً في توفير فرص العمل، وتنويع الدخل القومي، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد المحلي وتقويته. ونتيجة لتلك الأسباب وغيرها الكثير، يبدو أن خطوة مجلس التنمية الاقتصادية في محلها، بل ومطلوبة بشدة أيضاً. وعوداً إلى صاحبنا الأوروبي الذي قدم انطباعه كونه مختصاً في الدعاية والإعلام، لو كانت ملاحظته نسبية، إلا أنه من المهم مراعاة أدق التفاصيل والتي تقدم “صورة” عن “بلد” من خلال رسائل يتم عرضها على شاشات عالمية وفي دول تتميز بخبرة عريضة في مجال التسويق والدعاية والإعلان، ولا نود الدخول في تفاصيل ذلك الإعلان التلفزيوني، ولنبحث بدلاً عنه عن الصورة الأكبر المطلوبة. فالتسويق والترويج لبلد لا تشبه أي نوع آخر من الدعاية والإعلان لمنتج أو خدمة، فهو عمل يهدف لبناء وتقديم وتثبيت صورة في ذهن المتلقي، ومن هو المتلقي؟مستثمرون أفراد وشركات متعددة الجنسيات وبنوك وغيرها.
وهذا يتطلب الكثير من الإحتراف والدقة والتخطيط، وهو ما لا يجب أن يغيب على مجلس التنمية الاقتصادية، فالتسويق لأي بلد مهمة لا تضخ ميزانية على البلد فحسب من خلال الاستثمار فقط، بل تجعل من البلد على خطى الاعتماد على الذات والاستفادة من التكتلات الاقتصادية والدخول في المنظمات العالمية للاستفادة القصوى من كل مقوم للإعتماد على الذات في الاقتصاد، وليس فتح السوق المحلية لتكون “سبيل”، وهذا هو الفرق الذي يجعل دولاً كإيرلندا وأسبانيا من دول اعتيادية في الجسم الأوروبي إلى بلدين مهمين ويُشار لهما بالبنان، والأمر بالمثل في آسيا كسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلند।
وبعبارة أخرى هناك فرق بين من يروج لبضاعته بواجهة محل منسقة وخدمة زبون ودودة مع وجود يافطة جذابة، وبين محل وإن امتلك البضاعة الجيدة وبأسعار تنافسية، إلا أنها غير مرتبة، فضلاً عن يافطة ناقصة وغير جذابة للمارة والمشترين. ونعتقد بأن البحرين قادرة وبامتياز في التسويق المميز للاستثمار الأجنبي المباشر، فلديها المقومات الكافية لذلك، وهناك أمور تساعد في ترتيب المحل وعرض البضاعة بالطريقة المناسبة ليكون اسم البحرين قريناً بالفرص الاستثمارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط . فما هي تلك الأمور :أولاً: وجود توجه من أعلى السلطات في البلد، فهذا الأمر بمثابة البطارية التي تزود الخطوات والخطط بالطاقة للاستمرار والتقدم. وهذا الأمر متوفر من خلال توجه مجلس التنمية الاقتصادية والذي يترأسه ولي العهد.
ثانياً: صياغة وتقديم التشريعات والقوانين بما يحفز الاستثمار المحلي أولاً والأجنبي ثانياً، ولا يكون الأخير عل حساب الأول। وقد أفرد الموقع الذي يروج للبحرين في الخارج معلومات بهذا الخصوص। (٣)
ثالثاً: معرفة الهوية المقدمة باسم البلد، وهي مهمة جداً، فمن خلالها تُعرف الخطوط العامة للتواصل والدعاية والإعلان، فضلاً عن كونها تقدم ما يُسمّى “نقطة البيع الفريدة ” Unique Selling Proposition USP ، والتي يمكن الاعتماد عليها في صياغة سيناريوهات عدة للحملة الإعلانية والحديث عن مقومات الاستثمار في البحرين.
رابعاً: الاستعانة بالخبراء ممن قاموا بالتسويق لبلدان حققت نجاحاً، ليس على مستوى التسويق الإعلاني فقط، بل على مستوى نماء وتطوير الاستثمارات بنوعيهاالداخلي والخارجي।
خامساً: العمل على إنشاء شبكة منظمة بين الوزارات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار لتسهيله على المستويين الداخلي والخارجي، يتأتّى ذلك من خلال وجود نظام تعاوني مشترك وملموس بين تلك الجهات. وقد بادر ولي العهد في تذليل الصعاب بين مكونات الجسم الحكومي لتتبع منهجية ورؤية واحدة صاغها مجلس التنمية।
سادساً: توظيف الإعلام بشتى الطرق عبر طريقة ممنهجة ومدروسة، من الطابع البريدي إلى الصورة الموجودة والمتفاعلة في ذهن البحريني وغير البحريني على حد سواء। ومن المهم جداً أن تكون العقلية التفاعلية اليومية للمواطن البحريني هي صورة البحرين من خلال عمله اليومي وشعوره وسلوكه وفكره تجاه تلك الصورة، كما هو الحال على سبيل المثال مع تجربتي سنغافورة وإيرلندا، حيث يتحول التفاعل إلى سلوك يومي، لدرجة أن الشعب الإيرلندي من الشعوب المميزة في محاربة القرصنة والمحافظة على مستوى الملكية الفكرية في بلدانهم، لتصل إيرلندا إلى مصاف أفضل الدول في حقل الملكية الفكرية।وفي هذه النقطة السادسة، نبيّن أهمية الوسائل الإعلامية المختلفة، والتي قام مجلس التنمية الاقتصادية بالاستفادة منها، حيث باتت حملته الترويجية موجودة في مواقع متعددة حول العالم والتي تعتني بالاستثمار الأجنبي المباشر، منها على سبيل المثال لا الحصر http://www.fdiintelligence.
com/ ، فضلاً عن تواجد البحرين في المحافل الدولية، ومع ذلك يبقى هناك عنصر مفقود ضمن هذه المعادلة، و”تلفزيون البحرين” على رأس القائمة، وإذا أردنا إكمال الصورة المطلوبة لترويج البحرين، فلا بد من تغيير “اليافطة” الموضوعة “رسمياً” على واجهة مملكة البحرين، ويمثل التلفزيون الرسمي تلك اليافطة.حيث يتضح لمتابعوا القناة-إن وجدوا- فارقاً زمنياً كبيراً وبُعداً شاسعاً بين تلفزيون البحرين والناس من جهة، وبينه وبين الصورة الترويجية لمملكة البحرين في الخارج من جهة أخرى، خصوصاً عند الحديث عن ترويج لصورة مملكة البحرين في الخارج، ويُعتبر التلفزيون الرسمي أحد أهم القنوات التي سيشاهدها المستمثر لأنها تعكس الصورة التي تريد الدولة تقديمها لشعبها وللآخرين. وهنا بيت القصيد، لتكتمل حلقة الترويج التي يتبناها مجلس التنمية الاقتصادية، فالقارىء والمتابع يرى أن هناك “نشازاً” في اللحن العام المقدم عن صورة البحرين، بالرغم من وجود آلات العزف في محلها إلا أن هناك فرداً يعزف لوحده بعيداً عن الأوركسترا। وذلك هو “تلفزيون البحرين”، وفي مثل هذه الحال لا بد من طريقتين لحل هذه اللحن “النشاز”، وذلك بطريقتين، إما:
أولاً: بجعل الموسيقي “يلتزم” باللحن العام المقدم.
ثانياً: استبداله بآخر. وبعبارة أخرى، نرى أن التلفزيون الرسمي لا يسير على “الرتم” العام المقدم للترويج لصورة البحرين للعالم، ولا يكفي تزويد هيئة الإذاعة والتلفزيون بمعدات حديثة إن لم تمكن هناك استراتيجية واضحة وممنهجة للسير على نفس “اللحن” العام لصورة البحرين। والسيناريوهين المقدمين هنا هما:
أولا:ً شراكة فعلية بين هيئة الإذاعة والتلفزيون ومجلس التنمية الاقتصادية، للرقي بمستوى التلفزيون، مادةً وجودةً.
ثانياً: تدشين قناة خاصة لترويج البحرين بأكثر من لغة. والاستعانة بالخبرات والكوادر المحلية المبدعة لذلك. وفي غير تلك الحالتين، سيبقى الصوت النشاز موجوداً ومشوهاً للحن العام المقدم باسم البحرين. فهل نُبقي الموسيقي “النشاز” يلعب بآلته، ندربه من جديد أم نستبدله؟
http://ru.youtube.com/watch?v=YKZ0K1xRp20 (١)
(٢)
www.fdiintelligence.com* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي
-
النافذة المكسورة، المالكية نموذجاً
جعفر حمزة*
التجارية ٣٠ يوليو ٢٠٠٨معيّنت سلطات نيويورك في منتصف الثمانينيات مديراً جديداً للقطارات النفقية اسمه “دافيد غان” ، وذلك للإشراف على إعادة ترميم نظام القطارات النفقية بكلفة تصل إلى مليارات الدولارات। وكانت المشكلة الأهم هو غياب النظام داخل القطارات حيث السلب والعنف بالإضافة إلى سلوكيات أخرى كالخربشة داخل القطارات نفسها.
وقد طلب العديد من من مؤيدي القطارات النفقية من “غان” ألا يقلق بشأن “الخربشات”، وأن يركز على المسائل الأكبر للجريمة، ومصداقية القطارات النفقية، وبدا ذلك مثل نصيحة منطقية। فالقلق بشأن الخربشات في وقت كان فيه النظام بأكمله على وشك الإنهيار، بدا عديم الجدوى تماماً مثل تنظيف مقاعد باخرة “التايتانك” فيما كانت تتجه نحو الجبل الجليدي. لكنّ “غان” أصرّ وقال:( الخربشات ترمز إلى إنهيار النظام، حين تنظر إلى عملية إعادة بناء المنظمة، تحاول الفوز بالمعركة ضد الخربشة، ومن دون الفوز بهذه المعركة، لن تحدث كل الإصلاحات الإدارية والتغيرات المادية. كنّا على وشك إطلاق قطارات جديدة يبلغ سعر الواحدة منها عشرة ملايين دولار تقريباً، وما لم نفعل شيئاً لحمايتها، نعرف تماماً ما سيحصل. سوف تدوم يوماً واحداً ثم تمتلىء بالخربشات“.(١)
وبعد وضع “غان” لخطته استمر تنظيف الخربشات من ١٩٨٤ إلى ١٩٩٠، وتغير الوضع كلياً بعدما وضع خطة محكمة لم يتراجع عنها أبداً، وقد آتت أُكلها بعد حين، حيث انخفضت نسبة الجرائم والعنف في القطارات النفقية। وبقيت القطارات نظيفة تماماً، حيث داوم هو وفريقه على تنظيفها بعدما ينتهي المراهقون من القيام برسوماتهم التي تستمر لثلاثة أيام في بعض الأحيان، مما سبب لأولئك المراهقون إحباطاً من الاستمرار فيما يقومون به। وقد اعتمد “غان” في إصلاحه للأمور على نظرية “النافذة المكسورة”، وهي نظرية وبائية للجريمة والسلوك الاجتماعي السلبي، حيث تقول إنّ الجريمة معدية وأنها قد تبدأ بنافذة مكسورة، وتنتقل إلى مجتمع بأكمله. ونقطة التحول تبدأ بشيء مادي-وفي مثل هذه الحالة الخربشة- لأن القوة الدافعة للإنخراط في نوع معين من السلوك، لا تنبع من شخص معين وإنما من خاصية في البيئة. ويبدو أنّ لدينا الكثير من “النوافذ المكسورة” في جزيرتنا الصغيرة، وما لفت انتباهي مؤخراًًٍ هي إحدى النوافذ الكبيرة والمتمثلة في قضية “وقف مشروعات التنمية في المالكية” وربطها بعودة الأمن لإكمالها। حيث يتم الحديث عن الأمن وتحققه في العموم دون التطرق إلى “نقطة التحول” الرئيسية في تحقيق ذلك، وعوداً إلى نظرية “النافذة المكسورة” للتوضيح. حيث كانت تلك النظرية وليدة أفكارالاختصاصيين في علم الجريمة “جايمس ك।ويلسون” و”جورج كيلينغ”، إذ يقولان “إنّ الجريمة هي النتيجة المحتمة للفوضى. فإذا انكسرت النافذة ولم يتم إصلاحها، فسوف يستنتج الأشخاص الذين يمرّون قربها أنّه ما من أحد مهتم، وما من أحد مسؤول. بسرعة سوف تنكسر المزيد من النوافذ وتنتشر الفوضى من المبنى إلى الشارع الذي يقابله، مع إرسال رسالة أنّ كل شىء ممكن. فتلك الإشارات البسيطة من خربشات وغيرها بمثابة “دعوات” تتكاثر فيما بعد لتشكل نمطاً سلوكياً في المجتمع لا يمكن التخلص منه بسهولة. وبعبارة أخرى فإنّ ربط إكمال المشاريع التنموية بتحقق الأمن تشكل معادلة ناقصة لنزع الجوّ المشكّل لتلك العقلية التي تحرق وتجعل المجتمع في حالة اضطراب أمنية مستمرة. حيث من المهم معرفة الأسباب الجذرية ـفي حال وجودها- وتحمّل كل جهة مسؤليتها. ومن ناحية عملية الربط المكررة والمقدمة بخصوص إكمال المشروعات التنموية باستقرار الأوضاع في المالكية -مثالاً-، فإنها تشكل سابقة “غريبة” من نوعها، وذلك للأسباب التالية:أولاً: نتفق بأن الأمن ضروري للتنمية إلا أنّ الموقف المُعلن يقدّم “قوة” لا داعي لها لمن يُثير الاضطراب في المجتمع، ويمنحهم “ثقة” زائفة مما يشجعهم على الاستمرار على ما هم عليه। كحال ترك النافذة مكسورة دون إصلاحها، وبالتالي تنتشر النوافذ المكسورة، نتيجة عدم إصلاح النافذة الأولى। وقد اتضح ذلك من خلال بعض “العبارات” الاستفزازية للحكومة على بعض جدران القرية।
ثانياً: تحقيق الأمن لا يتم إلا ب”شراكة مجتمعية” بمعنى يجب تحقيق عنصرين أساسيين، هما الجهات الأمنية وأفراد المجتمع، وفي مثل هذه القضية نرى أن مسؤولية تحقيق الأمن بات محصوراً في جهة الأهالي دون الجهات الأمنية، وهي عملية ربط ناقصة وغير منصفة للمجتمع، كما أنها غير منصفة للجهات التي تحافظ على الأمن. وأتت مبادرة أهالي المالكية بزيارتهم لرئيس الأمن العام, حيث عبر أهالي القرية عن تأييدهم الكامل لتوجيهات جلالة الملك التي تدعو إلى مواصلة الاستمرار في مسيرة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والمحافظة على أمن الوطن وممتلكاته، وأنهم سيتعاونون مع أجهزة الدولة في سبيل تنفيذ هذه التوجيهات السامية. (٢) فهناك تحرّك إيجابي من طرف واحد، في حين يقتصر الدور الأمني على إنزال القوات الأمنية في القرية لوقف الحرق والتجمهر غير المرخص فقط।
ثالثاً: يمثل وقف المشروعات التنموية مساساً بهيبة الدولة، والتي تتمثل عبر ضرورة بسط سيطرتها بالقانون وتنفيذ خططها التنموية الشاملة دون التأثر بمجموعات لا تمثل توجهاً لأهالي هذه القرية أو لتلك المنطقة। وفي حال “الشرط” بتحقق الأمن وإيكال هذه المسألة على عاتق الأهالي وحدهم وانتظار النتيجة، فإنها تمثل تراجعاً عن المسؤليات فضلاً عن تأصيل لعرف جديد في عصر المؤسسات والتنمية والتطوير।
ولو اتبع “غان” هذا الأسلوب مع “خربشة القطارات” لضاعت الملايين من الدولارات، ولما استجاب أحد من راكبي القطارات لطلبه -إن فعل- في التصدي للمراهقين ممن يقومون بتلك الأفعال. لم يقم “غان” في معالجته لمشكلة القطارات النفقية بتناول السلوكيات الظاهرة كالعنف والسلب، بل ناول “نقطة التحول” التي تُوحي وتخلق ذلك الجو السلبي والذي يؤدي إلى كل تلك السلوكيات السلبية، وقام بمعالجتها। وعندما نريد أن تبقى “النافذة” غير مكسورة، فعلينا تهيئة الجو لذلك، من خلال مشروعات توجه طاقات الشباب وتحول فراغهم الذي يمثل شرارة في الانتماء إلى سلوكيات سلبية إلى طاقة إيجابية। فكثير من الأمور تحتاج لمعالجة فورية واستمرار في العلاج بدلاً من الانتظار، ولو تم الانتظار لمعالجة فيروس -مثلاً- لانتشر وتفاقم لدرجة لا يمكن وقفه والحد منه.
لذا نؤمن بضرورة مواصلة المشاريع التنموية وبوتيرة متسارعة أيضاً، لتقديم جو عملي يُبعد كل بذور المواقف السلبية، بالإضافة إلى أهمية حضور المشروع عيناً عند الأهالي، حيث يمكن وضع مجسم للمشروع في نادي القرية وتوزيع المخطط بالتفصيل وميزاته بطريقة جذابة لأهالي القرية والمناطق المجاورة لخلق جو بيئي جديد وواقعي يتلمسه الجميع بما فيهم “كاسروا النوافذ”، ليدركوا أهمية أن تبقى النوافذ سالمة بل ونظيفة أيضاً. لأنه في غير تلك الحالة سيبرد الجميع مع حلول الشتاء وبوجود “نافذة مكسورة”. وفي قبال تلك النقاط التي تجعل من الجهات “المسؤولة” بعيدة بطريقة أو بأخرى عن “مسؤلياتها” الأصيلة، فإنّ لنا وقفة أيضاً مع الطرف الثاني للمعادلة، وهو أفراد المجتمع بمؤسساته، حيث يشكل “السلوك الجمعي” عاملاً مؤثراً في صياغة التطوير والتقدم। فإذا أهمل كل فرد وضع القمامة في المكان المخصص، فليس هناك لوم على الحكومة إن وفرّت تلك الأماكن। والأمر بالمثل في هذه القضية، فعلى الأهالي القيام بالنصيحة في المرحلة الأولى ومن ثم التهميش والمحاصرة الاجتماعية، لتصل إلى مرحلة الضغط والدفع بهم لتغيير سلوكياتهم، وما زيارة أهالي المالكية إلى رئيس الأمن العام إلا إحدى الخطوات المطلوبة، ولكن قبلها يجب أن تكون المخاطبة مباشرة إلى أولئك الشباب، ولسنا في “زيمبابوي” بحيث لا يعرف الفرد صاحبه أو جاره في القرية، وتلك “المعرفة” تشكل مسؤلية لا ينبغي التواني فيها.
ومن الجميل أن تستمر زيارة المسؤلين إلى القرى والمدن، ليشعر الأهالي بقرب الحكومة منهم، وحبذا لو تُكثّف تلك الزيارات -خصوصاً في المناطق المضطربة-، لنزع السلوك الدافع لكسر بقية النوافذ في المجتمع. وعوداً إلى “النافذة المكسورة”، إذ لا يمكن ترك النافذة على حالها إن تم كسرها، حيث يجب إصلاحها من قبل مختص “الحكومة” وبرضا صاحب المنزل “الأهالي” والذي كسر النافذة إن كان من أهل البيت فيجب تأديبه، وإن كان من الخارج فيجب متابعته ومحاسبته. وقبل هذا وذاك ينبغي السؤال عن السبب في كسر النافذة ومعالجتها. وفي غير ذلك يبدو أن النوافذ ستبقى مكسورة إلى حين مجىء “غان” ليصلحها لتبقى بقية النوافذ سالمة.
(١
The Tipping Points, by Malcolm Gladwell
نصيحتي المتواضعة هو قراءة هذا الكتاب للطرفين، الحكومة وممثلي الأهالي. توجد منه نسخة عربية أيضاً.
٢)
الوقت ٢٥ يوليو ٢٠٠٨م* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي
-
قطعة الجبن المخرومة
جعفر حمزة*
التجارية ٢٣ يوليو ٢٠٠٨م
http://www।altijaria.net/“ألا توجد عندكم شواطىء في هذا البلد؟ أين يستجم الناس وأين يروحون عن أنفسهم؟، هل نحن في جزيرة حقاً؟”.
رفع طرفه منتظراً الإجابة من ابن هذه “الجزيرة”، وكان “تعجبّه” في محله، ألا يتعجب المرء عندما لا يرى الإهرامات في مصر، أو تلك المناظر الطبيعية الجميلة في لبنان، أو اختفاء النخيل في العراق أو غياب الطواحين الهوائية في هولندا؟ فكان سؤاله في محله، فماذا كانت الإجابة؟
لا أخفيك سراً، وما سأقوله لك ليس من الأسرار العسكرية المحظورة أو من تلك التي يُتهم من يقوم بتسريبها بالخيانة العظمى، أو على الأقل ليس من يفشيها سيكون ممن يُشك في “وطنيته”। فكانت الإجابة “مطامع شخصية وسوء تخطيط، هما اللذان أديا إلى وجود جزيرة بلا سواحل”.ولعلم القارىء ما قلته سابقاً كان جواباً مخففاً وغير علمي بعض الشيء، إذ يلزم أن تكون شواطىء للجزيرة لا سواحل، حيث أن الأخيرة تكون أماكن مُعدة سابقاً لتكون واجهة مطلة على البحر، في حين تكون الشواطىء لسان يطل على البحر غني بالأحياء البحرية وجميع صورالمكونات الأساسية للشاطىء الطبيعي। وبعبارة أخرى فالسواحل صناعية والشواطىء طبيعية।
وعوداً على سؤال الأخ العربي القادم من الغرب، فلم تكن ردة فعله سوى هز رأسه وابتسامة شممت منها رائحة الضحك على واقعنا. ففي ظل “طفرة عمرانية متسارعة” في المملكة، وتوسع استثماري مشهود، وقفزات في الانفتاح الاقتصادي، و”تنمية” حجرية أفضت إلى “تناطح” العمارات والبنايات، حتى تم الاستغراق في الحجر ونسيان البشر، كما شبهها أحد المسؤلين الإماراتيين في خضم حديثه عن “الإنغماس” في التعمير والتطوير المادي، ونسيان التنمية البشرية. ففي ظل كل ذلك، هل من المستحسن طرح ذلك السؤال؟ وهل يشكل فارقاً مهماً يستحق الحديث عنه؟ ولم كل هذه الجلبة من البعض في رفعها لعناوين الحفاظ على البيئة و..إلخ من الكلام؟
إن رفع الحَجَر تأتي عندما يُرفع من قدر البشر، ولنأخذ الأمور ببساطتها في المجتمع البشري، فعبر ذلك يمكن الحديث دون “أقنعة” أو “مسبقات فكرية” تفرض على الكاتب كما على القارىء بعض المسلمّات التي لا فائدة من الحديث عنها।
تجهد الدول في العقدين الأخيرين، بتأسيس مبدأ الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والبشرية ليكونا هما رأس المال الأساس في ظل تصاعد محموم في المنافسة، فضلاً عن تخطيط للمستقبل بلحاظ العمر الافتراضي القصير لموارد الطاقة التقليدية. وبدلاً من المقارنة والتقييم مع دول أخرى وإن كان ذلك أمراً منطقياً ومرغوباً، فإننا نفضل الحديث عن البحرين بمقوماتها وحالها وما هي الصور الناقصة فيها، والتي جعل من ثيمة “جزيرة بلا سواحل” كمنقصة حين الوصف. وإليكم الثقوب التالية في جزيرتنا، والتي جعلت الكثير من الملفات كجبنة سويسرية تلمؤه الكثير من الثقوب، ولكم الحكم:الثقب الأول: مع زيادة عدد السكان في هذه الجزيرة، والذي قارب المليون وزيادة، والتي اكتشفناها مؤخراً من لدن إحدى الأجهزة الحكومية، وكأنها تغني خارج السرب، دون علم بقية الوزارات والهيئات الحكومية بالعدد. جعلت تلك الزيادة الخطط التنموية في “حيص بيص” كما يقولون، وهو ما يستلزم وضع خطط تنموية جديدة تراعي العدد الحقيقي الجديد من مشاريع الإسكان والخدمات وتوابعهما.
ويدفعنا هذا الثقب للسؤال عن وجود مخطط للمملكة، فهل يوجد؟
الثقب الثاني: مع زيادة عدد السكان، تكون النتيجة الطبيعية زيادة عدد المساحات الخاصة لهذه الأنفاس البشرية، والملاحظ هو زيادة في عدد المساحات، والتي أتت على البر والبحر بطريقة “مدمرة” بكل ما للكلمة من معنى، حيث يتم استخدام أسلوب قاسٍ للطمر والدفان في عرض البحر، بالرغم من وجود أساليب بيئية سليمة للقيام بذلك. ويبقى السؤال لمن هذه المساحات المطمورة بحراً و”المأخوذة” براً؟
ويدفعنا هذا الثقب للسؤال عن وجود مخطط للمملكة، فهل يوجد؟الثقب الثالث: هَوَس لم يُشهد له مثيل في “الاستيلاء” على الأراضي والتي باتت ذهباً، ولا ضير في أن تكون تلك الأرض “وقفاً” أو “قبراً”، فالأرض تبقى أرضاً، ويمكن تحويلها إلى استثمار مربح। وتبعات ذلك عديدة تنعكس اجتماعياً ودينياً وقانوناً، وقبل هذا وذاك، تنعكس بصورة إنسانية.
ويدفعنا هذا الثقب للسؤال عن وجود مخطط للمملكة، فهل يوجد؟الثقب الرابع: مصادرة حق عام من الناس ووضعها ضمن “أملاك خاصة” لهذا المتنفذ أو ذاك। فكم هي الشواطىء التي تمت مصادرتها، وهي حق مكفول عقلاً ودستوراً وقانوناً وعرفاً للناس؟ لو كان الأمر بيد البعض لباع الهواء على الناس.
بل وصل الأمر لبعضهم بتحويل المياه الإقليمية إلى “أملاك خاصة” (1)
ويدفعنا هذا الثقب للسؤال عن وجود مخطط للمملكة، فهل يوجد؟الثقب الخامس: وضع البيض “الفاسد” في سلة واحدة، لا يُزكم الأنوف بل يُمرضها. فلم بناء المصانع التي لا تراعي الشروط البيئية قرب سكن الناس في قراهم ومدنهم؟ فإن كانت المصانع قد بُنيت سابقاً، فيمكن حلها عبر تحسين الشروط البيئية ومراعاتها، وإن كانت حديثة، فلا عذر لها.
ويدفعنا هذا الثقب للسؤال عن وجود مخطط للمملكة، فهل يوجد؟وبعد كل تلك الثقوب، يبدو أن الجواب في سؤالنا المكرر بعد كل ثقب، هو “نعم، يوجد مخطط للمملكة على مدى الثلاثين السنة القادمة”. حمداً لله يوجد مخطط، وهل سيحل تلك الإشكالات؟ “تفاءلوا بالخير تجدوه”. ولنرى…
أولاً: بعض التصنيفات من سواحل وأراض لم تدرج ضمن المخطط، بالإضافة إلى بعض المناطق الصناعية والمشاريع الإسكانية وبعض المشاريع الخاصة التي لم تدرج أيضاً في المخطط।
ثانياً: لم يستطع المخطط أن يعالج موضوع إيجاد مساحات صناعية جديدة بعيدة عن المناطق السكنية، ولايزال هذا المخطط يكرس مبدأ أن تبقى المناطق السكنية بالقرب من المناطق الصناعية والعكس، ناهيك عن التأثيرات البيئية الأخرى. هذا ما ذكره الناشط البيئي غازي المرباطي.
ثالثاً: لم يكن لمؤسسات المجتمع المدني أية بصمة أو مشاركة في هذا المخطط كما يحدث في حال وضع المخططات الاستراتيجية في الدول، إذ يتم أخذ آراء الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني في الجوانب الرئيسية للمخطط حيث له علاقة بالجوانب التنموية في البلد।
هذا ما أتى على لسان النائب جواد فيروز. ويبدو أن عليّ التوقف، وإلا فإننا سننتهي بكتاب لن يسر الكثيرين، ونعود لبساطة الأسئلة فهي أوقع وأقوى. هل مع ما ذكر يمكننا الحديث عن تخطيط أو تخبيط؟ ويمكننا الرد عبر تعليق للباحث الكويتي في علوم البيئة وعضو هيئة التدريس في الجامعة العربية المفتوحة مبارك العجمي ” لا توجد استراتيجية بيئية في البحرين”. والذي أردفه بسؤال “جزيرة عدد سكانها في تزايد. لا بحر فيها ولا أشجار. فأين يستجم المواطنون؟ لابد أن يكون هناك متنفّس للناس”.
بل ويزيد الأمر سوءً عندما ندرك أن هذا الجشع يعود بظواهر بيئية جديدة عنّا، وآخرها ظاهرة الغبار، حيث يذكر الناشط البيئي مبارك العجمي أن الغبارالذي مرت فيه البحرين كان بسبب الردم البحري. (٢)
وردنا هو عندما تتحوّل الأرض التي نعيش عليها أو بالقرب منها إلى قطعة جبن سويسرية، مقطعة حتى النخاع، فإن كل ما ذكر ليس بوارد البحث، والتبعات البيئية والاقتصادية والصحية والسكانية والاجتماعية ستتزايد، لتصل إلى أن “ينفر” الفأر من الاقتراب من هذه الجبنة، وعليكم بالعافية.(1) ما ذكره رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النيابي جواد فيروز. الوسط 18 يوليو 2008م.
(٢) الوقت، ١٩ يوليو ٢٠٠٨م.
*مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرف
-
على الطاير
جعفر حمزة*التجارية ١٦ يوليو ٢٠٠٨
لم يك الوقت مُعيناً لي في “التقاط” ما كان مكتوباً في الإعلان، بالرغم من تكراره لأكثر من مرة في نفس الطريق، لا لسرعة كنتُ أقود بها سيارتي، بل نتيجة كتابة “مقال” في إعلان خاص بالطرق، وذلك أحد الأسباب التي تقع فيها بعض الجهات المُعلنة، والتي تفتقد لألف باء الإعلان في الطرق، والنتيجة هو وضع المال والرسالة المراد تقديمها للجمهور بطريقة غير احترافية، بحيث “يتبخّر” المال و”تضيع” الرسالة، ولا “من شاف ولا من دري” كما يقال.
ومن الجدير بالذكر أن إعلانات الطرق تحتل المرتبة الرابعة بعد كل من إعلانات الصحف والتلفزيون والمجلات، وتأتي إعلانات الراديو والسينما في المرتبة الخامسة في سلّم استخدام وسائل الإعلان للترويج والإعلان بصورة عامة في الوطن العربي وبالخصوص في منطقة الخليج.
وهذا يستدعي التمعّن قليلاً والتفكير في الوسائل العملية والفعالة في الاستفادة المثلى من هذه الوسيلة في الإعلان، وهناك ميزة فريدة في البحرين تجعلها مختلفة عن بقية دول الخليج في استخدام إعلانات الطرق، وهي صغر مساحتها، مما يجعل من إعلانات الطرق وتوزيعها أمراً سهلاً وممكناً، وخصوصاً في تلك الأماكن التي تشهد حركة سير مكثفة ومتواصلة. ونتيجة لذلك أصبحت أسعار إعلانات الطرق مرتفعة بناءً على المكان والمدة، وهذا ما جعل من ابتكار وسائل أخرى من حيث المكان والطريقة مشهوداً في بعض المناطق بالمملكة. حيث يتم تأجير مساحات أسقف المنازل والبنايات للإعلان، وهو ما يعكس تزايد الطلب على هذه النوعية من الإعلان.
ونتيجة لذلك التزايد والكثافة في إعلانات الطرق، ينبغي أن تكون الإعلانات الناجحة محققة للكثير من الشروط لترتقي إلى مستوى التميّز والملاحظة في خضم “تخمة” إعلانات الطرق والتي تروج للمنتجات والخدمات والرسائل الأخرى من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وغيرها.
فما السبيل لجعل الرسائل التي يريد أن يوجهها القطاع العام مميزة وترقى لمستوى الإهتمام وشد الإنتباه، وذلك في ظل الكثافة الإعلانية على الطرقات؟ فضلاً عن إيصال رسالتها بطريقة مبتكرة وواضحة بعيداً عن الأفكار المكررة، والتي لا تشد انتباه الفئة المستهدفة من الإعلان، وغالباً ما تكون الجمهور العام من المواطنين.ومن الجيد أن تخرج الوزارات الحكومية والقطاع العام بصورة إجمالية في خططهم الإعلانية عبر وسائل متعددة، ومنها إعلانات الطرق، إلا أن الصورة غير مكتملة، بل هناك نقص مركّب فيها، وهو مدار حديثنا الذي نريد أن نسلط الضوء فيه على نمط الإعلانات من القطاع العام في الطرقات، وما أوردناه في بداية الحديث، وهو الوقوع في مطب الإسهاب للتعبير عن الرسالة أو الخدمة هي إحدى السلبيات التي نصبح ونمسي عليها عبر إعلانات معظم الوزارات إن لم تكن كلها، فما هي القطعة المفقودة -والحقيقة هي أكثر من قطعة- في الصورة الإعلانية التي تقدمها الوزارات أو القطاع العام بصورة إجمالية؟
القطعة الأولى: الإسهاب في كتابة محتوى الإعلان وطوله، حيث من المفترض أن يكون المحتوى “Content” مختصراً وواضحاً ومباشراً، فوقت قراءة الإعلان على الطرقات تُعد بالثوان . فما يُكتب في الإعلان المطبوع “الصحف والمجلات” لا يمكن وضعه كما هو في إعلان الطرق، وخصوصاً إذا كان المحتوى يحتاج وقتاً للقراءة.
القطعة الثانية: الاستهلاك في استعمال الأفكار المكررة والتي تدور حول فكرة واحدة وتطبيق واحد، فضلاً عن غياب الأفكار الجديدة في عرض الرسالة المقدمة، سواءً كانت خدمة أو معلومة. وهذا ما يجعل الإعلان غير ملفتاً ومؤثراً، بالرغم من أهمية المحتوى الذي يتضمنه. ولكي لا يكون الكلام في الهواء، فإننا نسرد مثالين عن ذلك، هما: إعلانات هيئة الكهرباء والماء والخاصة بحملة الترشيد والتي تذكرنا بنمط الإعلانات في السبيعنيات، وإعلانات وزارة التنمية الاجتماعية في “صيفنا بديرتنا” حيث أن أقل ما يقال في شأن تلك الإعلانات أن “لا جديد تحت الشمس”.
القطعة الثالثة: بالإضافة إلى المحتوى والفكرة Content and Idea، هناك طريقة العرض،فحال الإعلان كحال المنتج، فإذا تم تقديم المنتج في علبة ملائمة، فإنها تشد الزبون لشراءه، فمهما كانت أهمية المنتج، لن يحظ بالاهتمام ولن يشد الانتباه ما دامت طريقة تغليفه وتقديمه غير مشجعة، وهو ما يسمى ب”Packaging”. والمتمثل في اختيار الألوان، الحجم والشكل المقدم في الإعلان. فضلاً عن حجم ونوع الخط وكمية المحتوى في المساحة المعروضة. والملفت للنظر هو تكرار مثل هذه الأخطاء بطريقة أصبحت “عرفاً” متداولاً في الكثير من الجهات الحكومية، منها على سبيل المثال لا الحصر، الإعلانات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء وإعلانات الحكومة الإلكترونية، حيث يلاحظ في الأخيرة زيادة حجم المحتوى المقدم حيث يتناسب مع الإعلانات المطبوعة أكثر من إعلانات الطرق.
القطعة الرابعة: من المهم بعد استكمال تلك القطع وضعها في مكان ووقت مناسبين، وذلك بمعنى اختيار المكان المناسب لعرض الإعلان والمدة الزمنية التي ستكون موجودة، وما يقرر ذلك هو معرفة الفئة المستهدفة “the target” من الإعلان.
القطعة الخامسة: ليكون صوتك مسموعاً بين الجمهور، فهناك طريقتين، إما أن يكون صوتك أرفع من أصوات المحيطين بك وإما أن تذهب للمنصة وتتكلم في مكبر الصوت، والأمر سيّان في ظل “تخمة” من الإعلان في الطرقات، حيث باتت طرق الإعلان فيه متعدددة، فمن المنصات ذات الحجم الكبير إلى المنصات ذات الحجمين والمتوسط والصغير”Megacom, lamppost,Mupi, Unipole”.
ومن المهم ابتكار وسائل تقدم الفكرة والرسالة للجمهور بطريقة مميزة، فلا التزام مشروط بحجم وشكل الإعلان الموضوع في الطرقات. واعتماداً على نوع الرسالة المقدمة تتم صياغة الطريقة التي يتم تقديمها للجمهور المستهدف.
وهناك الكثير من القطع الأخرى، إلا أننا قدمنا تلك القطع التي تمثل أولوية مهمة في الاستفادة المثلى من وسيلة إعلانية، وبصورة فعالة، عوضاً عن وجودها كإحدى وسائل الحملة الإعلانية لهذه الوزارة أو لتلك الجهة، بعيداً عن فهم أساسيات التأثير والخروج بأكبر فائدة ممكنة من تلك الوسيلة،
ولا نتوقع أن تتغير العقلية الكلاسيكية في الإعلان في القطاع العام بين عشية وضحاها، إلا أننا نتوقع -على الأقل- وجود نية حقيقية في التغيير بما يتناسب مع المستوى المتغير في الخطاب الإعلاني، وذلك عبر الاستفادة من المختصين والشركات ذات الخبرة والمبدعة في هذا المجال. ونقولها بصراحة، أنه لا يكفي أن نقول أن هذه الوزارة أو تلك الجهة قامت بحملة إعلانية وكلفتهم مبلغاً من ميزانيتهم دون الإطمئنان إلى “احترافية” تقديم تلك الحملة، فليست الحملة الإعلانية “موضة” أو “براءة ذمة”
بل هي مسؤولية تحتاج لخطة ومختصين وميزانية ودراسة، وليست هي عملية “على الطاير” ليُقال بأن هذه الوزارة أو تلك الجهة قد قامت بحملة إعلانية، وللإنصاف ومعرفة فعالية الحملة، ينبغي القيام بدراسة ومسح لمعرفة مدى تأثير هذه الحملة ولا يمكن الاكتفاء بتدشين الحملة فقط.
فهل تستمر حملات إعلانات الطرق “على الطاير”؟*مختص في ثقافة لصورة والاقتصاد المعرفي.
-
الدوا قبل الفلعة
جعفر حمزة*التجارية ٩ يوليو ٢٠٠٨
أطلقها “مزحة” ما زالت ترنّ في أذن كل باحث وقارىء لواقع التغيرات في هذا العالم العربي، تلك المزحة التي صاغها مسلسل “درب الزلق” على لسان “حسينوه” عندما قال مشيراً إلى ضرورة الابتكار والاختراع بما يتناسب البيئة التي نعيشها، حيث قال “ليش ما نخترع راديو يشتغل على غبار؟”قد تكون تلك اللفتة “مزحة” أو “إشارة” سمّها ما شئت، إلا أنها تعكس تطلعاً لواقع عربي ما زال متأخراً في إكمال أحجية التطور والتقدم والأخذ بزمام التقدم، بالرغم من توفر ألف باء ذلك التطور، سواء من ناحية الموارد الطبيعية أو الموارد البشرية التي تحتاج لصقل ووضعها في المكان الصحيح.
ونعتقد بأن الخروج من على كرسي “المشاهد” إلى دور “اللاعب” بات أمراً حتمياً للدول العربية، وبالخصوص تلك التي تملك الموارد الطبيعية والبشرية المؤهلة، ومنها دول الخليج العربية। ويكفي أن نقرأ تجارب من دول مختلفة، والتي يُطلق عليها بالدول النامية، والتي تحولّت من “مستهلك” إلى “مصدّر” للكثير من المنتجات، بل وباتت صاحبة علامات تجارية عالمية مشهورة، ومن تلكم الدول تايوان وكوريا الجنوبية.ولا يكفي أن تقوم الدول بما يسمى ب”تحرير الأسواق” فحسب. لأن الأسواق الحرة بذاتها لا تؤدي تلقائياً إلى النمو الاقتصادي. وعلى المجتمعات في الاقتصاد القائم على المعرفة أن تخلق ميزتها النسبية. فلا تمنحها إياها أمنّا الطبيعة كمناجم للذهب أو آبار للبترول أو ظروف زراعية مواتية. إنّ كل منطقة في العالم عليها أن تطور مصادرها من المزايا النسبية التي من صنع الإنسان. (١)
وقبل أن نفكّر في راديو “الغبار” علينا أن نعرف راديو الطاقة الشمسية أو أقلها راديو البطارية، وبعبارة أخرى علينا التفكير في ثلاث دوائر رئيسية تمثل الخطوط العامة للانتقال من الاقتصاد المعتمد على الموارد الطبيعية إلى الاقتصاد المعرفي، والذي يحول النحاس ذهباً، وعلينا ألا نبالغ كثيراً عند الحديث عن الاقتصاد المعرفي، إلا أن معطياته موجودة في مجتمعاتنا الخليجية، ومنها مملكة البحرين، حيث تتميز بنسبة تعليم عالية، وبيئة استثمارية -قد لا تكون بالصورة المرجوة- إلا أن لها القابلية لتتحول إلى “سنغافورة” الخليج أو على الأقل بمثل مرتبة “تايوان” والتي تُعد من نماذج الدول النامية التي انتقلت إلى مرحلة “التصنيع” و”التصدير” لتلعب دوراً على خارطة الاقتصاد العالمي। ويمكننا إلى جانب “ترويج” المساحات الغمورة في البحر كمشاريع عقارية، تخصيص أرض لمشروعات البحث والتطوير والبحث!
وعوداً إلى الدوائر الثلاث، والمتمثلة في التالي:
الدائرة الأولى: سد النقص الحاصل في ألف باء الاستثمار، وعدم “وضع البيض في سلة واحدة” كما يُقال، وما ذكره وزير الصناعة والتجارة من “فتح الباب على مصراعيه” لصناعة الإسمنت، هي خطوة متأخرة، وكأن “البيض” كان محصوراً في سلة واحدة وواحدة فقط، وما أشار إليه ولي العهد من ضرورة فتح المجال للبدء بصناعات محلية والاعتماد على الذات، هو البداية الحقيقية للاستثمار الحقيقي. وعلينا في ظل الاستفادة من تجربة “أزمة الإسمنت” الأخيرة تجهيز “الدوا قبل الفلعة” كما يقال في المثل المحلي، والذي يدل على ضرورة الاستعداد للأمر قبل وقوعه. فهل ننتظر أزمة أخرى لفتح “الباب على مصراعيه” من جديد؟ ذلك هو الدرس الأول، والذي على الحكومة الاستفادة منه ووضع خطة للاعتماد على الذات بلحاظ تسارع وتيرة الاستثمار في البحرين।إذ لا يكفي دعوة الآخرين لتناول الطعام في مطعم “فاخر” وينقصه “الماء” أو”الكهرباء”। ولا يكفي “البقاء حياً” إن أردت التفوق في عالمك، عليك أن تتبع نهج “البقاء قوياً”
الدائرة الثانية: تشجيع التطوير والبحث Development and Research، وذلك من خلال وضع خطة وطنية تتجاوز التقارير السنوية والتي تقوم بها هذه الجهة أو تلك، لتصل إلى مرحلة “خارطة الطريق” الخاصة بالتطوير والبحث على أكثر من صعيد، وتتحول إلى نمط سلوكي وتفكير منظم تُصبح وتُمسي عليه الأجسام الثلاثة التالية، والتي تمثل مصدر الهواء لتنفس أي حكومة هواءً نقياً والذي يمدها بالنشاط والتقدم في سباق المعرفة، وتلك الأجسام هي:
أولاً: الدوائر الحكومية، والتي تحتاج إلى تغيير في سلوك العمل والتي باتت تمتلك تلك الصورة النمطية السلبية عن العمل في تلك الدوائر। ويمكن “حقن” هذا الجسم بدوائر “المعرفة”، والتي تتمثل في تشجيع التطوير والبحث عن طريق إنشاء دائرة قائمة بذاتها تتمتع بالاستقلالية عن كل قسم، وتكون تحت الوزير مباشرة، وتتمتع بصلاحيات التغيير والاستشارة في سن القوانين ومشاركتها مع الوزير مباشرة.
ثانياً: القطاع الخاص، وهو متقدم نسبياً وفي بعضه بأشواط عن الدوائر الحكومية، وذلك في ظل منافسة محمومة -نوعاً ما- فضلاً عن افتتاح “لا خيار غيره” للتطور والتقدم في ظل “سباق” لا ينتظر أحداً. ومن الضروري “حقن” هذا الجسم بالبحث والتطوير وخصوصاً تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SME، والتي تمثل “الملكية الفكرية” IP لها “الورقة الرابحة” للبقاء بتميّز في وضع متقدم في ذلك السباق.
ثالثاً: الجامعات والمعاهد والمدارس، وهي تمثل “الخلايا الأولى” لصنع “المعرفة” وتصديرها للجسمين الأولين (القطاعين العام والخاص)। وبالرغم من وجود الكوادر “المميزة” إلا أن “عسلها” يتم سكبه بعد أن يتم تصنيعه على عتبات “التحجيم” و”الاستغلال” و”التهميش”. ونعتقد بأن من يملك تلك الإرادة في “الاحتفاظ” بالعسل والاستفادة منه، بدلاً من سكبه هو ولي العهد، حيث يلزمنا مبادرة مشجعة لتطوير الأبحاث والاستفادة منها، بدلاً من أن تتحول إلى “الأرشفة” التي إن تم الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة، لرأينا “بحرين غير”.
ونؤمن بأن تلك الأجسام الثلاثة إن تم حقنها بالتطوير والبحث، ستستاهم في تغيير عقلية المجتمع وتجعله يفكر بصورة عملية بالدعم والتطوير للمجتمع، وستكون تلك العقلية كفيلة بضمان وضع المملكة بعيداً-بصورة ملحوظة- عن محيط الأزمات الاقتصادية-، وأزمة الإسمنت كانت في مرحلة “سلم”، وما الذي سيحصل إن كان الوضع غير ذلك؟ وبتلك العقلية ستتحول المملكة إلى دائرة الإنتاج، فقطار المعرفة لا ينتظر أحداً، والاعتماد على الموارد الطبيعية أو نهج السوق المفتوحة لا يكفي، بل تعتبر مخاطرة ستستهلك الموارد الطبيعية وتُذهب بنهج السوق المفتوحة. حينها لا يمكن التفكير براديو يعمل على “غبار” ولا طاقة شمسية ولا حتى بطارية، وذلك إن لم نفكر بتجهيز “الدوا قبل الفلعة”.
* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.
(١) النظام الاقتصادي العالمي الجديد. ليستر ثور
-
عدوى
جعفر حمزة*
التجارية ٢ يوليو ٢٠٠٨
ما إنْ قدمها له، حتى اعتذر وقال إنّ هذه “العلكة” تحتوي على مواد لا يصح أكلها। وعند سؤاله عن مصدر تلك المعلومة حتى بدت عليه ملامح الثقة والاطمئنان “لقد استلمت رسالة عبر بريدي الإلكتروني تؤيد ما قلتُه بالحقائق والصور”، وأضاف “سأبعثها لكم في أقرب وقت”، وما كان من الآخرين سوى الانتظار.
لقد أصبحت المعلومات المتعلقة بالمنتجات أوالخدمات من ضمن “طيف واسع” من الكم الهائل الذي يستقبله الأفراد كمعلومات يومية بل وفي كل بضع ساعات، لتشكل “توجهاً” غير واضح الملامح في العلاقة ما بين “Consumer” و”Brand”। إنّ التغير المتسارع في وسائل الاتصال الإلكتروني الحديثة خصوصاً تلك المتعلقة بعالم الإنترنت والفضاء الافتراضي للمعلومات، جعل من خيارات التسويق والترويج غير محدودة، حتى أصبح التوسع الشبكي في الإنترنت بمثابة الفرصة في كل ثانية لاستغلال هذه المساحة أو تلك لظهور هذه الماركة أو لحجز تلك الماركة لخدمات معينة، وبالتالي يصبح ظهور الماركات متناسباً وبصورة طردية مع حجم التوسع الحاصل في نوع الخدمات المستحدثة والحاضرة في عالم الاتصال الإنترنتي. ومع كل تلك المساحات والفضاءات المفتوحة والواسعة في الإنترنت لتقديم الماركات منتجاتها وخدماتها، إلا أنّ ذلك لا يبدو كافياً। حيث انتقلت حركة الماركة من الدائرة “الخاصة” بها إلى المساحات الفردية لمستخدمي الإنترنت حول العالم، والمتمثلة في البريد الإلكتروني والعديد من تلك الخدمات التي نحب أن نطلق عليها “الأحياء الإلكترونية” “Electronics Neighborhood” والتي تحتفظ بخصوصية الأفراد في أحيائهم الخاصة مثل “FaceBook” و”My Space” وغيرهما.
———————————————————— —————————— ——–
Definition
Marketing phenomenon that facilitates and encourages people to pass along a marketing message।
Information
Viral marketing depends on a high pass-along rate from person to person. If a large percentage of recipients forward something to a large number of friends, the overall growth snowballs very quickly. If the pass-along numbers get too low, the overall growth quickly fizzles.
At the height of B2C it seemed as if every startup had a viral component to its strategy, or at least claimed to have one। However, relatively few marketing viruses achieve success on a scale similar to Hotmail, widely cited as the first example of viral marketing.
——————————
—————————— —————————— ——– ولتوضيح سبب الإنتقال التي تفضله الكثير من الماركات من “مملكتها” الخاصة إلى “دار” كل مشترك، لا بد من معرفة أن التسويق عادة يتم في دائرتين رئيستين هما أن تحتفظ “الماركة” بمكانها الخاص بها، ويذهب لها الأفراد، والدائرة الثانية هي أن تنزل “الماركة” بين الأفراد عبر الترويج لها ومن ثم تفاعلهم معها। ونتيجة للطفرة الإلكترونية الحاصلة في مجال الاتصال، تشكلت دائرة ثالثة، وهي أن يقوم الأفراد بترويج “الماركة” فيما بينهم، ولا يحتاج الأفراد في ذلك إلى فتح “فرع” للماركة الأم। حيث يكفيهم “تناقل” المعلومات الخاصة بهاوانتقال تلك المعلومات باسم الأفراد إلى أصدقائهم ومعارفهم لتتسع دائرة “معرفة الماركة” وبالتالي تتحول “الماركة” إلى “حضور” فاعل في حياة الأفراد عبر تواجدها في دائرة خصوصياتهم الإلكترونية. وما يُساعد في عملية “الإنتشار” هي تلك التي دفعت صاحبنا للامتناع عن تناول “العلكة” والذي بدوره سينقل مثل ذلك “المنع” إلى الآخرين، وهكذا يتشعب الامتناع عن تناول “العلكة” وتتسع دائرتها لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد। وهذا بمثابة “العدوى” التي تصيب الإنسان نتيجة “فيروس”।
فكما ينتقل “الفيروس” بسرعة خاطفة، فإن الموقف تجاه منتج أو خدمة معينة ينتقل بطريقة غير اعتيادية أو متعارف عليها من ضمن وسائل الإعلان المتداولة، لذا يُسمّى هذا النوع من التسويق بالتسويق الفيروسي “Viral Marketing وهو أحد أنواع التسويق الإلكتروني الحديث والتي تحظى باهتمام من قبل الماركات العالمية التي تبحث عن علاقة خاصة مع الأفراد، لتتعدّي مجرد بيع المنتج أو الخدمة لتصل إلى مرحلة “التعلّق” بالماركة إلى أبعد الحدود। ومن الأمثلة الناجحة والتي رسمت لها أثراً يُضرب بها المثل تجربة “ Burger King” حيث تم الترويج لشطيريتي دجاج بطعمين مختلفين، وذلك عبر “مبارزة” بين دجاجتين تمثل كل منهما شطيرة مختلفة। ووصل الأمر إلى درجة حضور الآلاف في مباراة على الهواء بين الدجاجتين ليؤدى إحدى الدجاجتين. (١)
وفي قبال هذ النوع من التسويق الذي يحظى بأهمية في عالم التسويق الإلكتروني، بل يمتد ليضرب بجذوره كل المساحات الإلكترونية المختلفة للمجتمعات التي يحتضنها الإنترنت، هناك نسخة مطابقة له في الواقع وهوما يُسمّى ب”Word of Mouth ” وهو التسويق المعتمد على تناقل المعلومة الخاصة بالمنتج أو الخدمة بناءً على التجربة الشخصية وانتشار الخبر ليكون بمثابة “حملة إعلانية” غير مُعلنة لهذه الماركة أو تلك. وتحوي تلك العدويين -مثنى عدوى- قوة كبيرة في اتجاهين، فكما يمكن أن تأخذ “ماركة” إلى موقع مؤثر وبصورة إيجابية من خلال تلك العدوى، إلا أن هذا النوع من التسويق يمكن أن يُستخدم “ضد” الماركة أيضاً। ففي مجال الإعلان المطبوع أو المرئى أو المسموع أو الإعلان الخارجي “OOH” لا يمكن وضع إعلان ضد ماركة أخرى وبصورة واضحة، فهناك قوانين وتشريعات لا يمكن تعديها، وإلا تحولت فضاءات الإعلان إلى معركة شرسة. إلا أن مجال التسويق الفيروسي Viral marketing هي بمثابة “الهايد بارك”، فلا توجد قوانين تمنع تناقل معومات-حتى لو كانت مغلوطة- وبالتالي يجب أن تكون أدوات “المواجهة” مُعدة للثبات في خضم تلك العدوى.
إنّ تنامي وسائل الاتصال لم يُقلّص من المساحة التي يمكن للفرد التأثير فيها، بل تحول الفرد إلى جزء أساسي في نظام التسويق، فالعلاقة القائمة على “ارسال” الماركة لقيمها نحو “الفرد” “المستقبل” لم يعد قائماً بنسبة كبيرة. بل تحول الفرد إلى “مستهلك” و”مسوق” في آن معاً. وهو ما يعكس واقع أنّ دور الفرد تغير، مما يستدعي تغيراً في نوع الخطاب الموجه له بكونه فرداً واعياً مؤثراً لا مستهلكاً مستقبلاًً فقط. فالمجتمع أصبح أكثر وعياً، ونوافذ تلقي المعلومات أصبحت لا تُحصى، وبالتالي فإنّ التعامل مع الأفراد يجب أن يضع في عين الاعتبار “وعيهم” و”انفتاحهم” الذي يضع خطوطاً معينة عندما تريد هذه الشركة أو تلك الترويج أو التسويق لمنتجاتها أوخدماتها. بل لقد أصبح لدى الأفراد القدرة على وضع العصا في العجلة. حيث يمكن للفرد القيام بنشر عدوى إلكترونية – بغض النظر عن صحتها- ضد أي إعلان تقوم به شركة لمنتجاتها أو خدماتها، وخصوصاً تلك المتعلقة بصورة مباشرة بالصحة والسلامة أو خدمات الاتصال على سبيل المثال، وبميزانية لا تتجاوز عدة فلوس -وقت كتابته وإعداده للبريد الإلكتروني- قبال آلاف الدنانير التي تقوم بصرفها الشركة على إعلاناتها المطبوعة والخارجية -على سبيل المثال-. وتعتمد العدوى على حجم دائرة المعارف وقنوات الاتصال التي يتمتع بها الفرد من قاعدة بيانات للمعارف والأصدقاء. لم يعد بالإمكان الاعتماد على الطرق التقليدية في التسويق ورسم التأثير المطلوب ما لم تكن هناك قاعدة صلبة ترسخها الماركة من حيث جودة المنتج أو الخدمة. ومن يريد أن يتميز في دائرة الأفراد الشخصية ضمن محيطهم الإلكتروني، عليه ببدء نشر العدوى التي ستكون له بمثابة حملة إعلانية سيكون ناشروها هم الأفراد أنفسهم.
*مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.
-
كانتونات
جعفر حمزة*
لم يكن متحمساً لتقديم سيرته الذاتية في إحدى الدوائر الحكومية، بالرغم من حصوله على شهادة عُليا وتميزه في تخصصه، وذلك لأسباب يمكن أن يجلس ساعة كاملة ليشرحها لك بالتفصيل “الممل”. وتستطيع أن تقرأ ما بين كلامه “البرمجة السلبية” التي دأبت الكثير من الدوائر الحكومية في بثها وتطبيقها بصورة عملية وبشكل يومي. يشعر صاحبنا بعبارة أكثر وضوحاً ب”التمييز الوظيفي” بناء على انتمائه المذهبي. لا أكثر ولا أقل. وبغض النظر عن اتفاقنا مع ما يسرده من وجوه التمييز ومسلسلاته المطولة “المكسيكية” أو لا، فإنّ ذلك يستدعي التوقف وطرح المسألة بصورة علمية وعملية بعيداً عن “متهمي” الوضع الوظيفي الحكومي بالتمييز بالصورة “الشمولية” أو “منزهّي” ذلك الوضع ورسم الواقع على أنّنا في “المدينة الفاضلة”. لأنّه بسبب ذينك “القطبين” تتشكل سلوكيات متنافرة ومتناقضة لتقع في “الإفراط” و”التفريط”. و”التهويل” من القضية أو “تهوينها” لا يصب في مصلحة الإصلاح الاقتصادي والذي سينعكس على “توجيه” الكفاءات في محلها الصحيح، وبالتالي تكون النتيجة تطور ونماء حقيقي في المجالات المعيشية كافة. ربما يكون صاحبنا قد “شَعَرَ” أو “سَمِعَ” أو “قرأ” ما يُشكل له “قناعة” بعدم جدوى العمل في هذه الدائرة الحكومية أو تلك، بل قد ينسحب الأمر على القطاع الخاص والشركات والمصانع “الوطنية”. والأمر بالمثل في الجانب الآخر الذي “يعتقد” بأنّ الأمر “أخذ أكبر من حجمه” والباب “مفتوح لصاحب الكفاءة والقدرة، وما يُروّج له ما هو إلا “توسيع” مساحة “الإمساك” لفئة بأكثر من “عَجَلَة” في ماكينة الوطن! لقد أصبح التوجهان يُصيغان حالة من “ثقافة العمل السلبية” والتي ُتُفضي إلى “وأد” كفاءات وقدرات إبداعية في المملكة. وأذكر هنا مفهوم مهم جداً يرتبط بطريقة التعامل مع الأفراد وقبلها القضايا الكلية، وخصوصاً تلك التي لها صلة بجانب “الإنتماء” سواء كان مذهبياً أو نسباً أو عرقاً .وذلك بطريقة مُبرمجة مُسبقاً ولا شعورياً والتي تُعطي نتائج “كارثية” في حال إغفالها وتركها على حالها. وذلك المفهوم هو “الارتباط الضمني” “Implicit Association” والذي يذكره “Malcom Gladwell” في كتابه “Blink, The Power of thinking without thinking أو “التفكير اللمّاح في طرفة عين، قوة التفكير بدون تفكير”. وقد أُجريت العديد من الاختبارات بناءً على هذا المفهوم الذي يُعطي موشراً عن نمط التفاعل مع الآخر المختلف “جنساً ولوناً بل وديناً”، وقد تبيّن من خلال تجربة “الرجال البيض والسود” تمييزاً في العقل الباطن لدى البيض عن السود بطريقة لا شعورية تغذيها الكثير من الارتباطات والمفاهيم المتراكمة ليصل الإنسان إلى قناعة غير مُعلنة تظهر من خلال إشارات وعبارات وأحكام “عفوية” تجاه الطرف الآخر. وقد شكلت تلك التجارب “صدمة” للكثير من الرجال البيض-ومن ضمنهم المؤلف- الذين يعتبرون أنفسهم منصفين وحياديين ويؤمنون بأن الأعراق متساوية. (١) وما أوردناه سابقاً هو مجرد “تلميح” لأمرين هما: أ. اكتشاف حقيقة “التهوين” أو “التهويل” الجارية بحق جسم القطاع العام بل والخاص في الدولة فما يتعلق بمسألة التمييز الوظيفي. وذلك عبر إخضاع المسألة للبحث العلمي والإحصائي المحايد. ب. تفكيك التصوّر السلبي نتيجة الارتباط العفوي غير الموضوعي، والمتعلق بمسألة التمييز الوظيفي، والوصول إلى المساحات “الخطرة” في ذلك الارتباط، والذي يتحول مع مرور الزمن إلى “ثقافة” لا يمكن تغييرها إلا بصعوبة بالغة وتحتاج إلى سنوات طوال. ويمكن للذين يعتبرون هذا الحديث “ترفاً” أو “مبالغة” الرجوع إلى تقرير منظمة “International Crisis Group” للعام ٢٠٠٥م، والذي أشار إلى أهمية معالجة ما أسماه التقرير ب”مأسسة التمييز”، والذي يتخذ أنماطاً متنوعة وواسعة لقطاعات مختلفة من جسم التوظيف بالمملكة. وعوداً إلى ”الارتباط الضمني” والذي جعل من صاحبنا يُحجم عن تقدمه للعمل في تلك الدائرة الحكومية، والتي شكلت “التجارب” المتنوعة له “توقعاً وقراءً وسمعاً” نوعاً من “القناعة المُبرمجة”والتي من الصعب عليه أن يغيرها، وخصوصاً في ظل “ارتباط ضمني” يُمارس في الجهة المقابلة للكثير من الدوائر الحكومية والتي أصبحت “حكراً” على مجموعات تنتمي لانتماء مذهبي معين أو عرقي أو عائلي، وبالتالي يتحوّل ذلك الارتباط إلى واقع نعيشه ونتماشى معه سلباً أو إيجاباً. فالمجتمع مكون من جماعات مصالح أو انتماء أو اعتقاد. ومن الطبيعي أن يشعر كل فرد بتعاطف أكبر مع الأفراد الذين يشاركونه المصلحة أو العقيدة أو الثقافة أو الموقع الاجتماعي الذي يحتله. (٢) وتمثل “الطائفة” أجلى صور “التجمع” و”الجذب” المستند على مشتركات دينية وفكرية وثقافية وسلوكية معينة، ولها طابع خاص يميزها عن بقية المدارس الفكرية الأخرى، وتكون بمثابة “المجتمعات المسيّجة” التي تخف أو تشتد عقبات الدخول إليها اعتماداً على “إنفتاحها” و”تقبلها” للآخر. ولا تشكل الطائفية خطراً على المجتمع إلا إذا تحولت إلى أداة “إقصائية” للأطراف الأخرى في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث يتحول المجتمع حينئذ إلى “كانتونات” لا يمكنك دخولها إلا عبر “كلمة سر” و”صك غفران” مختوم ب”علامة الجودة”. ويذكر المفكر العربي “برهان غليون” بخصوص إسقاط الطائفية وغلبة مصلحة طائفة دون أخرى على السلطة “الدولة” بالقول: (استخدام الولاء الطائفي للإلتفاف على قانون المساواة وتكافؤ الفرص الذي يشكل قاعدة الرابطة الوطنية الأولى، وبالتالي لتقديم هذا الولاء على الولاء للدولة والقانون. وتحويل الدولة والسلطة العمومية من إطار لتوليد إرادة عامة ومصلحة كلية، إلى أداة لتحقيق مصالح خاصة وجزئية. إنها تشكل ما يشبه الاختطاف للسلطة السياسية التي هي أداة تكوين العمومية لأهداف خصوصية. إن الطائفية تنشأ عندما تنقل إحدى هذه الجماعات هذا التضامن والتكافل إلى مستوى الدولة).(٣) ولا نعتقد بأن الحل يمكن في سن تشريعات وقوانين ضد التمييز الوظيفي “على اعتبار وجوده وأثره السلبي”، إذ يتعدّى الأمر ذلك، فهي نوع من “السلوك اللاإرادي المتأصل” في الأفراد، ليقوم هذا المسؤول بإبعاد من ليس في دائرة إنتمائه، حتى لو كان “آينشتاين” ويقرّب ذلك من لا يعرف أساسيات العمل وأبجدياته حتى لو كان ؛مستر بين”. وتتسع دائرة “الكانتونات” لتشمل التمييز بناء على “المصلحة” فبغض النظر عن إنتمائك المذهبي فإن إدارة المصالح الخاصة هو القاسم المشترك في عملية التفاعل السلبية الحاصلة ووالتي تُبعد الكفاءات. فقد يشترك إثنان مختلفان في المذهب أو العرق لكنهما يُمارسان التمييز على الآخرين نتيجة تموضع مصلحتهما في إقصاء من ليس في فلك فكرهما. لذا لا يمكن وصم “التمييز الوظيفي” كونه مذهبياً فقط، بل أوسع من ذلك ليشكل بذرة الفساد الأولى. ويحذّر كل من “أنطونيا تشايز”و”مارثا ميناو” في كتابهما “تخيّل التعايش معاً” من ذلك “البعبع”، لكون الفساد صورة في غاية المحاباة والإغواء تقع في مجاهلها عواقب وخيمة وخطرة يُستبدل فيها حماس الموظف الحكومي الشاب بالإنفلات والسخرية من النظام. وتضيفان على ذلك بالقول “ويؤدي انتشار الفساد إلى كبح تنمية كيانات حكومية فعّالة كما يقوّض في طريقه الشرعية الحكومية. تعمل آلة الفساد داخل الدولة على عرقلة تطوير إدارة قادرة وتعيق إعادة الإصلاح الاجتماعي. فالفساد يكبح التمثيل الجيد والمحاسبة، ويضعف المؤسسات ويحمي المكتسبات غير الشرعية”. وكونهما بحاثتان عمليتان، فقد وضعتا مقترحات للحد من الفساد والذي يشكل فيه التمييز الوظيفي إحدى صوره والارتباط الضمني بذرته الخفية. بالقول” على الحكومات أن توجه الضربات ضد الفساد من خلال تأسيس مكاتب تحقيق في الشكاوى، وخطوط هاتفية مباشرة تتلقاها”. وللأمانة نقول، أنّ هناك جهوداً مخلصة وحثيثة لوضع قطار الكفاءات والمواهب في “سكتها” الصحيحة، والتي تضخ البلد بطاقات بشرية وكفاءات، بات السباق عليها حول العالم واضحاً ولا يمكن التغاضي عنه. حيث يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بوضع خطط قد لا تحد من “التمييز الوظيفي” والذي حذّر منه تقرير منظمة “ Crisis Group” إلا أنه يقوم مع صندوق العمل بضخ طاقات في مساحات متنوعة ستجعل من “كانتونات التمييز” عبارة عن جزر متفرقة لا يمكن وصلها، وبالتالي تضعف ولو بمقدار ملحوظ قدرتها على “التحكم” بمفاصل البلاد. والمهمة ليست بالهينّة إلا أن المهم هو أننا بدأنا ونتوقع المزيد، على الأقل لصاحبنا الذي قد يكسر “الارتباط السلبي” ليقدم سيرته الذاتية، ومن الجانب الآخر يرى إن كان أهلاً للعمل، ليكون الباب مفتوحاً لكل بحريني بغض النظر عن “مُسبقاته” التي لن تُضيف أو ُتُنقص من قدرة إنتاجه. فالجميع مثل خلية النحل، فلنتخيل أن جماعات من النحل داخل الخلية أرادت صنع العسل لنفسها دون بقية النحل في مملكتهم وبدأت بالتحزبات وعملت “كانتونات” خاصة بها. فهل ستكون هناك خلية نحل أو مملكة نحل؟1. يمكنك تجربة اختبار الارتباط الضمني المحوسب على الموقع www.implicit.harvard.edu
2,3. برهان غليون، مجلة الآداب البيروتية. كانون الثاني 07
* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.
-
“عدتُ لبتلكو”!
جعفر حمزة*
التجارية ١٨ يونيو ٢٠٠٨
تخطّى مراحل متعددة من الاختبارات والمقابلات حتى وصل إلى المرحلة النهائية التي تؤهله لشغل الوظيفة التي تقدم إليها في الشركة، وكان قراره بصرف النظر عن العمل في تلك الشركة “مفاجأً” للمعنيين بالأمر، فبعد كل تلك المراحل يقرر صاحبنا وبقناعة تامة لا تتزعزع عدم الإنخراط في جسم شركة بدء بعض موظفيها بالهجرة إلى مجتمعات عمل “أخرى”، فضلاً عن “ترسّخ” لصورة سلبية بدت بالنمو والإنتشار بعدما كانت “برعماً” ترك انطباعاً سلبياً للمجتمع المحلي في أكثر من موقف. كانت تلك قصة أحد المتقدمين لشغل وظيفة في شركة ” بتلكو”، والتي نقلها لي أحد موظفين الشركة بعد تقديمه لي صورة مفتتة من الداخل لجسم الشركة والتي تمثل بعضها في انتقال الموظفين إلى شركات أخرى للبحث عن جو يحفظ خبرتهم ويقدر جهودهم، فضلاً عن حفظ ماء وجوههم الذي بدا “مُراقاً” في شركة كان من الأولى أن تحتضن موظفيها وعامليها كونها تمثل نسقاً وطنياً وصورة تفاعلية أولى في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في البحرين. إنّ التحوّل في صورة “بتلكو” من دائرة التفاعل النسبية نوعاً ما -والتي كانت أمراً لا بد منه-إلى دائرة “النفور” و”الابتعاد” يمثل “فشلاً” بامتياز في مجال الأعمال والتسويق. وتدفع الشركات التي تريد التميز والاستمرار الكثير من الأموال والجهود والأبحاث لتعزيز صورتها بين مستعملي خدماتها، وتزداد أهمية تلك الخطوات اتساعاً مع وجود منافسين في السوق، وبالرغم من “تميّز” بتلكو بالأسبقية في تقديم الخدمات للمواطنين ومعايشتها معهم أكثر من عشرين عاماً، إلا أن تلك الفترة قد انتابها الكثير من “المطبات” في العلاقة بين الشركة ومستعمل خدماتها، ومن بين تلك المطبات: أولاً: التحكم في نوعية وسعر الخدمات المقدمة طوال فترة وجودها في السوق دون منافس، وهو ما زرع صورة لم تتميز بالإيجابية على الدوام. ثانياً: التجربة السلبية خلال فترة الاحتقانات التي شهدتها البحرين في التسعينيات، حيث كانت الشركة تقوم بإغلاق النوافذ الإلكترونية التي تم اعتبار الكثير منها “خارج إطار القانون” في حين كان بعضها يمثل ” صوتاً حراً” يعبّر عن آراء الكثير من طبقات المجتمع. وكانت نتيجة ذلك تعزيز “مضاعف” لصورة بتلكو السلبية “Negative Image”. حتى أصبحت مادة لصناعة “القفشات والنكت” وفاكهة غير مرغوب بها في الكثير من المجالس، ولئن كان بعضها “يتطرف” في وضع سلبياتها على الطاولة إلا أن البعض الآخر كان يعبّر عن حقيقة يعشيها المواطن. ثالثاً: السياسة الإدارية للشركة في قضية الــ ٤٤ موظفاً، والتي أصرت الشركة على عدم إرجاعهم للعمل بألف حجة وحجة، وتلك القضية هي “الشعرة التي قصمت ظهر البعير” فيما يتعلق بصورة الشركة الموجودة في المجتمع. وبعد تضامن نقابات بعض الشركات مع الموظفين المفصولين، بدت “بتلكو” في تخبط آخر وكأنها “تفقأ عينيها بيدها”، حيث ربطت مقاطعة خدماتها باحتمالية تسريح جديدة لبعض موظفيها. وتلك “مقارعة” بعيدة عن أبجديات التسويق والتواصل والصورة المقدمة للسوق، خصوصاً مع استمرار الرسائل الإعلامية التي تقدمها الشركة والبعيدة عن ملامسة زبائنها، فمن “التواصل عادتنا” والتي أثبتت التجارب مع الشركة بُعدها عن هذا المفهوم إلى الحملة الجديدة بافتتاحية لعبارة “عدتُ لبتلكو” مع صور لزبائن “رجعوا” للشركة نتيجة “خدماتها المميزة”. كل تلك الصور المقدمة تمثل “انفصاماً في هوية الشركة”، وعملية التسويق والاقتراب من الزبون تستلزم حلولاً عملية وتواصلاً حقيقياً لتتعزز صورة الماركة في الحياة اليومية للفرد، وتزداد أهمية هذا الحديث عند تناول خدمة تمثل جزءً من حياتنا اليومية “الاتصال” سواء عبر الهاتف بنوعيه أو الإنترنت. ولا يكفي “التبرّع” لبعض الجهات لأجل الظهور في الإعلام، في حين “تقطع” الصلة الحقيقية بالمجتمع بتهديد أرزاق” أفراد في المجتمع وانتهاج “سياسة التعنّت” وبصوت عالٍ. تسعى الشركات التي تريد أن تعزز حضورها في حياة الفرد اليومية لجعل موظفيها ينشرون قيمها بقناعة، ويتمثل ذلك في تغيير مفهوم “الموظف” ليكون فرداً من عائلة تحت سقف واحد وهو “الشركة” بقيمها وثقافتها ورسالتها، وبالتالي ينعكس ذلك عبر نشر الصورة الإيجابية للماركة في المجتمع، وهو ما ينعكس على “توجه” أكبر للأفراد نحو هذه الماركة دون غيرها. ذلك الأمر تقوم به الشركات الناجحة حول العالم، وتبتعد قدر الإمكان من “خدش” صورتها، لذا تسعى وبجدية لتكون علامتها التجارية ذات سمعة وحضور فاعلين، والحديث يدور حول شركات في معظم دول العالم مع وجود منافسين آخرين ينتهجون نفس السبيل، فما بال شركة تركت صورة سلبية عنها بخصوص فصل الموظفين الـ ٤٤، في حين تفتتح حملتها الإعلانية الأخيرة بالقول “عدتُ لبتلكو”؟ مع وجود الأسباب التالية، لا نعتقد بأن “بتلكو” تملك الصورة الإيجابية التي تتوقعها: أولاً: تراكم التجارب السلبية حول الشركة من الداخل والمتمثل في حركة البحث عن موقع قدم خارج الشركةليس نتيجة بحث طبيعية بقدر ما هي “فرار” منها، ومن الخارج نتيجة التجارب السابقة والحالية في مجال الكثير من الخدمات. ثانياً: وجود خيارات أخرى يمكن للفرد الأخذ بها، وذلك لوجود شركات اتصال متعددة سواء في مجال خدمة الهاتف المتنقل أو الثابت. وهو ما فتح المجال للتنفس دون “وضع البيض في سلة واحدة” وهي سلة بتلكو. ويخطأ إنْ ظنّ البعض بأنّ منتجات وخدمات الشركة الحالية والمستقبلية ستكون كفيلة بضمان “ولاء” الزبائن لها، وذلك من الأخطاء الرئيسية التي تقع فيها الكثير من الشركات حول العالم، وتسعى الشركات التي تريد التميز والنجاح لتلافي ذلك التصور الذي ذكره الكاتب “Matt haig” في كتابه “Brand failures”. وهو الأمر الذي على بتلكو التفكير فيه لتوسيع قاعدة مشتركيها، ولا يكفي القول “عدتُ لبتلكو” إن كان من يعمل فيها خارج منها، ومن هو خارج عنها لا يفكر فيها، ولو أُتيح المجال لتغيير مشغل الخدمة لزبائن بتلكو دون تغيير أرقامهم لرأينا أرقاماً جديدة لعدد مشتركي بتلكو، ولسمعنا نغمة أخرى في الكلام. والحق يُقال بأنّ الحكومة ساهمت في تقديم تلك الصورة وفي تعزيز تلك الأزمة بلحاظ حضورها الفعلي والمالي في الشركة، ومع استمرار ذلك النهج، على بتلكو أن تُبقي الحملة الإعلانية الأخيرة “عدتُ لبتلكو” كما هي دون تغيير سوى استبدال الأشخاص الحاليين إلى ذوي البشرة البيضاء والشعر الأشقر ليسر من لديه عقدة نقص تُفتت المجتمع وتهز الكفاءة الوطنية لتقديم ما لديها في رفع الاقتصاد الوطني. وإلى أنْ يحين الوقت الذي تمثل فيه الشركة “خياراً” مفضلاً للمتميزين من أبناء هذا الوطن في مجال العمل، يبقى السؤال عن المقصود في خطاب “عدتُ لبتلكو”؟!* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرف