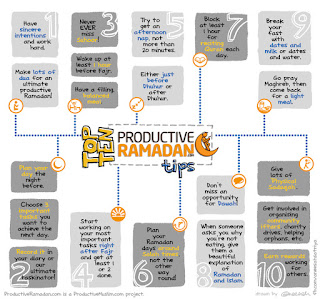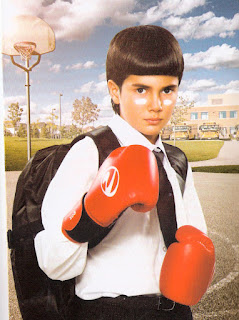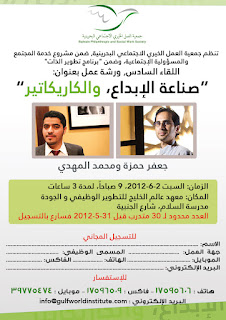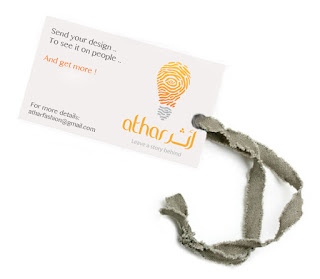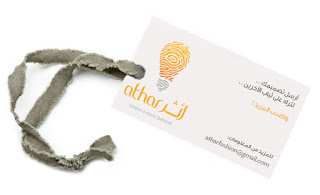الموت بين آليتي الدفع والرفع
جعفر حمزة
الدفع والرفع محركان أساسيان لحياة الإنسان المادية والروحية، وانعدامها فيه يستلزم التفكر الجاد في استغلال تلك الآليتين قبل فقدانهما على ساحة التفاعل الأرضي بالموت، وقبل التطرق إلى البحث في مفردات الحديث عن الموت، لا بد من هضم مفهومي الدفع والرفع المُشكّلان لعنوان هذه النظرة التحليلية لمفهوم وجودي ملموس كالموت.
ولتوضيح مفهومي الدفع والرفع نذكر مثالاً يُترجم ذينك المفهومين بصورة مباشرة، فعند التنبؤ بوجود مرضٍ ستكون ردة فعلك الطبيعية أمرٌ من اثنين، إما الوقاية المبكرة من المرض، وإما تجاهله وإصابتك به ثم تقوم بعلاجه، فالأول يُدعى بالدفع- لدفعك المرض عن نفسك-، والثاني يُدعى بالرفع- وهو رفع المرض عنك بالعلاج منه-، وانسحاب هذين المعنيين على الموت ليس انسحاباً تطابقيّاً في التعامل، بل هي مقارنة مع نظرات متباينة تتعامل مع الموت كلٌُّ حسب طريقته التي يشكلها التصور العام لمعنى الوجود والحياة في سلوك الإنسان، والتطرق إلى مثل هذا النوع من الحديث تُحركّه الكثير من الدلالات التي يشكلها الإنسان حول نفسه كفرد في هذا العالم الواسع، وهذا الأمر ينعكس كنتيجة أولية على التفاعل اليومي بين الفرد ومحيطه من مادة ومفاهيم وسلوك.
وكنقطة انطلاق للبحث في أيقونة الحياة المتجددة(الموت)، لا بد من تطرق بديهي إلى الحكمة من وراء تلك الطاقة المتحررة من الجسد(الروح)، يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام) وهو من أئمة الشيعة لأحد تلامذته ” الجُعفي” رداً على المُشككين من الملاحدة المتكلمين بخصوص الحكمة من الموت: أفرأيت، لو كان كل من دخل العالم ويدخله يبقون، لا يموت أحد منه. ألم تكن الأرض تضيق بهم، حتى تعوزهم المساكن والمزارع والمعائش، فإنهم والموت يفنيهم أولاً فأولاً، يتنافسون في المساكن والمزارع، حتى تنشب بينهم في ذلك الحروب وتسفك فيهم الدماء، فكيف كانت تكون حالهم لو كانوا يولدون ولا يموتون، وكان يغلب عليهم الحرص والشره وقساوة القلوب، فلو وثقوا بأنهم يموتون لما قنع الواحد منهم بشيء يناله، ولا أفرج لأحد عن شيء من أمور الدنيا، كما قد يمل الحياة من طال عمره، حتى يتمنى الموت والراحة من الدنيا).
والغريب في الأمر أن ثبات الأشياء في هذا الوجود فعلاً وقوة يستدعي الإختلاف في فهم معنى الفعل والقوة في الأصل، فالبذرة شجرة بالقوة، بمعنى كمون معنى ومادة الشجرة فيها، وبمعنى آخر أن البذرة مؤهلة لأن تكون شجرة، وهي بالفعل تكون شجرة إذا وُفرّت لها الأجواء من تربة وماء وأملاح وضياء..
فاختلاف الآراء في فهم الثابت ك”الموت” يُشكّل السلوك المتفاعل معه سلباً أو إيجاباً، فالشجاعة مثلاً، قيمة مجردّة ثابتة في الذهن كمفهوم، متغيرة في السلوك كتفسير لها، فالشجاعة صفة خُلُقية بين الجُبن والتهوّر، ومع وجود المُسبقات العقلية التي تجذب الشجاعة إلى الجُبن أو التهور بناء على تلك المسبقات مُساقة معها التبريرات، فتغير المفهوم الفطري الإنساني للكثير من القيم سببها تغير هضم الفهم الطبيعي لتلك القيم، فرب مجتمع ينظر إلى التهور كقيمة إيجابية لتتحول إلى شجاعة، والكثير من المجتمعات المعاصرة تنظر إلى بعض الأمور على أنها تمثّل قمة الشجاعة، كالألعاب البهلوانية الخطرة في أتون النار والمتفجرات، وقد تصل مرحلة التهور والمجازفة لتشمل أعداداً أكبر ليحركها بعدئذ عقل جمعي واحد إزاء مثيرات معينة تُربط بصورة أو بأخرى بأحداث تاريخية أو وطنية، ليكون الثمن المدفوع حينئذ أرواح أُناس انخرطوا في توليفة جماعية لا أساس لها من العقلانية، ولا أدل على ذلك من الإحتفالات الخطرة التي تجري في أسبانيا كل عام “ملاحقة الثيران”، وبصورة أعم “احتفالات رأس السنة” التي تعم العالم أجمع، لتؤخذ من صورة الفرح منطلقا تنفيسيّاً لمعناه في سلوكيات خطرة تُذهب بأرواح أناس شكلّت عقلية الحياة عندهم في مفهومها المتداول قوة الإعلام والسياسة الباردة في مفهومها للإنسان، وهكذا يتشكل الفهم للكثير من القيم الإنسانية بناء على توجيه مباشر أو غير مباشر للقوى الاجتماعية لتحوّل التهور إلى شجاعة، والصدق إلى ضعف، وهكذا تتوالى التغيرات في مجمل المفاهيم التي نعيشها ومن ضمنها الموت.
حتمية الموت لا يختلف عليها إثنان، ومن رأى غير ذلك فما عليه إلا الانتظار ليأتي دوره في سفر عبر الزمان والمكان إلى عالم آخر ليس مُختاراً في رفضه أو قبوله، إن ما يُختلف عليه هنا، هو فهم الموت الذي يشكّل فيصلاً في أي مجتمع لتكوين الإطار العام لسلوكه ومنهجه مع ذاته ومع الآخر، ولملامسة أهم الأُطر المعرفية للتفاعل مع الموت سلباً أو إيجاباً، سنأخذ ثلاث نماذج تشكل حسب رأينا الثلاثة الرئيسية المُسهمة في رسم التفاعل الواقعي والملموس مع مفردات الحياة اليومية للسواد الأعظم من البشر..
النموذج الأول/ الفلسفة الوجودية والتي تأخذ مساحة واسعة من الفكر الغربي المتمركّز في الدول الغربية وبعض دول العالم الثالث، والفلسفة الوجودية هي مذهب فلسفي يقوم على دعوة أن يجد الإنسان نفسه، عبر التحلل من القيم والإنطلاق لتحقيق الرغبات بلا قيد، وعبارة أخرى(تمتع بيومك قبل ذهابه كأقصى ما يكون التمتع)!!
فلسفة تمثّل الإله الجديد في عالم اليوم، أو كما يُسمّيه الفيلسوف الفرنسي المسلم”روجيه غارودي” بـ(تأليه السوق)، فلسفة تستند على تسخير كل ما يملك الإنسان من قوة ودهاء وقدرة عقلية وجسدية في نقطة واحدة تكون همه الأول والأخير، نقطة تستنزف كل إبداعاته الإنسانية وأخلاقياته الفطرية، نقطة تُذهب ببريق معنى الحياة الإنسانية في وجوده، نقطة تحتوي في ذاتها كل عناوين المصلحة الذاتية، والربح السريع، والتمتع بالشهوات بدون حساب، وجلب المصلحة على حساب الآخرين، والتفنن في القوة، كلها دلالات شكلتها الإحصاءات السنوية عن عدد الجرائم والتمزق الاجتماعي في الغرب.
ما نتوقع من مجتمع يعيش أربعاً وعشرين ساعة يومياً في ظل أيدلوجية مركزية المصلحة عبر تأليه السوق، ومثل هذا المجتمع لا بد أن نرصد له مؤشرات تُبعده عن التعامل الجاد مع الموت كبداية لمرحلة لها وضعها الخاص وحساباتها المنفردة بها، فالمجتمع الذي ينظر إلى الموت كواقع يتعامل معه كمحفّز للاستفادة – مهما كانت الوسيلة- مما هو موجود في هذه الحياة، والاندفاع المُفرط في التمتع بلا حدود وانعكاسه على السلوك الاقتصادي، عبر ترويج ثقافة التمتع المتنوع من خلال ازدهار سوق الرقيق الأبيض من جهة، والبضاعات الإباحية من مواقع إلكترونية ومنتجات وأفلام وإعلانات تجارية بل وثقافة عامة في هذا الأمر من جهة أخرى، لتصل إلى الأطفال عبر بعض الدلالات الموجهة من خلال الرسوم المتحركة وألعاب الكمبيوتر والفيديو، وتشرّب الناس في انجذابهم اللامنقطع إزاء مثل هذه العقلية، تُنعش السوق وتحركه، وينسحب الأمر بطبيعة الحال إلى الرؤية العامة للدول من سياسة واجتماع، يُحركها التيار الأقوى مادياً والباسط سيطرته على السوق.
والمرآة التي تعكس جزء لا بأس به من التصور الذاتي للمجتمع هو الإعلام-أقصد الإعلام الذي يتفاعل معه أفراد المجتمع، وإلا لن يكون مرآة تعطي ولو جزءً بسيطاً من المصداقية-، فالمدقق في الأفلام الغربية ودلالاتها يتأكد من وجود” المركزية الفردية” للإنسان في التعامل مع متغيرات الحياة وصعوباتها، ومن ضمنها الموت، فمعظم الأفلام الأجنبية والأمريكية على وجه الخصوص، تُسلّط الضوء على التعامل مع مستجدات الحياة وصعوباتها عبر الاستناد للخوارق والبطولات الفردية، أو ما نسميه بـ”الترسانة الفردية”، ليكون مفهوم التعامل مع الحياة فضلاً عن الموت، تعاملاً يستند فيه الفرد على قوته الذاتية وإلغاء مساحة الحوار مع الآخر، ووصمه بالغدر والعدائية، بل تصل العقلية الغربية إلى أن تتعامل مع الموت ككابوس إن لم يكن بالإمكان التخلص منه، فعلى الأقل التخفيف منه، أو- وهذا احتمال ثالث- مواجهته لقهره وإبعاده عنك لفترة أطول، كما في فيلمي
Final Destination 1 & 2.
وقد تبرز بعض الأفلام الأمريكية “الموت” كثمن يجب دفعه مقابل مفاهيم تُصاغ حقيقة في المطبخ السياسي الأمريكي، ليتحول الموت إلى قيمة سامية يجب التعامل معها بروح شجاعة، في مقابل أن تُحصد أرواح أخرى بالمقابل دون أي تأنيب لضمير حتّى، كأفلام حرب فيتنام، فيلم”بيرل هاربر”، وغيرها كثير التي تمثل الأمريكي الإنسان المحافظ على الحياة، ولئن واجهه الموت فهو لا يتردد في الدفاع عن وطنه-أو هكذا يُصوّر لهم- عبر مُدعيات تُساق لهم ليتحوّل الآخر في نظرهم إلى عدو يجب التخلّص منه دون التردد في قتله، ويحضر في ذهني ذلك الرجل العجوز المدمن على الكحول في فيلم
“The Independence Day”
، التي تملكته الشجاعة ليصبح فدائياً بتفجير طائرته في وسط مركبة الفضاء الغازية للأرض!!
قيمٌ تُدرس وتُزيّن ثم تُنشر من جديد على مجتمعات البشرية، والملامسة القريبة إلى المجتمع الأمريكي على سبيل المثال تُظهر نسبة الجرائم المتصاعدة عاماً بعد عام، وللعلم فإن نسبة المحاولات التخريبية والإنقلابية في كثير من الولايات الأمريكية أكثر مما يُتصوّر ويُنقل عبر الإعلام الأمريكي، وأعضاء الميليشيات السرية الأمريكية كلهم أمريكيون، مما يدفع بالسؤال إلى إمكانية تحوّل “الموت” عند فئتين من الناس في الغرب إلى قنابل بشرية متحركة تحصد أرواح الكثير من الناس، إحدى الفئتين تعيش الفراغ الروحي وتريد أن تنقل ذلك الفراغ إلى الآخرين عبر قتلهم، والأخرى تريد أن تكون حياتها عبّارة للحرية التي يريدونها هم.
وقد تتحول الحياة في معناها إلى عدم، وذلك إثر فراغ روحي عميق يُذهب بمعنى الحياة الحقيقي، وينسى الأمل المعلّق في روح الإنسان في هذه الحياة، لترتفع نسبة الانتحار سنوياً في الولايات المتحدة خصوصاً، والمجتمعات الغربية برتبة ثانية ثم الدول النامية عموماً.
وإذا انسحبت عقلية “تمتع بيومك كأقصى ما يكون التمتع”،ولا تنظر إلى الغد بكآبة المرأة الثكلى، بل بروح الشباب المتوقّد الذي يفرح ويتمتع بيومه ليعيد الكرّة غداً، إذا انسحبت هذه العقلية إلى الساسة فستكون دائرة المأساة أكبر، لتشمل أكبر عدد من أفراد الشعوب المقهورة على أمرها، لتتحول تلك الشعوب في نظر أولئك الساسة إلى أعداء يجب القضاء عليهم، وإلى خطر إرهابي من اللازم التخلص منه.
النموذج الثاني/ فلسفات تنظر إلى الموت كبداية لحياة أخرى، ويُتعامل معه في دائرة الفردية الخاصة التي لا تنسحب إلى عناوين كبرى تُشكّل السلوك الجمعي في بناء مجتمع يُعيد بناء نفسه من جديد عبر مفهومه للموت كمحرك إيجابي للتطور والتقدم، فتتحرك عبر دائرة الفردية الخاصة، وهي إيجابية في حد ذاتها إلا إنها لا تشكل منظومة واضحة الملامح للتفاعل مع متغيرات الحياة على جميع الأصعدة، ومن تلك الفلسفات –نطلقها مجازاً- المسيحية واليهودية والبوذية وبعض الديانات والمذاهب الأرضية.
يقول النبي عيسى(عليه السلام): (البناؤن يقولون إن البناء يكون بأوله،وأنا أقول لكم إن البناء يكون بآخره)، مبدأ يُحرّك الإنسان المسيحي المؤمن إلى تذكر الآخرة التي تدفع الإنسان إلى العمل الجاد الخالص لله تعالى.
وعند مطالعة إلى الفكر الأمريكي، نرى ترنيمة الحياة بمعناها الوجودي الإيجابي تقترن بحقيقة “الموت”، وذلك من خلال قصيدة (مزمور الحياة
A Psalm of Life)
لــ
(Henry Wadsworth Longfellow)(1882-1807)
حيث يقول:
لا تقل لي، بلغة الأرقام النائحة
إن “الحياة حلم فارغ ليس إلا”!
لأن الروح في السبات ميتة،
وليست الأمور كما تبدو.
الحياة حقيقة، الحياة جادة،
وليس القبر هدفها؛
“تراب أنت وللتراب ترجع”،
ما قيلت من أجل الروح.
لا الفرح، ولا الحزن،
غايتنا المقدرة أو طريقنا؛
ولكن أن نعمل، من أجل أن يجدنا كل غد
قد تخطينا اليوم.
الفن ممتد، والزمن يتسارع،
وقلوبنا مع أنها قوية وشجاعة،
ما تزال، مثل طبول مكممّة، تضرب
ايقاعات موسيقى عسكرية جنائزية متجهة للقبر
في ساحة الحرب العالم الواسعة،
في معسكر الحياة، لا تكن مثل قطيع أبكم مُساق!
كن بطلاً في الصراع!
لا تثق بأي مستقبل، مهما كان ممتعاً!
دع الأمس الميت يدفن موتاه!
إفعل-إفعل في الحاضر الحي!
قلبك في داخلك،والله من فوقك!
حياة كل الرجال العظام تذكرنا
أن بوسعنا السمو بحياتنا،
وحين نفارق، نُخلّف ورائنا
بصمات أقدامنا على تراب الزمن!
بصمات أقدام قد تجعل غيرك،
وهو يبحر فوق شواطيء الحياة المهيبة،
أخاً بائساّ تحطمت سفينته،
يراها، فيستعيد يقينه.
دعنا إذن ننهض، ونعمل،
بقلب مؤمن بأي قضاء؛
ننجز باستمرار ونسعى باستمرار،
نتعلم أن نكدح وننتظر.
نماذج لا تلقى صدىً في خضم عقيدة اللذة السريعة، والمصلحة الذاتية، لا يُنكر وجودها في عصرنا، إلا أن التفاعل معها شبه معدوم.
النموذج الثالث/ النظرة الإسلامية التي تنظر إلى الموت كمحرّك له آليات تقبلّه وفهمه في المجتمع، واستخدامه كصمّام أمان مُذكِّر، يقول النبي الأكرم(ص): اذكروا هادم اللذات، قيل : يا رسول الله وما هادم اللذات؟،قال(ص):الموت، فإن أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراً للموت،وأشدهم استعداداً له.
وتشكّل عقلية الإنسان المسلم للتفاعل مع الموت عدة آيات قرآنية، ترسم له التوجّه الحركي إزاء الموت كحقيقة وجودية دافعة للعمل الصالح وبناء الذات، قال تعالى:”قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكِّل بكم، ثم إلى ربكم ترجعون” السجدة 11.
“كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأُدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور” آل عمران 18.
ومع يقينية الموت إلا أن الشك وارد فيه بلحاظ عمل الإنسان والاستعداد له،يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام):”لم يخلق الله عز وجل يقيناً لا شك فيه أشبه بشكٍّ لا يقين فيه من الموت”.
لذا تكون عملية تذكر الموت واردة في المفهوم الإسلامي، قال تعالى:”ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر”التكاثر 1، حالة إنسانية طبيعية أن ينسى المرء، لذا يكون لفت نظره بالموت كعامل مهم للإبتعاد عن الاستغراق في العمل الدنيوي الذي تذوب معه الكثير من القيم والحس الإنساني السليم،نتيجة أجواء تعطي مفردات الانجذاب إلى الأرض والمنسحب كنتيجة له في التعامل مع الآخرين من منطلق جلب المصلحة بغض النظر عن الوسيلة، وهذه العقلية السلوكية تسحب بظلالها السلبية على بقية أفراد المجتمع التي تحركهم ردة الفعل إزاء الفرد المتمركز بقوته المادية والاجتماعية حول نفسه فقط، وغض النظر عن الآخرين، ليكون المجتمع حينئذ في دائرة الفعل ورده في عملية متواصلة تنخر في أصل المجتمع وتأكل من جهوده واستقراره.
وتذكّر الموت هو المُقنّن لعملية الانجذاب اللاشعوري إزاء المصلحة التي تسحق الآخرين، ونرى في المنظور الإسلامي آليات عدّة لتكّر الموت، منها زيارة القبور، وتجهيز الكفن، يقول الإمام الصادق(عليه السلام):”من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجوراً كلما نظر إليه.
وسيلة تذكّر تقلِّل إلى حد كبير من عجلة السقوط في تأليه الذات عبر نسيان مصيرها، ومجتمع هكذا تصوره، يجعل من الموت رقيباً ذاتياً مُذكرّا له على الدوام، مجتمع يبني ذاته يومياً، وأتذكر وجود بعض المحلات في إيران يوجد بداخلها حفرة شبيهة بالقبر ليتذكر صاحب المحل الموت على الدوام ليكون رادعاً له عن الغش في البيع!
والمحرّك العام للتفاعل مع الموت والحياة جمعهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام):”اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً)، هي ثنائية التعامل الكفيلة عند تحقيقها في أي مجتمع أن يضمن الرقابة الذاتية عبر ترك الغش والتمييز والمحسوبية من جهة، وضمان التطور والتقدم المستمر من جهة أخرى.
وأخيراً نقول، أنْ أترك بصمتك، فلك الحرية في اختيار نوعها قبل مغادرتك، ولكن تأكد من أنها تترك أثراً طيباً تُؤمن به ومتيقن به بع ذلك، والمفهوم الإسلامي للأثر الطيب يعطيه من خلال ثلاث: عمل صالح يُذكر به، أو صدقة جارية يُنتفع بها، أو ولد صالح يدعو له.
وبهذا يتحول الموت في عدميته الظاهرية إلى حياة أو العكس، ليكون لدى الإنسان في تعامله مع ذاته والآخر صنفان من المجتمعات، مجتمع ميت بحياته،وآخر حي بموته.