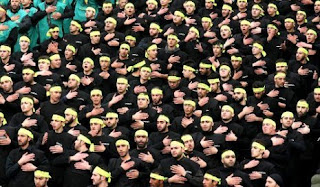جعفر حمزة*
“كم هذي بيّا؟”
“خمس روبيه”.
لم يلتفت إلي حتى، فهو يعرف ما أريد، بل ويعرف ما أشرت إليه ويعرف الإجابة مسبقاً، ف”برادته” أصبح يعرفها مثل راحة يده، فهو محيط بكل تفاصيلها من العلكة إلى كيس الأرز مكاناً وسعراً وماركة، فهي مملكته التي تفيض بكل ما يحتاجه أي فرد.
لم يتغير سيناريو الحوار مذ صغري إلى الآن، بل بات فصلاً يومياً في حياتي التي تجاوزت الثلاثين، وهو نفس السيناريو الذي لم يك ببعيد عن من يكبروني سناً، فتفاصيله كما هي لم تتغير، حتى أصبح السؤال عن سبب استمراره مستغرباً ولا داعي له، فأبطاله معروفين وتصنيفه الدرامي مُعاش يومياً وحبكته البسيطة في الظاهر مُسلّم بها، وكفى.
ويستفزني تفكيري تارة بعد أخرى عن العمل النشط في هذه البرادة وأين تذهب “الخمس روبيات” وغيرها من الأموال، فما دامت “حاجتي” موجودة وبمقدوري دفع “قميتها” فلا داعي لكل تلك الأسئلة وما وراءها.
فهناك المئات من البرادات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار من قبل غير البحرينيين، فهل تُحدث تلك فرقاً حتى نسلط الضوء عليها؟ وما هي حجم الأموال المحولة إلى خارج البحرين من تلك البرادات حتى نتوقف للسؤال؟
قد تكون الإجابة في بساطة السؤال عندما نسأل عن كمية الأموال “المرحلة” من قبل أصحاب البرادات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يمتلكها غير البحرينيين، وهل تمس سلباً بالاقتصاد الوطني- والذي يسعى القائمون عليه حسب المعلن أن يكون معتمداً علي ذاته في ظل المتغيرات العالمية-؟ وهل تلقي بظلالها سلباً على المواطن البحريني-إن وُجدت-؟
بل كيف السبيل لإيجاد البديل إن كان مجرد الحديث عن أولئك المئات من “مزودي” البضائع الأساسية يمثل تحدياً وطنياً وعائقاً في طريق الإعتماد على الذات وإثراء الاقتصاد الوطني في أقل صور الاقتصاد والتجارة وهو ما يُسمّى ب
؟”mini Projetc”؟
لسنا بصدد الحديث عن قطع أرزاق المتغربين من الأجانب في البلاد، بل يدور الكلام حول أهمية الاستفادة من الملعب والجمهور أي “الثقافة والمستهلكين” واللذان يعملان بشكل طبيعي لصالح البحريني بطريقة ميكانيكة سلسة، إلا أن ما ينقصنا هو وجود لاعبين محترفين أو على الأقل لاعبين لديهم الحماسة والرغبة والإقدام على اللعب. وإن وجدوا فليس كل اللاعبين مما يجعل الفريق في وضع غير مستقر، فضلاً عن ضرورة وجود مدرب يتمتع بكفاءة يمكن الإعتماد عليه في إنزال اللاعبين في الوقت المناسب وحسب خطة مُحكمة.
ويتعدّى الأمر “تحرير” البرادات من “السيطرة” غير البحرينية عليها، لتشمل كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تدخل ضمن مصروفاتنا الحياتية الضرورية من طعام ولباس وصيانة في المنزل أو السيارة، فتلك الأمور تشكل نسبة ليست بقليلة من مجمل مصروفاتنا الشهرية، وإلى من تذهب؟
ونتيجة لصغر المساحة وازدياد الكثافة السكانية بات التنافس قائم على قدم وساق في جميع المجالات، حيث ترى العديد من البرادات المتلاصقة ومحلات الثياب المتجاورة والكراجات المتزاحمة، ليكون السؤال هو من يُدير تلك المحلات؟
ولوجود تحديات عديدة تُخرج الإنسان البحريني بصورة خاصة عن إطار العمل الواحد، فضلاً عن السعي للتوسعة في المعيشة وتحقيق الذات والطموح، أسهم كل ذلك في وجود دافع للعمل الخاص والإضافي للبحريني، وتتنافس الأعمال الخاصة بقوة إلا أن هناك مساحة لم يتم الاقتراب منها بصورة واضحة سواء في مجال البيع والشراء في البرادات أو تلك المتعلقة بالملابس والحلاقة بنوعيها النسائي والرجالي، وإن وجدت فهي على استحياء وغير منظمة.
وبالرغم من وجود العديد من المشاريع والمبادرات المحلية “المتواضعة” إلا أنها لم تأخذ “دورتها” الكاملة لتحقيق “حضور” فعلي في السوق المحلية، لنرى “ماركة محلية” هنا أو اسم تجاري بارز هناك، لتصبح السوق المحلية بما هو متوافر من مقومات بيئة تتوالد فيها الماركات المحلية والمشاريع اليافعة، والتي تُسهم في تكوين دورة حياة جديدة للاقتصاد المحلي في نطاق المشاريع الصغيرة
mini projects
عندما يكون “راجو” ماسكاً لهذا المحل و”كومار” مديراً لتلك الورشة في العديد من المحال (١)، فذاك يقدم مؤشراً على ثلاثة احتمالات، إما استغناء المواطنين عن الإمساك بتلك الأعمال نتيجة ارتفاع دخل الفرد وبالتالي تتحول هذه النوعية من الأعمال للأجانب. وإما أن يكون هناك عدم ثقة من جهة المالكين في المواطن سواء لأسباب اجتماعية أو شخصية للمواطن الذي لا يفكر بجدية في الدخول في هذا النوع من العمل نتيجة ضعف الراتب والعمل المضاعف -ولكل قاعدة استثناء-.
أو نتيجة غياب دعم للمبادرات الفردية في العمل.
ونتيجة لتنوع الأعمال الحرة والصغيرة على طول البلاد وعرضها، والذي يكسبها أهمية هو إمكانية توفير المواد الأولية مع وجود شبكة من العلاقات العامة وصغر المساحة، مما يجعل من الترويج أمراً يحتاج إلى السمعة الجيدة أو إعلان في النشرات الدعائية المعروفة، وما عليك إلا استقبال الاتصالات، لتكون المهمة التالية هو كسب الثقة والاستمرار في تطوير العلاقات مع الزبائن وتطوير العمل بالتالي.
إنّ العملية تحتاج لأكثر من طرف للدخول في “صناعة الاقتصاد المصغر” والمتولد من المجتمع وإلى المجتمع ليحقق نوعاً من الإكتفاء الذاتي في التوسعة على نفسه أولاً، ولتقليل حجم البطالة الظاهرة والمقنعة ثانياً، ولإنعاش المستوى المعيشي للمواطن ثالثاً، وكل ذلك يصب في مصلحة المجتمع والدولة على حد سواء، وللوصول إلى تلك الصيغة التي عملت بها الهند في العديد من مدنها وقراها، وخطت إيرلندا فيها بصورة مميزة، لا بد من بسط كل المقومات الموجودة -حالياً- والعمل عبر استراتيجية مُحكمة وشفافة وبعيدة المدى لوصول إلى ذلك المستوى من الإنتاج والتوسع الأفقي في الاقتصاد، وهو الذي يولد الإبداع والمنافسة. كون الجمهور له أذواق مختلفة ومتطلبات عديدة يسعى كل فرد فيه لإضفاء خصوصية على ذاته من خلال الملبس والمأكل والمسكن والمركب -السيارة-، وبالتالي تتحول تلك الفردية إلى دافع للإبداع والتنافسية.
فمن هم اللاعبين الذي ينتظر منهم الجمهور “المجتمع” تقديم مباراة “أنموذج لاقتصاد محلي” على ملعبهم “البحرين”؟
في الهجوم والوسط
الأفراد المستثمرين وأصحاب المشاريع والأفكار.
فعلى الأفراد أن يتمتعوا بالصبر والتخطيط الجيد واللياقة والاستعانة بأكبر قدر ممكن من الموارد الموجودة داخل وخارج البحرين وبطرق مختلفة، والأهم هو حماسة اللاعب وتفانيه في اللعب -التخطيط والعمل الجاد ومواجهة الصعوبات-، فالطريق ليس مفروشاً بالحرير.
فبالتالي تكون المبادرة ضرورية من قبل الفرد لشق طريقه نحو الاستقلالية وتوفير مصدر دخل إضافي أو أساسي، فضلاً عن تحقيق لطموحاته وما يتطلع إليه.
في الدفاع وحراسة المرمى
القطاع الخاص بمؤسساته وتجاره ومستثمريه الذين يحملون على عاتقهم إنعاش الاقتصاد المحلي عبر دعمهم بطرقهم المختلفة.
فعندما تتوسع مساحة المشاريع المحلية الصغيرة فستعود فائدتها من سيولة مالية إلى الدخل الوطني، فضلاً عن كون إنتعاش تلك المشاريع مدعاة للتنافسية والإبداع والذي سيهب كل مشروع خصوصيته الفردية ويسعى لتأصيلها وتسويقها وتعزيزها يوماً بعد يوم، حتى تتحول إلى ماركة تجارية، والوصول إلى تلك المرحلة سيعزز القطاع الخاص من خلال وجود قاعدة عريضة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الجسم الأكبر في القطاع لخاص لأي دولة تسعى للإعتماد على مواطنيها عملاً وإبداعاً.
في طاقم التدريب
الجهات الحكومية الداعمة (تمكين، بنك البحرين للتنمية، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة الشئون الاجتماعية)
يبدو أن طاقة التدريب بدء بالتحرك الفعلي والملموس من خلال العديد من المبادرات التي دشنتها أكثر من جهة، والأبرز على الساحة من خلال التعاطي المباشر مع المواطنين هي تمكين “صندوق العمل سابقاً”، وبنك البحرين للتنمية، وعبر رؤية رسمها مجلس التنمية الاقتصادية. والتي تحتاج إلى ملامسة أقرب للمواطن في جوانب حياته الاقتصادية بصورة مباشرة.
فالمشاريع المتنوعة والتي تقدمها “تمكين” على سبيل المثال لا الحصر تمثل حراكاً يصب في إنعاش وتنمية القطاع الخاص، والتي تمد الأكسجين للطبقة المتوسطة في المجتمع بطريقة أو بأخرى، وهو ما يحفظ التوازن الاجتماعي من جهة، ويحرك ماكينة الاقتصاد من داخل المجتمع، عوضاً عن الاعتماد على الماكينة الحكومية الصرفة فقط.
وما يزعج الناظر المنصف هي تلك الخلفية الذهنية لدى البعض إزاء ما هو حكومي، حتى أصبح كل ما يأتي من الحكومة سلبياً، في قبال “تعميم” غير منصف في بعض الأطراف الحكومية تجاه الأفراد.
وهو ما يخلق فجوة تكبر أو تصغر اعتماداً على الآليات التي يتخذها الطرف المبادر -وهو الطرف الحكومي- لتقليل تلك الفجوة.
لذا على اللاعبين استغلال كل من الجمهور والأرض بالإضافة إلى الاعتماد على قدراتهم الذاتية، وتحضرني هنا قصتي نجاح، أولاهما لأحد الأخوة من بني جمرة والذي استفاد من تمكين في تطوير أعماله وتوسعتها، والآخر من النبيه صالح ممن أعتمد على نفسه وبدء بافتتاح استديو إنتاج عبر قرض بسيط وبدأ مشوار النجاح بتميز.
والمهمة كما هي صعبة على طاقم التدريب إلا أن كل اللاعبين يتحملون جزءً من اللوم إن أخفقوا أو تكاسلوا، وينسحب اللوم على الجمهور أيضاً في حال توقفه عن تشجيع اللاعبين، ويتمثل التشجيع في دعم ومساندة تلك المشاريع الفردية والمحافظة لها، لأنها في الأخير تحافظ على حلقة الأموال التي ستكون في مدار المجتمع ولن تخرج عنه، ونتيجة لتواجد تلك الأموال ضمن دائرة المجتمع الواحد، سيكون مجال الإبداع أكبر لوفرة الأموال وتشجيع أفراد المجتمع، وهم الذي يمثلون بداية الحلقة ونهايتها، في حين يكون السيناريو الآخر ل”راجو” و”وكومار” حيث لا تكتمل الحلقة بل تصبح خطاً مستقيماً من جيب المواطن إلى مكاتب تحويل الأموال لبدان أخرى، وبالتالي تنقطع الصلة وتتيبس حقول الإنتاج المحلي وتتوقف عجلة الإبداع إلا من رحم ربك.
فإن كان الجمهور معنا والأرض لنا، فما ينقصنا سوى طاقم تدريب جيد ولاعبين يتمتعون بالحماسة والرغبة في اللعب.
نحترم كل جنسية ووافد، وورود الأسماء لتوصيف الواقع لا أكثر.
* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.