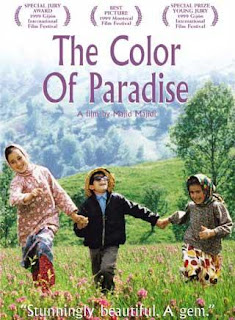http://www.altijaria.net/
جعفر حمزة*
استقبلته بعد يوم عمل شاق، وكان يتمنى أن يرى غير الذي لاقته به، فبدلاً من الملابس التي يحبها، رآها وهي في نفس الملابس التي تطبخ بها، وبدلاً من العطر الذي يميل إليه ويحبه، شم منها رائحة الطبخ وكل البهارات। وإن كان يحبها، إلا أن تلك الصور للبصر والأنف تُحدث فرقاً في العلاقة، وبالرغم من أن تلك الصور أساسية في العلاقة الزوجية، إلا أن الكثير من النساء يهملنها। وكلها تراكمات ووقت قصير، لتحدث الطفرة والنفرة في العلاقة بين الزوجين.
وهذا الأمر ليس ببعيد عن علاقة قد تكون أكثر قرباً في المكان والزمان والالتصاق، وهي العلاقة بين الفرد والماركة التجارية، حيث يعيش الفرد معها أكثر من عيشه مع زوجته أو أحد آخر قريب منه، فهي -أي الماركة- جزء منه في كل شيء، من ملابسه الظاهرة والباطنة، ومن أذنه الثانية “الهاتف النقال” إلى رجله الثانية “السيار”، ومن مشروب لا لارتواء أكثر منه امتعاء إلى الآيس كريم الذي قد يتناوله تلذذاً لا جوعاً.
وتجهد الكثير من الدراسات لكبرى شركات الأبحاث والمصانع ووكالات الإعلان العالمية على توطيد العلاقة بين الفرد والماركة، لا ليكون لها حضورٌ فاعل فحسب، بل حضور لا ينفك عن وجود الإنسان وحركته اليومية من السرير إلى السرير، أي منذ نهوضه في الصباح حتى خلوده إلى النوم مجدداً।
وتتمثل تلك الدراسات والبحوث في خلق تلك العلاقة الوطيدة ودعمها بالاختبارات وجس النبض في أكثر من زاوية للمنتج أو الخدمة، لتتحول تلك الماركة من مجرد شيء يُعرض في الرف، إلى جزء من شخصية الفرد لها “رفها” الخاص في عقله ومزاجه وذوقه وميوله، وبالتالي تتحول الماركة إلى “وقود” لا يمكن الاستغناء عنه ليُرضي لفرد عبرها شخصيته المتكونة والمتشكلة عبر الكثير من الأدوات المحيطة، من الفضائيات إلى الإنترنت، إلى الكلام المحكي والأفكار التي تسير معه يومياً.
والماركة مثل الزوجة للفرد، فكلما زاد فهم الزوجة لما يحبه الزوج ويرتاح إليه دامت العلاقة بينهما، عبر التفاهم والاتساق فيما بينهما، وكلما فهمت الماركة التجارية ما يميل إليه الفرد كلما تعزز وجودها في ذهنه، وبالتالي في سلوكه، لتصبح جزء من كلامه وشخصيته، ولا يحيد عنها ما دامت “متفهمة” “ذكية” و”جميلة” في نظره।
ومع ذلك يقولون أن “عين الرجل زايغة”، أي أنه لا يقتنع بما عنده، ويطمح لما ليس بين يديه، ومن هذا المدخل، تقوم الماركات المنافسة بلعب دور “الزوجة الأفضل”، فتقوم بالتزيين ووضع العطر الجذاب، والحديث بكلام جميل، لتستميل قلب “الزوج” إليها، وتتحول إثر “التكرار” الذكي إلى “ضرة” للزوجة الأولى، أقصد الماركة الأولى، وللشكل عبر الهوية أهمية كبيرة في رسم العلاقة بين الفرد والماركة.
في أوائل الثمانينيات، شعرت شركة كوكا كولا بتوتر شديد بشأن مستقبلها। فقد كانت هذه الشركة تهيمن ذات يوم على سوق المرطبات في العالم دون منازع। لكن أخذت بيبسي تقلص بانتظام الفارق بينهما وبين كوكاكولا। بالرغم من أن كوكا كولا أوسع انتشاراً وتنفق ١٠٠ مليون دولار على الأقل في السنة على الإعلان। وقد وصلت حدة المنافسة بين بيبسي وكوكا كولا فما سُمي بتحدي بيبسي إلى درجة الاستعانة بنتائج مختبرية للذواقة، مما جعل كوكا كولا، تعيش هاجساً انصب أكثر فيما تعنيه التركيبة الكيميائية التي تعطي المذاق المميز لها। تلك الاختبارات التي نجحت فيها “بيبسي” وانهزمت في قبالها كوكا كولا، وبالرغم من سعي الأخيرة لتبديل ملابسها عبر منتج جديد أسموه الكولا الجديدة، إلا أن النتائج كانت كارثية، وتبين من خلال غضب واحتجاجات حصلت في كل أنحاء الولايات المتحدة। وهذا يبين مدى العلاقة والتي ليس من السهل التهاون بها بين الفرد وزوجته “الماركة”। وقامت الشركة بإعادة الصيغة القديمة للكوكا كولا باسم الكولا الكلاسيكية। وقد لاقت نجاحاً، بل وتفوقاً على بيبسي، مما جعل الصراع على أشده، وما زالت كوكا كولا شركة المرطبات الأولى في العالم। وبعبارة أخرى، تشكل قصة الكولا الجديدة توضيحاً جيداً لمقدار التعقيد الدي يكتنف معرفة ما يفكّر فيه الناس حقاً। (١)
ويبدو أن تلك النتائج المختبرية كانت هي الكارثة في تعزيز العلاقة بين الماركة والمنتج “الكوكا كولا”، حيث أن تلك العلاقة لا تقتصر ولا يمكن حصرها بصورة علمية بحتة، من خلال المذاق فقط، إذ يقول “مالكوم غلادويل” أن مبدأ الاختبار المذاق المعمّى سخيف بأكمله। “حيث تجرى اختبارات لتذوق المنتج مع تصميد عيون الذواقة” لم يكن يجدر بها الاهتمام كثيراً، لأنهم يخسرون في اختبارات المذاق المعماة للكولا القديمة، ويجب أن لا نفاجأ بأنّ هيمنة بيبسي عى اختبارات المذاق المعماة لمم تُترجم كثيراً في العالم الحقيقي। لم لا؟ لأنه ما من أحد يشرب كوكا كولا مغمض العينين في العالم الحقيقي. ويضيف “غلادويل” القول: أننا ننقل أحاسيسنا بمذاق الكوكا كولا كل الارتباطات اللاواعية التي لدينا عن العلامات التجارية، والصورة والعلبة، وحتى اللون الأحمر الذي لا تخطئه العين في الشعار.(٢)
وهناك تجربة أخرى يمكن الإشارة إليها هنا فيما يتعلق بتجديد العلاقة أو توطيدها بين الفرد والماركة التجارية. “لواحد مش لاثنين” كان “الفستان” الجديد للمنتج “تويكس”، ففي السابق، كانت الرسالة في أن يكون اصبع من التويكس لك والآخر لصديقك أو صديقتك، أما الآن فقد تغيرت الرسالة، وأصبح من الضروري تقديم صورة جديدة للمنتج، بالرغم من بقاء التركيبة الغذائية للمنتج، وذلك لإنعاش ومنح “قوة حب وعلاقة” جديدة لتويكس، لتصبح الرسالة الجديد الآن، أن كلا الإصبعين من الشركلاته لك وحدك-تعزيز للفردية والأنانية-، لتقول “لواحد مش لاثنين”، بعد أن كانت “ليس قطعة وإنما قطعتان”! حالها -تويكس- كما يعمل العاشق، عندما يهدي حبيبته في كل مرة شيء مختلف، وعندما تغير في كل مناسبة ملابسها، وتنتعش العلاقة من جديد في كل لقاء بينهما، وهكذا.
إن الإنسان يميل إلى التجديد، وينجذب نحو الماركة التي تؤصل فيه حب نفسه من كل زاوية، والقيم التي يتم تقديمها عبر منتجات غذائية -على سبيل المثال- ما هي سوى ربط بين المنتج والقيم التي يحبها الإنسان لنفسه. وتمثل الماركات العربية “الزوجة المنافسة” للزوجات الأجنبيات، أقصد الماركات الأجنبية، فهي أي الماركات العربية لها أفضلية الأرض والجمهور، و”أهل البيت أدرى بما فيه”. ومجال المنافسة مفتوح على مصراعيه من المنتجات الغذائية إلى التنظيفات، وبالرغم من الغياب أو القصور في حقول مختلفة من المنتجات كالإلكترونيات، إلا أن مساحة التصنيع العربية الموجودة ليست بالصغيرة، وعليها أن تتحول من الزوجة التي تتشبع ثيابها برائحة المطبخ والغسيل، بالرغم من طيبتها وعملها الدؤوب، إلى الزوجة التي تستقبل زوجها برائحة العطر الذي يحبه، وبضربات مكياج خفيف يميل إليه، وهكذا تستمر جمرة الود بينهما متقدة.
إن عملية “الود” بين الفرد والماركة تتمثل عبر ثلاث مراحل، الأولى هي المنتج نفسه بجودته ومنافسته في أصل تصنيعه، الثاني في شكله وتغليفه، والثالث في ترويجه وصورته المقدمة للفرد. وتلك الثلاثية لم تُتقنها كل الماركات العربية، والمشوار يمكن اختصاره لتكون العلاقة بين الفرد والمنتج العربي دافئة ومتينة، ويمكن أن تكون-في حال إهمال استخدام العطر المناسب والملابس الجميلة والكلمة الشاعرية- إلى الانفصال والطلاق. وما تزال الماركات العربية بحاجة إلى هضم العلاقة ومعرفة سر قوة وجودها في سلوكيات الفرد، عوضاً عن استنساخ “الزوجات الأجنبيات” في شكلها وعطرها ومكياجها، لتكون “الزوجة-الماركة” العربية لها خاصيتها وجاذبيتها.
لكي لا يكون حالها كحال الغراب الذي حاول تقليد مشية الطاووس، فلم يستطع تقليد الطاووس في مشيته، ونسى مشيته هو، فأصبح بين هذا وذاك فاقد الهوية منسي الذكر. فهل تضع الماركات-الزوجات- العطر الخطأ وترتدي الفستان القديم؟ ليكون بعدها العجب مفقوداً عندما يتزوج- يتعامل الفرد مع الماركات -الزوجات-الأجنبيات؟
مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.
(١) التفكير اللمّاح في طرفة عين. مالكوم غلادويل.
|
|
|




 بدأ في الآونة الأخيرة انتشار متصاعد في العالم العربي لما يعرف بالمدونات، وذلك بعد أن شاعت في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في أوساط الشباب الذين باتوا يتنافسون ويتفاعلون مع نظرائهم على الأرض من خلال هذه الوسيلة حيث يعرفون باسم (بلوغرز)، وتعني باللغة الانجليزية (لوغ)، وهو السجل الذي تدون فيه الأشياء بالتسلسل، و(بيوغرافي) أي يعني كتابة المذكرات الشخصية. وباختصار تعني الكلمة تدوينا إلكترونيا عبر صفحات الانترنت للمذكرات الشخصية.هذه الظاهرة وجدت مكانها بين الشباب البحريني، وبين بعض المشاهير في المجالات المختلفة،
بدأ في الآونة الأخيرة انتشار متصاعد في العالم العربي لما يعرف بالمدونات، وذلك بعد أن شاعت في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في أوساط الشباب الذين باتوا يتنافسون ويتفاعلون مع نظرائهم على الأرض من خلال هذه الوسيلة حيث يعرفون باسم (بلوغرز)، وتعني باللغة الانجليزية (لوغ)، وهو السجل الذي تدون فيه الأشياء بالتسلسل، و(بيوغرافي) أي يعني كتابة المذكرات الشخصية. وباختصار تعني الكلمة تدوينا إلكترونيا عبر صفحات الانترنت للمذكرات الشخصية.هذه الظاهرة وجدت مكانها بين الشباب البحريني، وبين بعض المشاهير في المجالات المختلفة،  مشاركنا الأول هو احمد رضي صاحب قلم واضح في التعبير الذي اتخذ المدونة لتوثيق الأعمال الفكرية والأدبية، حتى انتقلت مع أمواج التيار المختلفة لتطرح العديد من الموضوعات الاخرى، ويفتح صاحبها أحمد رضي المجال لكل الزوار بطرح آرائهم بكل حرية وشفافية من باب الحرص على التعرف على الرأي والرأي الآخر والذي يقول عن دافعه لإنشاء المدونة الشخصية: هو الرغبة في تسجيل وتوثيق الأعمال الفكرية والأدبية ونشر المقالات المتنوعة المنشورة هنا وهناك، والطابع العام للمدونة هو اجتماعي وسياسي وثقافي في نفس الوقت، ويميل إلى كشف الحقائق وطرح الملفات الساخنة ومناقشة القضايا المتعلقة بالحركة الإسلامية في البحرين بعين الناقد والباحث عن المعرفة.
مشاركنا الأول هو احمد رضي صاحب قلم واضح في التعبير الذي اتخذ المدونة لتوثيق الأعمال الفكرية والأدبية، حتى انتقلت مع أمواج التيار المختلفة لتطرح العديد من الموضوعات الاخرى، ويفتح صاحبها أحمد رضي المجال لكل الزوار بطرح آرائهم بكل حرية وشفافية من باب الحرص على التعرف على الرأي والرأي الآخر والذي يقول عن دافعه لإنشاء المدونة الشخصية: هو الرغبة في تسجيل وتوثيق الأعمال الفكرية والأدبية ونشر المقالات المتنوعة المنشورة هنا وهناك، والطابع العام للمدونة هو اجتماعي وسياسي وثقافي في نفس الوقت، ويميل إلى كشف الحقائق وطرح الملفات الساخنة ومناقشة القضايا المتعلقة بالحركة الإسلامية في البحرين بعين الناقد والباحث عن المعرفة.  وأيا كانت دوافع وأسباب التدوين فالدافع المشترك لدى جميع المدونين هو التعبير عن الذات، المدونات أتاحت للجميع الفرصة لإنشاء عالمهم الخاص والتنفيس عن همومهم وأفكارهم ومشاركة الآخرين آراءهم وإبداعاتهم خارج نطاق الحدود الجغرافية. هي نوع من أنواع الكتابة مع فارق أنها أقرب للكتابة التفاعلية منها للمقروءة، فما تكتبه اليوم وأنت تقبع خلف شاشة جهاز الحاسوب في منزلك أو في اي مكان آخر يصل بكبسة زر إلى شتى أنحاء العالم وقد يجد صدى للآخرين فتصل إليك تعليقات من بلدان بعيدة ونائية لم تكن لتصل إليها من خلال أي مطبوعة.
وأيا كانت دوافع وأسباب التدوين فالدافع المشترك لدى جميع المدونين هو التعبير عن الذات، المدونات أتاحت للجميع الفرصة لإنشاء عالمهم الخاص والتنفيس عن همومهم وأفكارهم ومشاركة الآخرين آراءهم وإبداعاتهم خارج نطاق الحدود الجغرافية. هي نوع من أنواع الكتابة مع فارق أنها أقرب للكتابة التفاعلية منها للمقروءة، فما تكتبه اليوم وأنت تقبع خلف شاشة جهاز الحاسوب في منزلك أو في اي مكان آخر يصل بكبسة زر إلى شتى أنحاء العالم وقد يجد صدى للآخرين فتصل إليك تعليقات من بلدان بعيدة ونائية لم تكن لتصل إليها من خلال أي مطبوعة.