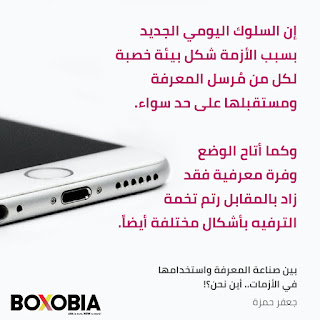المعرفة لم تعد وقفاً لأحد بعد الآن، فما تود أن تعرف أصبح مشاعاً من خلال منصات مشتركة يكون صانعوا المحتوى فيها روّادها، كموقع ويكيبيديا والذي لا يرتضي لنفسه أن يكون تجاريًا، فلا غرو أن لا يوجد به إعلان واحد حتى هذه اللحظة، ولو أراد لظفر!
وأصبحت منصات التعليم تتكاثر حتى تحتار فيما تختار، بدء من خان أكاديمي مروراً ب
Udemy
و
Masterclass
والقائمة تتوسّع، ولئن كان الحضور العربي ضعيفاً ولا جديد في ذلك.
فما دامت مثل هذه المعرفة متوافرة وعلى يد مختصين، وبين المجان وأسعار زهيدة جداً. فلا بد من مراجعة صريحة لأنظمة التعليم الجامعي عندنا.
هذا التدفق المعرفي المركّز، والذي يمنح الكثير منها شهادات احترافية، وبعضها من جهات أو جامعات لها وزنها الأكاديمي، إذ يشكل تحدياً حقيقيًاً لمنظومة التعليم الجامعي الكلاسيكي المبني على هيكلية لا تتسم بالديناميكية والحيوية اللازمة.
ودليل ما نقول، قياس مخرجات الطلبة من جامعاتنا.
هي واحدة من إثنتين، إما خلل في سياسات سوق العمل، أو ضعف في المناهج التعليمية، وإلا ما كان عندنا ما يسمونه “فجوة المهارات”
Skills Gap.

ولو نحسبها بالأرقام، لكان خيار المنصات الرقمية متفوقة على نمط الجامعات الحالي بلحاظ التنوع المعرفي والتحديث الدائم والتركيز على المعلومة المقدمة لتكون عملية وفاعلة، فضلاً عن ميزات المرونة والوقت.
وقد ساهمت الجائحة في الدفع للنظر بجدية أكثر لأنظمة التعليم لدينا.
يمكن لكل جامعة إعادة حساباتها بالاستثمار أكثر في التعليم الرقمي التفاعلي، بتوفير المواد المستحدثة مع المتغيرات واستخدام منصات تفاعلية، مع الإمكانية الهائلة في تزويد الطلبة بالمتخصصين في مختلف المواد الأكاديمية والعلمية، وبتكلفة أقل بكثير مما هي عليه الآن، بلحاظ إسقاط مصاريف السكن والتذاكر والمعيشة بشكل عام، إن كان الأمر معتمداً على التعليم الرقمي عن بعد.
ومن جانب الطلبة هناك ما يمكنني أسميه أسلوب مراحل اللعبة، فعندما تنتهي من مرحلة في لعبة معينة يمكنك المضي قدماً للدخول في مرحلة ثانية وهكذا، اعتماداً على مهاراتك ليس إلا.
فلنتخيل السيناريو المبتكر التالي:
كل شخص يمكنه الدراسة في الجامعة الرقمية، سواء لخريج المرحلة الثانوية أو حتى موظف أو باحث عن عمل أو ربة منزل.
هناك مواد أساسية يتم تقديمها مجاناً بلا مقابل، ومن يمكنه تخطي المستويات المقدمة يظفر بفرصة الترقي في المستوى للحصول على شهادة بمستوى أرفع وهكذا.
بمعنى آخر هناك شهادة أساسية يمكن لربة البيت كما للطالب أن يأخذاها، ومن يمكنه تجاوز اختبار كل مستوى يمكنه التقدم لمستويات أرفع.
كل المستويات تكون بأسعار رمزية، وفي متناول الفقير والغني على حد سواء.
إن هدف الجامعات تخريج عقول ديناميكية مبتكرة، ولا يكون ذلك إذا كانت العقلية السائدة، هو تحويل الجامعات لأنموذج البقرة الحلوب في استحصال الرسوم من الطلبة من جانب، وأنموذج الضرع الجاف عندما يدخلون سوق العمل.
إن العقول المبدعة وذات المنهجية الفكرية المميزة تكون بيئتها الجامعات، لتبتكر وتنتح وتقود.
إن المنصات الموفرة للمعرفة تتكاثر وتتنوع، فهل جامعاتنا لها القدرة على ضبط نموذج الأعمال لديها؟
لتكون متماشية مع المتغيرات المتسارعة ومع وفرة منصات المعرفة، ومن يظفر بالمعرفة من منصات ومصادر رقيمة أخرى، وتقبله غوغل وغيرها، فإن الأفق مفتوح، ولن يكون بعد اليوم في نطاق جغرافي محصور، وإسقاطات ذلك كبيرة إذا ما كانت العقول البحرينية الشابة القادمة معتمدة على الرقمنة التعليمية وتعمل لشركات أجنبية وهي لم تغادر حتى عتبة بيتها، وهنا كمية هدر وطنية، لن ندرك تبعاتها إلا بعد فوات الأوان.

ومع استمرار الوضع الحالي، لن تكون الجامعات سوى قطار يعمل بالفحم، قبال القطار الرقمي “المنصات المزودة للمعرفة والشهادات الاحترافية”والذي يشبه قطار الرصاصة الذي يبلغ سرعته 350 كلم/الساعة!
فهل يستمر هذا الهدر في المال والوقت والجهد بمنهجية تقليدية عفا عليها الزمن السريع أو يتم التوجيه لتحوير نموذج العمل للجامعات للتوجه للرقمنة بشكل أكثر مرونة وذكاء وتنوع وتخصص وتوسّع، لبناء مجتمع متعلم مرقمن منتج؟
والأغرب أن القائمين على الجامعة يعيشون سرعة المعرفة في هواتفهم لكن الزمن يتوقف عند بيئة أعمالهم!
كأننا نعيش فعلاً شيزوفرينيا برضاً وتسليم!
…
هنا بعض التصورات والتي يمكن أن تكون ممكنة أو على الأقل تستحق التأمل ودراستها في مجال المعرفة الجامعية
ما هو الفصل الأبيض
White Chapter
مقترح تم تقديمه لكل من جامعة البحرين وجامعة البوليتكنيك في المواد التسويقية والإعلام، ويتلخص بإفراد فصل في المنهج الدراسي، تتم كتابته من قبل الطلبة!
نعم الطلبة، كون وتيرة التطورات في كثير من المجالات تتسارع، ولا يمكن للنسخ المطبوعة أن تتماشى مع المتغيرات ولن يمكنها. فالحل أن نفرد مساحة للطلبة، وهم أسرع تلقياً للتغيرات في العالم الرقمي من أساتذتهم، بلحاظ سلوكياتهم اليومية، إن لم تكن جزء من هويتهم حتى. ويكون الرهان على أن يتم مقايضة المعرفة من الطلبة المقدمة لهذا الفصل الأبيض بمقابل درجات جامعية
Credits
وهكذا يكون لدينا محتوى مكون من شقين، ثابت ومتحرك: الثابت من الجانب النظري، والعملي والذي يساهم فيه الطلبة بتجاربهم ورؤاهم.
Certificate Knowledge Based
الشهادة على حسب المعرفة
ما المانع من تقديم شهادة أكاديمية لمن يمكنه خوض امتحان اجتيازها؟ ولم شرط أن يأخذ كل المواد إن كانت له المعرفة بها؟ ما دام الهدف هو استحصاله للمعرفة، النظرية منها والعملية.