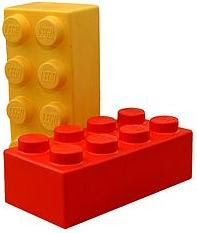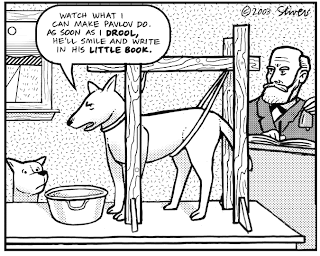|
يهدف مشروع “مهرجان عاشوراء السينمائي” إلى تقديم صور متعددة ومن زوايا مختلفة ترصدها عيون صانعو الأفلام والمهتمين بالسينما لكربلاء كقضية ولمحرم كذكرى وممارسة وتفاعل، وذلك بطرق مختلفة، سواء من الناحية التاريخية أو التوثيقية التسجيلية أو غيرها من الطرق، وبالتالي يكون استعراض واقعة كربلاء وشهر محرم من عدسة الكاميرا التي ترصد المشاعر والمواقف وتستخلص العبر وتوثق الفكرة ورصد الزوايا المختلفة في الشعائر الحسينية.
|
الرئيسية
-
مهرجان عاشوراء السينمائي
-
LEGO
جعفر حمزةالتجارية، ٢٠ فبراير ٢٠٠٨
كانت لديهما نفس اللعبة، ولم يُطلب منهما شيء، فليس هناك داعٍ لذلك، فقد أخذ كل منهما لعبة تركيب قطع الــ ”LEGO” المعروفة، ولم تكن تلك نهاية الحكاية بل بدايتها، فكانت القطع تتناثر يمنة ويسرة بين يدي الأول دون أن يركّب ولو شيء بسيط، في حين كانت تتكاتف في يد الآخر لتمثل مجسمات وأشكالاً جميلة . تلك هي صورة لعب طفلين بتلك القطع التي تهدف إلى تعزيز القدرة الذهنية في التركيب لدى الطفل، وبالتالي تعزيز النمو الإدراكي والمخيلة. لستُ بصدد تفسير نفسي أو تربوي لذلك المشهد، إلا أن ما شدني في ذك المشهد هو تطابق واقعي لصورة أكبر تشهدها الساحة العلمية وتأثيراتها الاقتصادية والمعيشية في البلاد العربية، ولنكون أكثر دقة، فالحديث يدور هنا حول المشهد المحلي وغياب القدرة الإدراكية في تعزيز النفََس العلمي والإنتاج الذاتي والابتكار، ويبدو أن الصورة الحالية تميل إلى ذلك الطفل الذي يرمي القطع “الموارد البشرية والمادية” دون تكوين حقيقي لشكل أو مجسم معين “إنتاج واعتماد على الذات”. والحديث مع الطفل بإمكانية استخدام ما بين يديه في تكوين ما هو مفيد لن يكون مجدياً ما لم نقدّم له مثالاً حياً لنفس تلك القطع وبطفل في نفس عمر على الأقل، ليقتنع بأن ما نطرح عليه ليس تنظيراً أو حديثاً في الفضاء بل بالإمكان القيام به. وتمثل التجربة الإيرانية في التقدم العلمي والصناعي وفي مجال البحوث الأكاديمية حجة مضاعفة للقراءة المتأنية لغياب الاستفادة المثلى من قطع الــ “LEGO ” التي بين يدينا على الساحة المحلية، حيث بتنا نضع تلك القطع في أفواهنا أو نحطمها وفي أحسن الأحوال نرميها جانباً بدلاً من وضعها في مكانها الصحيح والخروج بشكل أو مجسم مفيد. لقد وضعنا مواردنا المعرفية والمالية في مكان لا تنتمي إليه. فبتنا نرسم الترف الفكري بأموال أرضنا، ونقذف بالكوادر خارجاً عنّا. إننا نقرأ بين ضفتين، ضفة انغمست حتـى النخاع ولعبت حتى القاع في تلك القطع دون فائدة وبددت كوادرها وطاقتها، وضفة أخرى جارة لنا على الأقل جغرافياً اهتمت في تعمير العقول وصقلها، لأن لديها تحدٍ وحافز “Challenge & Motivator”، وبغض النظر عن طبيعة ذلك الحافز، فإن إيران باتت مجتمعاً منتجاً لا مستهلكاً ومعتمداً على نفسه لا على غيره، بالرغم من كل الظروف المحيطة به. ونحن أولى أن نكون أفضل من ذلك، فقطع اللعب التي لدينا أكثر وحجمها أكبر ومساحة تنفيذ ما يمكننا العمل به أوسع، إلا أن هناك عقليات تميل إلى ترف فكري يقلل ما لدينا من كوادر، ويحجّم مساحة البحث والإنتاج الذاتي، فقد باتت مسابقات الخيول والسيارات وشعر اللاشعر حاضرة وتغيب مسابقات الرياضيات والعلوم، ومنافسات الابتكار والاختراع، لا لشيء سوى أن قطع التركيب للمستقبل ليست بذات أهمية، وبعيداً عن التنظير أسرد لكم ما في الضفة الأخرى (إيران) من إنجازات في المجال الطبي في غضون سنوات قليلة فقط، وإليكم القائمة: إنتاج علاج لمرضى تقرحات القدم السكري، إمتلاك أكثر تقنية متطورة لطب العيون في العالم، إنتاج عقار لمعالجة الجلطة القلبية، إنتاج قصبة صناعية للرئة، إنتشار صناعة العظام في إيران، المرتبة الرابعة في زارعة الكلية في العالم، إنتاج أقوى لاصق ذكي للأنسجة، تشخيص الهوية بواسطة قزحية العين، التوصل لطريقة جديدة لمعالجة سرطان الثدي (١). هذا فضلاً عن الأبحاث العلمية والصناعية الأخرى في مجال الروبوت والكيماويات، وتميز لافت في المسابقات الدولية للرياضيات والفيزياء. لقد بات العالم في صراع علمي وتقني ومعرفي لا مجال للتوقف أو الإبطاء أو التغنّي بشعر نبطي هنا أو هنا، نحن في صراع مع الزمن وصراع مع أنفسنا في كيفية التوظيف الأمثل للموارد البشرية التي بين أيدينا، بتنا في عالم معرفي لا يعرف إلا لغة العلم والمعرفة والتطور التقني، وأين نحن من كل ذلك؟ وما تقديم إيران كمثال إلا لإسقاط حجة أن المعرفة والتقنية ليست محصورة في العالم المتقدم فقط، فإيران وماليزيا أوضح مثالين على الإرادة المخططة للإعتماد على الذات، مثالين من بلدين مسلمين أحدهما في الضفة الأخرى من الخليج والآخر يبتعد عن تجمع العالم الإسلامي الجغرافي آلاف الأميال، فلا حجة عندئذ لمن لا يعرف تركيب القطع والبدء بالإنتاج! وعوداً إلى الطفل صاحب الترف البصري، والذي لا يقدر قيمة ما بين يديه من قطع ”موارد”، فإليكم بعض من قائمة نستطيع تطويرها لنكوّن منها أنموذجاً مُنتجاً لا فاغراً فاه فقط: دعم المبادرات الرسمية والمجتمعية من أجل تطوير سوق العمل المحلي، منها على سبيل المثال مبادرات صندوق العمل. – إنشاء مراكز بحوث أكاديمية وعلمية تبتعد عن الاستنساخ البصري لبرامجها، وتقدّم ما هو ملموس على الساحة المحلية. – تعزيز الإبداع العلمي عبر ضخ ميزانية سنوية للمعاهد والمدارس والمراكز وتقييم مدى إنتاجيتها وتقويمها. -اتباع سياسة التغذية الراجعة الإبداعية، من خلال تخصيص جزء من ميزانيات مشاريع ضخمة للأبحاث والتطوير، مثل مشروع الفورمولا واحد والمشاريع العقارية والسياحية الضخمة في البلد. – التركيز على التعاون العلمي والبحثي في الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها الدولة مع الدول الصديقة والجارة، منها اتفاقية FTA مع أمريكا، ووضع خطة زمنية لتخريج كوادر علمية مؤهلة في المجالات التي بها نقص بالسوق المحلية. – سد “فجوة المهارات Skills Gap” في السوق المحلية، من خلال التنسيق بين الجامعات المحلية ومتطلبات سوق العمل خلال عشر إلى عشرين سنة القادمة. -دعم مبادرات إنشاء المعاهد العلمية والبحثية والمصانع في البلد شريطة وجود أجندة لتدريب الكوادر المحلية وتبؤها لمناصب صنع القرار. – إقامة المعارض العلمية وزيادة عددها في العام، من خلال تبنّي الحكومة لها وتعزيز الاستفادة منها. إعادة النظر في المناهج وبث روح الإبداع والإنتاج فيها، يمكن الرجوع للتقرير الخاص بالتعليم في الدول العربية لنرى حجم القطع المتناثرة في أرضنا العربية. ولن تكفيني مساحة العمود لأسرد كمية القطع التي يمكننا أن نستخدمها في سد فجوة المعرفة لدينا. ولكن هذا غيض من فيض. إن قطع الـLEGO موجودة بين أرض الوطن وابن الوطن، إلا أن ماسك تلك القطع لا يبدو راغباً في تكوين شيء مفيد وذو مردود بعيد المدى، ربما لخوف الطفل من أن تُبث الحياة في تلك القطع وتشكل له مزاحمة في وجوده، حاله مثل “دينكيشوت” الذي تخيل أن طواحين الهواء عمالقة يريد محاربتها.www.arabic.irib.ir(١) -
ضفادع مسلوقة
ضفادع مسلوقة
جعفر حمزةللحصول على ضفادع مسلوقة ذات نكهة خاصة، ينبغي أن تكون الضفادع حية وموضوعة في الإناء لضمان الحصول على طعام مميز وشهي، والأمر ليس بالعسير كما يبدو، فما عليك إلا وضع ضفدع حي في إناء به ماء فاتر، حتى تضمن بقاء الضفدع فيه دون حراك، وبعدها عليك برفع درجة حرار الماء ببطء شديد، وفي النهاية ستحصل على ضفدع مسلوق.
ليست تلك بوصفة لطبق من شرق آسيا أو من بدع طبخات الغرب الغريبة، بل هي وصفة لطبق يتم تقديمه في مجال السياسة والاقتصاد والدين، ويعود الفضل إلى علم النفس والبيولوجيا،
حيث من المعروف ردة فعل الضفادع السريعة إزاء التغيرات المحيطة بها، وفي وصفتنا المقدمة لا يمكن بحال من الأحوال أن نضع الضفدع في ماء حار منذ البداية، فآليات دفاعات جسمه الطبيعية سترسل إشارات سريعة بضرورة القفز من الإناء؛ لأنه يلحظ درجات الحررارة القاتلة فوراً.وسر الطبق هو في عبور دفاعات جسم الدفاعات من خلال رفع درجة الحرار ببطء، بحيث تتقبّل آليات الدفاع لديه الوضع الجديد الصغير وتتكيّف معه، لحين وصول درجة حرارة الماء للغليان، وعندها لن يكون بمقدور الضفدع الهرب ويتحول إلى ضفدع مسلوق!
ولئن كان الضفدع المسلوق ليس شهياً لدى الكثيرين من الناس إلا أنّه يمثل الوجبة المفضلة التي تعدها العديد من الدوائر السياسة والاقتصادية حول العالم من أجل اختراق الدفاعات الطبيعية لدى الفرد من أجل الوصول إلى ضفادع مسلوقة، أقصد أفراداً مبرمجين على الوضع الجديد.
يبدو أن واقع التغيرات المبرمجة في هذه الجزيرة الصغيرة ليست بمنأى عن الوصفة “العالمية”، ولكل طبق نكهته الخاصة حسب البلد والبهارات المطلوبة وطريقة التقديم.تمثّل التغيرات في الملف الاقتصادي على الساحة المحلية درجات الحرارة المتدرجة التي تجتاز “آليات الدفاع الطبيعية” للمواطن، وذلك نتيجة تراكم القرارات والسياسات التي تواصل في “تخدير” المواطن، وبالتالي تعدّى خطوط دفاعاته الأساسية وتنتقل إلى مرحلة متقدمة من التغيرات لتصل إلى مرحلة “السلق”.
ولئن كانت التغيرات أمرٌ لا بد منه والحركة شيء طبيعي ومن “ألف باء” التحولات العالمية، إلا أن السؤال هو في أي اتجاه نتحرّك وأي تغيير نريد؟؟
القرارات المعيشية التي لا تراعي معادلة رياضية بسيطة تتمثل في جمع إيرادات الدولة وقسمتها من أجل وضع معيشي مستقر يتناسب مع دولة نفطية وصاحبة “الثقب الأسود” في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI. تلك القرارات تمثل إنتقالاً لدرجات حرارة مرتفعة بالتدرج، وهكذا تصبح التغيرات المعيشية جزء من حركة تراكمية لا نعي خطواتها المتتابعة؛ لأنها تأتي على فترات متدرجة، لنكون مثل الضفدع الذي يتصور أنه في حمام معدني فاخر في حين أن الغلي والسلق هو ما سيحصل عليه في النهاية.
ومن الملفات التي ترفع درجة الحرارة و”تُبرمج” المواطن ليكون في وضع “لا بد منه” هي الملفات التالية:
-أزمة السكن وشحة الأراضي.
التمييز الوظيفي.
البطالة المقننة.
ارتفاع الكلفة المعيشية.
تدمير البيئة ومصادرة الأراضي.
التجنيس خارج إطار القانون.فضلاً عن ملفات محرمة أخرى لا يجوز الحديث عنها بسبب وجود سياج قانوني يمنع الاقتراب أو تناولها بموضوعية.
كل تلك الملفات التي تعني بالشأن الحقوقي والمعيشي للمواطن باتت “مبرمجة” لدرجة أنه لا يشعر بالتغيرات التدريجية الحاصلة في نمطه المعيشي اليومي.
وتبعات ذلك تتمثل في “إنشغال” المواطن في لقمة العيش وتوفير المستوى المعيشي له ولأهله، في حين تتسابق بقية المجتمعات الجارة والبعيدة في التطوير المعرفي والعلمي والاقتصادي الذي ينعكس على المستوى المعيشي للمواطن.ويتمثّل العلاج في أهمية إدراك التغيرات ولو كانت طفيفة والتعامل معها معالجة لا تسلمياً وتحليلاً لا عرضاً، وتأتي المعالجة من خلال توفير صمامات الأمان ودعمها، والمتمثلة في التالي:
أولاً: مساحة التحرك البرلماني الضامن للحد من ارتفاع درجة حرارة الغليان، عبر تشريع القوانين والحد من حركة التغيرات المتسارعة السلبية.
ثانياً: القيادات الشعبية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تمثل مشاركة فعلية في صياغة ملامح التغيرات في المجتمع.
ثالثاً: الوعي الشعبي بالمتغيرات وضرورة وضع آليات من قبل الجهات الثلاث الأولى بما يتناسب مع درجة التفاعل الشعبي ووضعه.يبدو أن ارتفاع درجات الحرارة المتسارعة أظهرتها مؤسسة «كارنيجي» الأميركية ومؤسسة «فرايد» الإسبانية حول وجود التمييز في البحرين، وهو ما أنكرته بعض الكتل النيابية المنتخبة من الشعب!
ومع ارتفاع درجات الحرارة الحالية في الملفات المعيشية، لا ينفع الضفدع أن يكون الإناء الذي هو فيه مصنوع من ذهب أو فضة، ما دام سيتم سلقه في النهاية.
—
-
ضفادع مسلوقة
ضفادع مسلوقة
جعفر حمزة
التجارية ١٣ فبراير ٢٠٠٨
http://www.altijaria.net/للحصول على ضفادع مسلوقة ذات نكهة خاصة، ينبغي أن تكون الضفادع حية وموضوعة في الإناء لضمان الحصول على طعام مميز وشهي، والأمر ليس بالعسير كما يبدو، فما عليك إلا وضع ضفدع حي في إناء به ماء فاتر، حتى تضمن بقاء الضفدع فيه دون حراك، وبعدها عليك برفع درجة حرار الماء ببطء شديد، وفي النهاية ستحصل على ضفدع مسلوق.
ليست تلك بوصفة لطبق من شرق آسيا أو من بدع طبخات الغرب الغريبة، بل هي وصفة لطبق يتم تقديمه في مجال السياسة والاقتصاد والدين، ويعود الفضل إلى علم النفس والبيولوجيا،
حيث من المعروف ردة فعل الضفادع السريعة إزاء التغيرات المحيطة بها، وفي وصفتنا المقدمة لا يمكن بحال من الأحوال أن نضع الضفدع في ماء حار منذ البداية، فآليات دفاعات جسمه الطبيعية سترسل إشارات سريعة بضرورة القفز من الإناء؛ لأنه يلحظ درجات الحررارة القاتلة فوراً.وسر الطبق هو في عبور دفاعات جسم الدفاعات من خلال رفع درجة الحرار ببطء، بحيث تتقبّل آليات الدفاع لديه الوضع الجديد الصغير وتتكيّف معه، لحين وصول درجة حرارة الماء للغليان، وعندها لن يكون بمقدور الضفدع الهرب ويتحول إلى ضفدع مسلوق!
ولئن كان الضفدع المسلوق ليس شهياً لدى الكثيرين من الناس إلا أنّه يمثل الوجبة المفضلة التي تعدها العديد من الدوائر السياسة والاقتصادية حول العالم من أجل اختراق الدفاعات الطبيعية لدى الفرد من أجل الوصول إلى ضفادع مسلوقة، أقصد أفراداً مبرمجين على الوضع الجديد.
يبدو أن واقع التغيرات المبرمجة في هذه الجزيرة الصغيرة ليست بمنأى عن الوصفة “العالمية”، ولكل طبق نكهته الخاصة حسب البلد والبهارات المطلوبة وطريقة التقديم.تمثّل التغيرات في الملف الاقتصادي على الساحة المحلية درجات الحرارة المتدرجة التي تجتاز “آليات الدفاع الطبيعية” للمواطن، وذلك نتيجة تراكم القرارات والسياسات التي تواصل في “تخدير” المواطن، وبالتالي تعدّى خطوط دفاعاته الأساسية وتنتقل إلى مرحلة متقدمة من التغيرات لتصل إلى مرحلة “السلق”.
ولئن كانت التغيرات أمرٌ لا بد منه والحركة شيء طبيعي ومن “ألف باء” التحولات العالمية، إلا أن السؤال هو في أي اتجاه نتحرّك وأي تغيير نريد؟؟
القرارات المعيشية التي لا تراعي معادلة رياضية بسيطة تتمثل في جمع إيرادات الدولة وقسمتها من أجل وضع معيشي مستقر يتناسب مع دولة نفطية وصاحبة “الثقب الأسود” في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI. تلك القرارات تمثل إنتقالاً لدرجات حرارة مرتفعة بالتدرج، وهكذا تصبح التغيرات المعيشية جزء من حركة تراكمية لا نعي خطواتها المتتابعة؛ لأنها تأتي على فترات متدرجة، لنكون مثل الضفدع الذي يتصور أنه في حمام معدني فاخر في حين أن الغلي والسلق هو ما سيحصل عليه في النهاية.
ومن الملفات التي ترفع درجة الحرارة و”تُبرمج” المواطن ليكون في وضع “لا بد منه” هي الملفات التالية:
-أزمة السكن وشحة الأراضي.
التمييز الوظيفي.
البطالة المقننة.
ارتفاع الكلفة المعيشية.
تدمير البيئة ومصادرة الأراضي.
التجنيس خارج إطار القانون.فضلاً عن ملفات محرمة أخرى لا يجوز الحديث عنها بسبب وجود سياج قانوني يمنع الاقتراب أو تناولها بموضوعية.
كل تلك الملفات التي تعني بالشأن الحقوقي والمعيشي للمواطن باتت “مبرمجة” لدرجة أنه لا يشعر بالتغيرات التدريجية الحاصلة في نمطه المعيشي اليومي.
وتبعات ذلك تتمثل في “إنشغال” المواطن في لقمة العيش وتوفير المستوى المعيشي له ولأهله، في حين تتسابق بقية المجتمعات الجارة والبعيدة في التطوير المعرفي والعلمي والاقتصادي الذي ينعكس على المستوى المعيشي للمواطن.ويتمثّل العلاج في أهمية إدراك التغيرات ولو كانت طفيفة والتعامل معها معالجة لا تسلمياً وتحليلاً لا عرضاً، وتأتي المعالجة من خلال توفير صمامات الأمان ودعمها، والمتمثلة في التالي:
أولاً: مساحة التحرك البرلماني الضامن للحد من ارتفاع درجة حرارة الغليان، عبر تشريع القوانين والحد من حركة التغيرات المتسارعة السلبية.
ثانياً: القيادات الشعبية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تمثل مشاركة فعلية في صياغة ملامح التغيرات في المجتمع.
ثالثاً: الوعي الشعبي بالمتغيرات وضرورة وضع آليات من قبل الجهات الثلاث الأولى بما يتناسب مع درجة التفاعل الشعبي ووضعه.يبدو أن ارتفاع درجات الحرارة المتسارعة أظهرتها مؤسسة «كارنيجي» الأميركية ومؤسسة «فرايد» الإسبانية حول وجود التمييز في البحرين، وهو ما أنكرته بعض الكتل النيابية المنتخبة من الشعب!
ومع ارتفاع درجات الحرارة الحالية في الملفات المعيشية، لا ينفع الضفدع أن يكون الإناء الذي هو فيه مصنوع من ذهب أو فضة، ما دام سيتم سلقه في النهاية.
-
سمبوسة أوهمبرجر
جعفر حمزةأخذت تلاطفه في صورها ورائحتها، تقرّبت منه ولامست شهيته وتغنجّت باسمها، إلا أنّه امتنع وصد عنها لا لعيب فيها بل كان راغباً فيها إلا أن “العين بصيرة واليد قصيرة”، وبدلاً منها اقترب من أخرى أقل فتنة وأخذها بين يديه والتهمها وهو ينظر إلى الأولى حسرة لبعده عنها.
كانت الأولى هي شطيرة همبرجر معروف والثانية كانت مجرد “سمبوسة” اقتنع بها صاحبنا وأخذها لتُسكت جوعه الذي رضي أن تكون “السمبوسة” هي الــ Fast Food الخاص به.
وبين الهمبرجر والسمبوسة تغيرات اقتصادية ترسم سلوكيات جديدة للفرد وعلاقته بالمنتج أو العلامة التجارية، لتكون فترة “الطلاق الرجعي” قائمة بين المستهلك والمنتج، لحين عودة المياه إلى مجاريها، وكلما طالت فترة ذلك الطلاق كان الرجوع إليها صعباً، حيث يمكن أن تدخل علامات جديدة أو بديلة على الخط و”ترتبط” بالمستهلك، وهو ما يؤدي إلى دخول الأخيرة بقوة في الأسواق التي تعاني من الأزمات الاقتصادية وتشكّل علاقات “ود” جديدة مع المستهلك.
إلا أن المنتج البديل في زمن الأزمات لا يبدو الخيار الأوحد، ولا يمكن أن يعلن نفسه منتصراً، خصوصاً في مجتمعات عاشت وكونّت لها صورتها الخاصة في نمط المعيشة ومستوى الاستهلاك، كالمجتمع البحريني مثالاً، حيث يقع ضمن منظومة اقتصادية متشابهة نوعاً ما، وهي منظومة دول الخليج العربية، فالمستوى المعيشي والصورة النمطية لاستهلاك مواطني هذه الدول يختلف عن بقية البلدان العربية نتيجة اعتمادها على مصادر دخل ثرية كالنفط، فضلاً عن توجهها الحالي في بقية حقول المصادر المختلفة كالطاقة والصناعة والصيرفة الإسلامية والمشاريع العقارية وغيرها.
إن عملية الإنتقال ستكون صعبة من مستوى معيشي تمثل العلامات التجارية الصورة الأبرز في المجتمع إلى مستوى آخر تظهر فيه علامات “ضعيفة” وليس لديها حضور يعكس الصورة التي تناسب دولاً نفطية غنية كدول الخليج والبحرين خصوصاً، وعند الحديث عن المستوى المعيشي فإننا نعني جانبين مهمين، الأول مستوى المنتجات والخدمات الأساسية التي تتناسب طردياً مع حجم مدخول الدولة وانفتاح اقتصادها، فكلما زاد دخل الدولة انعكس على المستوى المعيش للمواطني وزادت رقعة الدعم الحكومي للمنتجات والخدمات للمواطنين، فضلاً عن تكوين قواعد جديدة للاقتصاد وإثراء التنوع في الدخل القومي.
والثاني مستوى عقلية الفرد المستهلك وتعامله مع العلامات التجارية كجزء من تركيبة سلوكه المعيشي.إن التغيرات الاقتصادية تخلف “ثغرات” معيشية يؤثر على نمط الشراء للمنتجات، فضلاً عن نظرة الفرد للعلامات التجارية ذات المستوى المرتفع في السعر، ونتيجة لتلك التغيرات التي تمثّل تحدياً لطبيعة تفكير الفرد وعلاقته بالمنتجات والخدمات، فإن الآثار المترتبة على ذلك تتوسع من دائرة الإنفاق إلى دائرة إشباع التملك والظهور إلى دائرة التميز والتفرد، ومن تلك الآثار:
أولاً: التغيير في جدولة الإنفاق لدى المستهلك والبحث عن بدائل رخيصة الثمن مع الحفاظ قدر الإمكان على الجودة.
ثانياً: محاولة بعض العلامات التجارية الحفاظ على ظهورها وحضورها عبر العروض الخاصة.
ثالثاً: البحث عن بدائل شبيهه بالمنتج الذي يميل إليه المستهلك، وخصوصاً فيما يتعلق بمنتجات الألبسة والإكسسورارات.
رابعاً: تنامي سوق البضائع المقلدة وإثراء صناعة التقليد، وتبعاتها في الصحة والأمن على المستهلك.وهناك العديد من الآثار المترتبة على إنخفاض معدل الدخل للفرد وطريقة التعايش مع وضع اقتصادي متأزم، إلا أن ما يثير الإنتباه هو تنامي حدة الصراع الداخلي بين الرغبة في امتلاك نمط معين من العلامات التجارية وبين واقع الميزانية التي لا تشجع على امتلاك تلك العلامات أو استخدامها، ويأتي ذلك الصراع ويشتد نتيجة الصور المُعلنة وربطها بمستوى معين من أسلوب العيش.
وخصوصاً في ظل تنانمي الفضائيات الموجهة والتخصصية التي تُثري الذاكرة البصرية للمشاهد لاقتناء هذه العلامة أو تلك.فعندما تقتني إمرأة حقيبة من “Channel” فذلك يعكس نمط معيشتها والمستوى المعيشي الذي أتت منه، وقد لا تكون بالضرورة لديها المال الكافي لامتلاك تلك العلامة التجارية إلا أن الجو العام للتفكير في إظهار مستوى معيّن من المعيشة يدفعها لشراء تلك الحقيبة.
لقد أخذ الصراع بين المطلوب والموجود حدته لدى الكثير من الناس من ذوي الدخل المتوسط بل والضعيف، حيث يسعى البعض وربما الكثير في اقتناء علامات تجارية تحتاج لسيولة مالية جيدة، وقد يصل البعض إلى إغراق نفسه بالديون ليكون من ضمن الصورة “المحترمة” في المجتمع من خلال تلك المنتجات، ويذكرني هذا الأمر بأحد الأخوة الذي لا يبقى من راتبه إلا النزر القليل ويسكن في منزل أجار ولديه بنات في الروضة، حيث اتخذ قراره بشراء سيارة دفع رباعي من الوكالة ولديه سيارته الخاصة، وعجبي كيف سيعيش بعدها، ربما بأكل السمبوسة صباحاً وتناول النخج على العشاء!
وعلى المستهلك التعايش مع الأمر بخطوتين، هما التعامل مع الوضع الاقتصادي المتأزم بواقيعة بعيداً عن سحر صور العلامات التجارية وبريقها، ثانياً زيادة مستوى الدخل عبر تأمين مصادر مالية إضافية وادخارها وقت الحاجة.
ولا عيب أن تأكل السمبوسة بدلاً من الهمبرجر، فكلاهما يذهب للمعدة، ولله ال -
سمبوسة أوهمبرجر
جعفر حمزة
أخذت تلاطفه في صورها ورائحتها، تقرّبت منه ولامست شهيته وتغنجّت باسمها، إلا أنّه امتنع وصد عنها لا لعيب فيها بل كان راغباً فيها إلا أن “العين بصيرة واليد قصيرة”، وبدلاً منها اقترب من أخرى أقل فتنة وأخذها بين يديه والتهمها وهو ينظر إلى الأولى حسرة لبعده عنها.
كانت الأولى هي شطيرة همبرجر معروف والثانية كانت مجرد “سمبوسة” اقتنع بها صاحبنا وأخذها لتُسكت جوعه الذي رضي أن تكون “السمبوسة” هي الــ Fast Food الخاص به.
وبين الهمبرجر والسمبوسة تغيرات اقتصادية ترسم سلوكيات جديدة للفرد وعلاقته بالمنتج أو العلامة التجارية، لتكون فترة “الطلاق الرجعي” قائمة بين المستهلك والمنتج، لحين عودة المياه إلى مجاريها، وكلما طالت فترة ذلك الطلاق كان الرجوع إليها صعباً، حيث يمكن أن تدخل علامات جديدة أو بديلة على الخط و”ترتبط” بالمستهلك، وهو ما يؤدي إلى دخول الأخيرة بقوة في الأسواق التي تعاني من الأزمات الاقتصادية وتشكّل علاقات “ود” جديدة مع المستهلك.
إلا أن المنتج البديل في زمن الأزمات لا يبدو الخيار الأوحد، ولا يمكن أن يعلن نفسه منتصراً، خصوصاً في مجتمعات عاشت وكونّت لها صورتها الخاصة في نمط المعيشة ومستوى الاستهلاك، كالمجتمع البحريني مثالاً، حيث يقع ضمن منظومة اقتصادية متشابهة نوعاً ما، وهي منظومة دول الخليج العربية، فالمستوى المعيشي والصورة النمطية لاستهلاك مواطني هذه الدول يختلف عن بقية البلدان العربية نتيجة اعتمادها على مصادر دخل ثرية كالنفط، فضلاً عن توجهها الحالي في بقية حقول المصادر المختلفة كالطاقة والصناعة والصيرفة الإسلامية والمشاريع العقارية وغيرها.
إن عملية الإنتقال ستكون صعبة من مستوى معيشي تمثل العلامات التجارية الصورة الأبرز في المجتمع إلى مستوى آخر تظهر فيه علامات “ضعيفة” وليس لديها حضور يعكس الصورة التي تناسب دولاً نفطية غنية كدول الخليج والبحرين خصوصاً، وعند الحديث عن المستوى المعيشي فإننا نعني جانبين مهمين، الأول مستوى المنتجات والخدمات الأساسية التي تتناسب طردياً مع حجم مدخول الدولة وانفتاح اقتصادها، فكلما زاد دخل الدولة انعكس على المستوى المعيش للمواطني وزادت رقعة الدعم الحكومي للمنتجات والخدمات للمواطنين، فضلاً عن تكوين قواعد جديدة للاقتصاد وإثراء التنوع في الدخل القومي.
والثاني مستوى عقلية الفرد المستهلك وتعامله مع العلامات التجارية كجزء من تركيبة سلوكه المعيشي.إن التغيرات الاقتصادية تخلف “ثغرات” معيشية يؤثر على نمط الشراء للمنتجات، فضلاً عن نظرة الفرد للعلامات التجارية ذات المستوى المرتفع في السعر، ونتيجة لتلك التغيرات التي تمثّل تحدياً لطبيعة تفكير الفرد وعلاقته بالمنتجات والخدمات، فإن الآثار المترتبة على ذلك تتوسع من دائرة الإنفاق إلى دائرة إشباع التملك والظهور إلى دائرة التميز والتفرد، ومن تلك الآثار:
أولاً: التغيير في جدولة الإنفاق لدى المستهلك والبحث عن بدائل رخيصة الثمن مع الحفاظ قدر الإمكان على الجودة.
ثانياً: محاولة بعض العلامات التجارية الحفاظ على ظهورها وحضورها عبر العروض الخاصة.
ثالثاً: البحث عن بدائل شبيهه بالمنتج الذي يميل إليه المستهلك، وخصوصاً فيما يتعلق بمنتجات الألبسة والإكسسورارات.
رابعاً: تنامي سوق البضائع المقلدة وإثراء صناعة التقليد، وتبعاتها في الصحة والأمن على المستهلك.وهناك العديد من الآثار المترتبة على إنخفاض معدل الدخل للفرد وطريقة التعايش مع وضع اقتصادي متأزم، إلا أن ما يثير الإنتباه هو تنامي حدة الصراع الداخلي بين الرغبة في امتلاك نمط معين من العلامات التجارية وبين واقع الميزانية التي لا تشجع على امتلاك تلك العلامات أو استخدامها، ويأتي ذلك الصراع ويشتد نتيجة الصور المُعلنة وربطها بمستوى معين من أسلوب العيش.
وخصوصاً في ظل تنانمي الفضائيات الموجهة والتخصصية التي تُثري الذاكرة البصرية للمشاهد لاقتناء هذه العلامة أو تلك.فعندما تقتني إمرأة حقيبة من “Channel” فذلك يعكس نمط معيشتها والمستوى المعيشي الذي أتت منه، وقد لا تكون بالضرورة لديها المال الكافي لامتلاك تلك العلامة التجارية إلا أن الجو العام للتفكير في إظهار مستوى معيّن من المعيشة يدفعها لشراء تلك الحقيبة.
لقد أخذ الصراع بين المطلوب والموجود حدته لدى الكثير من الناس من ذوي الدخل المتوسط بل والضعيف، حيث يسعى البعض وربما الكثير في اقتناء علامات تجارية تحتاج لسيولة مالية جيدة، وقد يصل البعض إلى إغراق نفسه بالديون ليكون من ضمن الصورة “المحترمة” في المجتمع من خلال تلك المنتجات، ويذكرني هذا الأمر بأحد الأخوة الذي لا يبقى من راتبه إلا النزر القليل ويسكن في منزل أجار ولديه بنات في الروضة، حيث اتخذ قراره بشراء سيارة دفع رباعي من الوكالة ولديه سيارته الخاصة، وعجبي كيف سيعيش بعدها، ربما بأكل السمبوسة صباحاً وتناول النخج على العشاء!
وعلى المستهلك التعايش مع الأمر بخطوتين، هما التعامل مع الوضع الاقتصادي المتأزم بواقيعة بعيداً عن سحر صور العلامات التجارية وبريقها، ثانياً زيادة مستوى الدخل عبر تأمين مصادر مالية إضافية وادخارها وقت الحاجة.
ولا عيب أن تأكل السمبوسة بدلاً من الهمبرجر، فكلاهما يذهب للمعدة، ولله ال -
قبل صياح الديك
جعفر حمزة
التجارية ٣٠ يناير ٢٠٠٨
كان مقدراً لها أن تلقى حتفها على يد ملك بلادها، إلا أن ذكائها وحنكتها وحسن تقديرها للأمور، بالإضافة إلى خيالها الواسع جعلت مسألة قتلها بعيد المنال، فقد كانت تسرد القصص التي لا تنتهي، وتتوقف عند كل مكان حرج في القصة لتُكملها في اليوم التالي، وبهذا حافظت على نفسها من عادة الملك في قتل من لا يحبها ولا يرتضيها زوجة له. كانت تلك الأميرة “شهرزاد” التي لم تتوقف طوال “ألف ليلة وليلة” من سرد القصص على مسامع الملك “شهريار”، وكان الفاصل الإعلاني بين قصة وأخرى هو صياح الديك عند الصباح. خطرت في بالي هذه القصة وأنا أقرأ الواقع المحلي الاقتصادي والمعيشي، الذي تجاوزت قصصه آلاف الليالي لا للتسلية بل للإلهاء أو لنقل بذل الجهود في أمور نحن في غنى عنها. ولئن تشابهت الوسيلة مع ما اتخذته “شهرزاد” إلا أن الهدف مختلف تماماً، فهي سعت إلى إنقاذ بنات مملكتها من حكم الملك الجائر وإيقاف القتل المتواصل للنساء، في حين يسعى البعض على هذه الجزيرة لإلهاء الناس عن الملفات الأساسية والمحورية، ويبدو أن هذه الثقافة العربية المتأصلة في الزمن والتراث والحضارة العربية ما زالت باقية ووصفة “شهرزاد” سارية المفعول لحد الآن. فقصص “شهرزاد” أصبحت على لسان الكثير من ماسكي الملفات المعيشية في الساحة المحلية، أكان من يمسك تلك الملفات وزارة أو هيئة أو مسؤول أو نائب … وتستمر الحكاية. لقد أصبحت القضايا الأساسية والتي من المفترض أن تكون ضمن سير عملية الإصلاح الواقعية أمراً يستحق لـ”شهرزاد” أن تُطيل سردها وبطرق متنوعة وإبداعية ليتم طرحها على الجمهور الذي سينشغل بالحبكة القصصية وأحداثها بدلا من التركيز على القضايا الأساسية للوطن، كما انشغل “شهريار” عن مصير “شهرزاد”. فالعديد من الملفات المعيشية الأساسية من قبيل مصير إيرادات أسعار الزيادة في النفط وسبل تصريفها، والقوانين التي جعلت الأراضي مشاعا للجميع، بل أصبح الحصول على أرض أو بيت من الأماني صعبة التحقق في بلد نفطي، بالإضافة إلى ترهل البنية التحتية وسبل تطويرها وإعادة النبض الواقعي الحضاري لها، فضلاً عن انتشار التمييز الوظيفي وانعكاساته على التطور المهني وإثراء الاقتصاد الوطني، وملفات البيئة المنكوبة والسواحل المصادرة والفساد الإداري والمالي في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وملفات الحريات المدنية والبطالة المقنعة وغياب استراتيجية وطنية شفافة إزاء ذلك الملف، فضلاً عن ضيق الحرية الإعلامية في إنشاء القنوات والإذاعات الخاصة، وتضارب الرؤى الاقتصادية للوطن بين من يخلص في تسريع عجلة التنمية وبين من يضع العصا في العجلة. وكل تلك الملفات الساخنة والأساسية أصبح الحديث عنها في فضاء هوامشها لا في أصلها، فقد بات الحديث عن البناء العمودي بدلاً من “أرض لكل مواطن”، وأصبح الحديث عن زيادة ٧٠ أو ٥٠ ديناراً لكل أسرة بدلاً من وضع خطة واضحة للاستفادة الحقيقة من زيادة إيرادات النفط، وأصبح الحديث عن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر “FDI” بدلاً من تشجيع الاستثمار في العقول المحلية، وبات الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتغنّي بها بدل التفكير في إنشاء مناطق صناعية مؤهلة”Qualified Industrial Zones”والتي تسهم عند إزدياد عددها في توفير السلع ذات كلفة دنيا ونوعية أعلى للمستهلكين المحليين، فضلاً عن تصديرها للدول الجارة وصاحبة الاتفاقيات الثنائية. وهكذا تستمر “شهرزاد” في سرد قصصها المشوقة والي لا تنتهي، لينشغل “شهريار” بها طوال الليل، ولينتظر تكملة الحكاية في الليلة التالية. ولا تقتصر “شهرزاد” على الجانب الحكومي، وإن كان لها نصيب الأسد في سرد الحكايا “الأسطورية”، إلا أن مؤسسات المجتمع المدني والكتل النيابية والتجار والمثقفين في البلاد لهم نصيب من تلك الحكايا، ألم نقل أن “شهرزاد” متأصلة في الثقافة العربية، فبدلاً من الإنشغال في هوامش وآثار حكايا “شهرزاد” الحكومية كان لا بد بالإضافة إلى ذلك السعي تأسيس وعي معيشي يمكن معه مجاراة التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، فتجديد الخطاب الشعبي وحث الناس على تبنّي عقلية النمو والتطوير والبحث عن السبل الكفيلة بتنوع الدخل للفرد والرقي بوعيه المعرفي والاقتصادي، فضلاً عن مبادرات لمؤسسات وتجار ووجهاء في إنشاء مشاريع وحاضنات فكرية وإبداعية تنتج أكثر مما “تجتر” في المفردات والخطابات بين “نافث” للفتنة و”محترق” بها و”إطفائي” ينتظر رؤية الدخان ليبدأ عمله. فبدلاً من كل ذلك “الإنشغال” المهووس بالسياسة لحد النخاع و”الإنغماس” في تشدد الخطاب الديني لبعض رافعي “صكوك الغفران” إلى القاع، لا بد من فتح أبواب أخرى للإشتغال والإنشغال الإيجابي للمواطن البحريني عبر ملفات اقتصادية وفكرية ينتج معها أكثر مما يتلقى ويتفاعل، ولتكون الأجندة القادمة هي أجندة مواجهة التحديات والتغيرات على المستويين المحلي والعالمي عبر نافذة اقتصادية ومعيشية. فهي البوابة الواقعية للتطوير والاستقرار، وفي الحديث “لولا الخبز لما عُبد الله” يقول علي بن أبي طالب (ع):’ما دخل الفقر قرية إلا وقال للكفر خذني معك’. ففي كل منا “شهرزاد” قد تتمثل في الخطاب الحكومي، وتتمثل في خطاب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والكتل، ويبقى السؤال عن إنتهاء سرد القصص في الهامش والابتعاد عن الهدف الرئيس ، فهل نستمر في سماع “شهرزاد” ونتخذها أسلوباً في السياسة والدين والثقافة أم أن الوقت حان للتوقف عن استماعها ليس عند صياح الديك في الصباح، بل قبل ذلك؟ -
اليابان تطلق القنابل
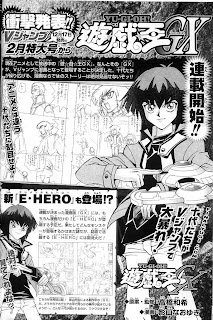

بين برمجة “المانجا” و “الهانتاي”
الرسوم الكرتونية اليابانية تطلق قنابل افتراضية في العالمجعفر حمزة
” القدرة على الرسم طاقة تحي أمة وتميت أخرى”
عُرف اليابانيون كغيرهم من جيرانهم كالصينيين والكوريين بالقدرة الجميلة في الرسم والتلوين، ولا أدل على ذلك من التراث الغني لهذه البلدان والمتمثلة في المعابد التي تزخر بالزخارف والرسوم التي تأخذ بالألباب، ولا ينسى المرء ولو للحظة الرسوم للإنسان والحيوانات والنباتات التي يخال للمرء أنها ستخرج من مكانها لدقة رسمها وبراعة راسمها.
ويبدو أن براعة الإنسان وحسه الإبداعي يقفز محلقا مبتعدا عن حسه الإنساني الطبيعي عندما لا يرى سبيلا نيرا يسترشد به، لتتحول تلك البراعة إلى سواد ملون بالرسوم، ويكون ذلك الإبداع سلاحا مُبتكرا للربح والترويج لقيم العنف والجنس، فما الذي حول تلك الرسوم التي تحكي التاريخ إلى أفلام ومسلسلات كرتونية يابانية تحاكي الإنسان في عنفه وجنسه؟قبل الخوض في غمار القيم الكرتونية اليابانية بالخصوص، لا بد من معرفة المادة الأولى لتصنيع تلك القيم وترويجها وبيعها بملايين الدولارات حول العالم، إذ تمثل “المانجا” المادة الخام للرسوم الكرتونية اليابانية، حيث تعني هذه الكلمة الكتب الأدبية المرسومة بشكل كرتوني، وهذه الظاهرة انتشرت في اليابان وتجد رواجا هائلا بين فئات الشعب المختلفة في اليابان، وبعد نجاحها محليا انتشرت في أنحاء العالم حيث انتقلت إلى كل أوروبا وأمريكا.
وهذا النوع من الأدب يستخدم الصورة المرسومة بالإضافة إلى النص المصاحب لها، وتتناول مواضيع مختلفة وتخاطب شرائح المجتمع كافة، إذ أنها لا تقتصر على الاطفال، بل أن أكثر رواد هذا النوع من الكتب الكرتونية هم من البالغين والكبار. ومن الكتاب اليابانيين الذين برعوا في هذا الاتجاه “جو ناجاي” صاحب مغامرات الفضاء المعروفة عند الجمهور العربي، وكذلك “أوسامو تيزوكا” الذي يعد الأب الروحي للمانجا الحديثة.وقد أخذت “المانجا” صورتها الأولى في اليابان كقصص مرسومة للناس خلال فترة “الإيدو” (1603-1868)، حيث بلغت العلاقة الثنائية بين الرسم والكتابة صيغتها التفاعلية المهيئة لظهور “المانجا”، وتذكر بعض الدراسات أنها صينية الأصل، وانتقلت إلى اليابان بعدئذ، وقد كانت تحكي تلك القصص حوادث ووقائع سواء كانت خرافية أم حقيقية، وقد بدأ التحول الفعلي في تناول “المانجا” لموضعات الجنس والعنف في “الثورة التعبيرية للغة المانجا” خلال الفترة من الستينات إلى السبعينات.
وبدأت المرحلة الثانية من التحول في “المانجا” من الرسم الثابت إلى الرسم المتحرك، لتدخل “المانجا” عالم الرسوم المتحركة وقد كانت مهيأة في ذاتها لذلك، وهناك قاعدة في اليابان تقول: “إذا كان بالإمكان القيام بعمل فيلم بممثل حقيقي، فبالإمكان أيضا صناعة فيلم بممثل كرتوني”، وقد كانت الانطلاقة الحقيقية والقوية لصناعة الرسوم الكرتونية اليابانية التي تحتفظ بقوتها المميزة لها دون غيرها في الدقة، والتفاعل، والتلوين، والخلفيات، وقبل كل ذلك في ملامح وجوه الشخصيات، والشخصيات التي تتميز بها الأفلام أو المسلسلات الكرتونية اليابانية تتسم بالتعقيد، وفي بعض الأحيان يبدو أن الفاصل بين الطيب والشرير عويصا وليس واضحا، ومن المباديء التي تطرحا “المانجا” الجنس، ، العنف والموت.
يبلغ حجم عائدات الاقتصاد الياباني من قيمة صادرات الرسوم المتحركة، ألعاب الفيديو، الأفلام، الرسم، الموسيقى والموضة ذات العلاقة بالرسوم ما يعادل 17.1 مليون دولار أمريكي في عام 2002م، وبناء على دراسة لمعهد “ماروبيني” للأبحاث بطوكيو، فإن 60% من الرسوم المتحركة (أنيميشين) في العالم تأتي من اليابان، تذكر “البوكيمون”، “الديجيمون” والقائمة طويلة جدا يتذكرها الجميع بلا استثناء كبارا وصغارا على حد سواء، ناهيك عن الألعاب الكمبيوترية ذات العلاقة مثل “جيم بوي”، “بلاي ستيشن” و “إكس بوكس”.
” في الحقيقة، من موسيقى البوب إلى الأجهزة الإلكترونية، ومن العمارة إلى الموضة، ومن الطعام إلى الفن، اليابان أخذت سيطرتها الثقافية بالظهور أكثر من فترة الثمانينات، عندما كانت قوة اقتصادية”، هذا ما قاله “دوجلاس مك كاري” الذي كتب مقاله في مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية عام 2003.
وقد أخذت العديد من تلك الرسوم والأفلام وكذلك المسلسلات طريقها إلى الولايات المتحدة الامريكية، ليكون لها عشاقها ومتابعيها، حيث تصدر اليابان العديد من أفلام الرسوم المليئة بالعنف والدماء وتبث عبر التلفزيون، بمعدل مرتفع جدا عما هو معروض في تلفزيونات الولايات المتاحدة الأمريكية نفسها، ولم تقتصر “المانجا” اليابنية على التصدير بل أخذت بالتأثير، فمسلسل “عودة بات مان” الذي أنتجته شركة “ورنر برذرز” الأمريكية مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن التأثير الياباني في القتال والحركة أخذ موضعه من ذلك المسلسل الأمريكي.
بل أن الكثير من القنوات الأمريكية أخذت ببث المسلسلات اليابانية بصورة متكررة وغير مسبوقة نتيجة الطلب المتزايد على تكرارها ومشاهدتها، فقناتي “فوكس” و “دبليو بي” وأيضا قناة “كرتون نتوورك” أصبحت تعرض مسلسلات مثل “ديجيمون” و “بوكيمون” ثلاث مرات في يوم السبت ضمن البرنامج اليومي لديها.
ويبدو أن اليابانيين قد تملكتهم القوة الكرتونية ليحتلوا السوق الأمريكية صوريا، حيث أن الكثير من مجلات “المانجا” باتت تطبع وتنشر للشباب في الولايات المتحدة الأمريكية.وتعدى الأمر ليصل إلى الرسوم الكرتونية الجنسية “مانجا الجنس” في الكثير من المسلسلات والأفلام الكرتونية اليابانية، فقد ظهرت موجة تسمى بأفلام الجنس الكرتونية أو “هانتاي”، وقد شكلت كارثة على صناعة الرسوم الكرتونية المتحركة اليابانية المحافظة على عاداتها، ورغم أن الرسوم المتحركة اليابانية تحتوي على أطنان من التلميحات الجنسية والتعري الواضح والكامل، إلا أن صناع الرسوم المتحركة الكبار في اليابان هاجموا صنّاع “الهانتاي”.
و “هنتاي” كلمة يابانية تستخدم خارج اليابان، وبالخصوص في البلدان الغربية والكثير من البلدان الناطقة باللغة الانجليزية، للدلالة على الرسوم المتحركة اليابانية والمجلات، ألعاب الكمبيوتر التي تحوي الموضوعات والصور الإباحية والجنسية الواضحة.وقد يبدو من الغريب أن تخرج مثل هذه الصناعة من لدن مجتمع محافظ كاليابان المتميز بتمسكه بتقاليده والمحافظة على الكثير من القيم الاجتماعية، إلا أن الحقيقة بأن اليابانيين قد تخلوا عن المحافظة واتجهوا للأفلام الجنسية منذ الثمانينات، ويبقى السؤال حول سبب انتشار هذه الألعاب في اليابان بشكل أكثر من بقية الدول فالجواب يأتي من اختلاف الواقع الياباني عن الأمريكي والأوروبي، ففي أمريكا وأوروبا بامكان أي شخص أن يدخل إلى صالات التعري، أو أن يحصل على متعته في الشارع، وهذا الأمر لا يوجد بتلك الطريقة المفتوحة كليا في اليابان حيث يضطر الياباني البحث عن بديل، وقد يكون البديل افتراضيا.
ويذكر “مايك لايزو” المدير المساعد للبرامج والإنتاج في “كرتون نتوورك” بأن الغريب والعجيب أن تصنع أفلام العنف الكرتونية في أقل البلدان في معدلات العنف في العالم”.
وفي مقالة له عن “المانجا” يذكر الكاتب الياباني “فيوسانوسيوكي ناتسومي” بأن الجنس والعنف ليست أكثر من مواضيع تتناولها “المانجا” كغيرها من المواضيع، وبالاعتماد على التقارير التي تكشف الرأي العام حول التفاعل المقاس مع مواضيع “المانجا” الكرتونية، يتبين مدى الحقيقة التي تطرحها “المانجا” والتي تعبر عن انعكاس للداخلي الياباني المكبوت، والتمييز بين ما هو حبيس في النفس وما هو حر.
ويبدو أن اليد اليبانية المبدعة في الرسم، تخطت تقاليد مجتمعها وتراثه ، لتطلق العنان لنفسها في عالم تتسيده دون غيره حتى أن أمريكا تكون متخدرة بالفن الياباني العنفي والإباحي، الذي أخذ مساحته الكبيرة والملحوظة في القنوات الأمريكية والأوروبية، فضلا عن المواقع الإلكترونية والمجلات وألعاب الفيديو، فهل يشكل اليابانيون قيم العالم الافتراضي الجديد؟
-
“الكلب، الجرس، الطعام
الاستنساخ البصري ما زال مستمراً
ثلاثية “الكلب، الجرس، الطعام” وتحدي النمطيةجعفر حمزة
“النسخ المتعدد للتوجهات الموحدة للأفراد بات مُنتجاً يتم تغليفه وبيعه في نظام الإنسان فيه محلاً للاستهلاك أكثر من أن يستهلك”.
الرؤية العامة للنظام الاقتصادي المعاصر يتحرك نحو “نسخ السلوك الاستهلاكي” للأفراد ما يدفع الكثير من شركات التصنيع في مختلف المجالات إلى توظيف مفهوم “الاستنساخ الاستهلاكي” الذي يحوّل الأفراد إلى مستهلكين متماثلين في التوجه والذوق وهو ما يعود بالفائدة التجارية على كبرى الشركات.
وكمثال تقريبي لتقديم ما نريده هو وجود محل تجاري في منطقتك ويريد أن يشتري كل الناس ما يبيعه من منتجات مختلفة إلا أنها تخرج من مكان واحد هو “المحل” لا غيره، ويسعى إلى تحقيق ذلك من خلال ترويج قيم استهلاكية معينة وبمختلف الوسائل لزرع ارتباط شرطي بين المنتج والقيمة. ما نحاول الوصول إليه من خلال استعراض “صوري” للمنتج هو تسليط الضوء على الصيغة المتحركة في السوق العالمية من أجل استنساخ الأذواق بما يتناسب مع كمية الدخل لكبرى الشركات فيما يخص بالترويج والدعاية وبرمجة الصورة الشرطية عند المستهلك.“إيفان بافلوف” والتركيبة السرية
“الكلب والجرس والطعام” كانت تلك التركيبة السرية التي أوصلت “بافلوف” إلى جائزة “نوبل” عام 1904م, والقصة معروفة، حيث أجرى “بافلوف” على نظرية الارتباط الشرطي التي طبقها على كلب يأتيه بطعام بعد أن يدق الجرس، ومع مرور الوقت أصبح لعاب الكلب يسيل بمجرد دق الجرس،إذ ارتبط سماع صوت الجرس بالطعام، بمعنى آخر لم يعد الطعام في حد ذاته مثيراً للكلب، بل أصبح الجرس مثيراً جديداً بمثابة المثير الأصلي وهو اللحم.
إن نظرية الارتباط الشرطي هي الأساس العلمي للترويج والتسويق العالمي المعاصر، فعن طريق ربط القيم الإيجابية من خلال الصور البصرية تتكون علاقة قوية تعتمد على أساسين مبنيين على تلك النظرية،هما:
أولاً: الاتساق.
ثانياً: التكرار.
وتعتمد منهجيا التسويق المعاصرة على ذينك الأساسين للترويج و”خلق” حالة مُعاشة وارتباط لا ينفك بين قيمة فكرية أو جمالية معينة وبين المنتج المادي (بضائع) أو المنتج المعاملة (الخدمات).
لقد قدم “بافلوف” نظريته تلك والتي كانت أساساً علمياً لما يسمّى باللغة الإنجليزية “براندينغ” الخاصة بعملية الترويج التجاري للبضائع والخدمات، ما نؤمن به هي الحقيقة الموضوعة بين يديك في الجرائد والمجلات وقبلها في الفضائيات والإعلانات في الشارع والمحلات والمجمعات، ومجموع كل الصور التي تمر على باصرتك يومياً بمعدل يزيد عن ثلاثين ألف صورة في اليوم بالمعدل الطبيعي، سواء كان إعلاناً أو جزءً منه، وتزداد كثافة الصورة المتكونة في الذهن في علاقة طردية مع المساحة التي يمكنك أن تتحرك فيها دون إعلانات أو صور، ويأخذ الأمر أهميته الخاصة في مملكة البحرين ذات المساحة الصغيرة والكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى المساحات العمرانية الممتدة، مما يجعل فرصة إراحة العين من النظر تبدو قليلة جداً، وهو ما يعزز من جانب ثانٍ الارتباط الشرطي بن الصورة والقيمة، فعن طريق الاتساق بين موضوع الطعام العصري و”ماكدونالد” على سبيل المثال، أو بين “كوكا كولا” والمشروب الغازي المفضل لمذاقه و”موضته” إن صح التعبير، وذلك من خلال استخدام صور ذات مدلول إيجابي وجذاب، تصل الرسالة بصورة واضحة للذهن بوجوب وجود ربط بين تلك القيمة الايجابية والصورة المقدمة “ماكدونالد” و “كوكا كولا” على سبيل المثال.
ولا يمكن الاعتماد على عملية الربط فقط لترويج الصورة إذ لا بد من التكرار لتكون عملية “الحفر الذهني” بين القيمة والصورة أعمق وعلاقتهما أوثق، وهو الأمر الذي تقوم عليه كبرى الشركات من خلال خلق حالة من “الولاء” للمنتج وهي السياسة العامة للسوق الدولية التي تجهد للوصول إلى تلك الحالة بشتى الوسائل.نظام بصري لا خطي، كيف نتعامل معه؟
بصريات العولمة المعاصرة ترقى إلى الوصول إلى “نمذجة نمطية” للأفراد، بمعنى آخر تعمل العولمة المعاصرة إلى محو الفوارق الفكرية والذهنية بين الأفراد والشعوب لترسي قيمة واحدة وواحدة فقط عبر الاجتهاد البصري المدروس، هي قيمة “الاستهلاك” من خلال التوظيف الذكي للإعلام والإعلان في الترويج لتلك القيمة.
ولمعرفة “فلسفية” للعولمة التي تمثل لغة الحركة السوقية اليوم لا بد من الاستناد إلى خبراء في هذا الجانب لمقاربة بسيطة نوعاً ما لتلك “الأيقونة” ومن ثم الدخول الموضوعي للمسألة قيد البحث.
يقول “موري جيل مان” الحائز على جائزة نوبل، والأستاذ السابق في الفيزياء النظرية بجامعة “كالتيك”: ( لقد ظهرت هنا على كوكب الأرض، بمجرد تشكلها، نظم متزايدة التركيب والتعقيد نتيجة للتطور الفيزياء للكوكب، والتطور البيولوجي، والتطور الثقافي البشري. ولقد سارت العملية مشواراَ بعيداً إلى درجة أننا نحن البشر نواجه الآن مشكلات إيكولوجية وسياسية واقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد. وعندما نحول التصدي لهذه المشكلات الصعبة، فإننا بطبيعة الحال نميل إلى تقسيمها إلى أجزاء أسهل في التعامل معها. وهذا أسلوب مفيد، ولكن له أوجه قصور خطيرة. فعندما يتعامل المرء مع أي نظام لا خطي، ولا سيما إن كان مركباً، فإنه لا يستطيع قصر فكيره على الأجزاء أو الجوانب أو مجرد جمع الأشياء معاً وأن يقول إن ذلك سلوك هذا أو سلوك ذاك، وعند جمعهما معاً، يُسفران عن الأمر برمته. لا بد للمرء، في وجود نظام لا خطي مركب، أن يقسمه إلى أجزاء، ثم يدرس كل جانب، وبعد ذلك يدرس التفاعل الشديد جداً بينها جميعاً. فبهذه الطريقة وحدها يستطيع وصف النظام بأكمله”.
إن الهدف من عرض تلك المقولة كاملة هو التعرف على النظام الذي نعيش فيه، ذلك النظام المعقد في تعريفه البسيط حين النظر إليه، إن أصل المسألة لا تنحصر في ارتباط شرطي محكوم الدراسة هنا، أو ترويج مدروس هناك لهذه العلامة التجارية أو لتلك البضاعة، إننا نعيش في عالم مركب ولا يمكن الاستمرار فيه من موقع “المؤثر” إن اقتصرت النظرة من موقع “المتأثر” والمستهلك فقط.
ما نعيشه في الواقع هو مجموعة عناصر مختلفة ومتنوعة تجتمع لتكوّن صورة تجهد حكومات وأسواق عالمية فضلاً عن توجه عام ترسمه السياسات الاقتصادية في أن تكون تلك الصورة هي “الإله الجديد” الذي ينبغي للجميع بلا استثناء السجود له والتودد إليه عبر “تقرّب بصري” من خلال “هضم” المنتج المأكول والمشروب والملبوس و..إلخ.
إن أساسا التعامل مع نظام العولمة المركب اللاخطي كما سماه “جيل مان” هو التفكيك البسيط، وذلك عبر تحليل الصورة البصرية للقيمة إلى وحدات بسيطة وتقديمها للمستهلك، ليعرف أن أصل اللعبة القائمة في الترويج هي سياسة “الكلب، الجرس،الطعام” من جهة، والصورة المركبة من جهة أخرى،ولا نعتقد أن الإدراك وحده يكفي للتخفيف من “هوس الاستهلاك النمطي” الذي يستعين بشركات ضخمة للترويج فضلاً عن شبكة متشعبة من الاستراتيجيات الفرعية في تعميم “مبدأ الشراء النمطي”، إذ لا بد من رؤية معاكسة بمعنى وجود استراتيجية لا نمطية في الاستهلاك، وبوادرها ذات ظهور متواضع إلا أنها موجودة متمثلة في جمعيات وتجمعات مناهضة للاحتكار البصري ضمن الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ترسم منهج الفرد في التفكير والشراء بل وحتى في الأمور الخاصة جداً به.كوكا كولا، كوكا كولا، كوكا كولا
تبقى السلعة الاستهلاكية هي “شيفرة” العولمة المعاصرة التي تزيل الفوارق لتنسخ المجتمعات دون فوارق وتتلاشى الخصائص والتمايزات، ويصبح السلوك الإنساني في كل العالم واحداً من الغرب إلى الشرق، من أمريكا إلى الصين، ومن آلاسكا إلى بلاد الأنكا، ذلك السلوك الإنساني الذي يستهلك نموذجاً نمطياً واحداً لا يتغير، فيستهلك السلعة نفسها ويطمح إلى اقتنائها.
وليكون الوجه الإنساني بعد ذلك نمطاً لا يعتريه التبدل إلا ما تلزمه الحملات الإعلانية الخاصة بالمنتج “الإله”، وقريباً يُصبح العالم يأكل “الماكدونالد” ويشرب “الكوكا كولا” ويلبس “الجينز” ويقتني “البلاي ستيشن وإكس بوكس”، ونصل إلى مرحلة “الفراغ في الهوية” إذ تكون هويتنا تنزل مع كل منتج جديد من الأسواق العالمية، وعلى رفوف محلات الموضة، وهكذا تتمثل الشخصية “الاشتراطية” التي تناولته نظرية “بافلوف”، فمع كل مثير بصري تتحرك منا ردة فعل جسدية وفكرية بل وحتى ثقافية عقائدية، وبعد التكرار والاتساق تذوب الهوية وتظهر القيمة السوقية في السلوك.
ونهتف عندئذ :(كوكا كولا، كوكا كولا) ليكون ذلك الهتاف هو النداء اليومي الذي نسمعه ونردده كرمزية لقيم ما زالت تتفنن في التقديم لتضمن استمرار الاستهلاك.
وتبقى المسألة في المعرفة الحقيقية المخططة في رد الاعتبار لقيمة الإنسان في استقلاله وفردانيته بعيداً عن الخطط الترويجية والاستخفاف المدروس بالعقول، فهل نصل إلى مرحلة الاستقلال والخيار الذاتي، أم أن عصر “الكوكلة” ما زال في بدايته؟ -
الولايات المتحدة البحرينية
الولايات المتحدة البحرينيةجعفر حمزة
جريدة التجارية، ٢٣ فبراير ٢٠٠٨
سياتل، واشنطن دي سي وميامي، كانت تلك بعض الولايات التي زرتها قبل عدة سنوات وقابلنا فيها صانعو القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيها، ولكل ولاية نكهتها الخاصة وعالمها الخاص، وكأنك تزور بلداً مختلفاً في كل ولاية، ولا يخطر على بالك أنها تحت مظلة سلطة حكومة مركزية واحدة. تراءت في خاطري تلك الولايات المختلفة حين قرائتي للخطوة الجريئة والصريحة التي اتخذها الشيخ سلمان بن حمد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، عندما تناول تباطيء بعض الجهات الحكومية والوزارات في التفاعل المطلوب مع رؤية المجلس الاقتصادية الهادفة إلى وضع البحرين في سكة التغيرات الاقتصادية في المنطقة والعالم، وما يتبع ذلك من وضع سياسات لرفع المستوى الاقتصادي للبلد ونتاج ذلك معيشياً ومعرفياً. وأما وجه الشبه بين تلك الولايات الأمريكية والوزارات الحكومية، فهي الاستقلالية التي تتبعها الوزارات، وكأن لها “حكم ذاتي” خاص بها في المنهجية والآليات المستخدمة في ترجمة تلك الرؤية بعيداً عن الجهة الوطنية صاحبة الرؤية الاقتصادية المنظمة وهو مجلس التنمية الاقتصادية. إنّ الدول التي تريد أن تبقى على الخارطة الاقتصادية العالمية عليها وضع القناة المناسبة لقيادة الصفوف الداخلية من أدوات تملكها الدولة متمثلة في الوزارات والجهات ذات العلاقة المباشرة بالحكومة، فضلاً عن القطاع الخاص والمؤسسات المتوسطة والصغيرة “إس إم إي” ، وذلك من أجل تركيز الجهود ووضعها في المكان الصحيح ضمن منظومة تلعب فيها كل جهة دورها المناسب دون التمدد على المساحات الأخرى أو الإنكماش على الداخل، وتلك معادلة صعبة في الغالب الأعم، وتكون أكثر صعوبة بل وتصل إلى مرحلة “التعقيد” والضبابية المركبة في التعامل، عندما تتبع بعض الجهات سياسة “الولايات المتحدة المستقلة” في المضي قدماً بناءً على رؤيتها الخاصة وآلياتها الموسومة باسمها الخاص، لا باسم الرؤية العامة للدولة. ونعتقد بأن تناول الصحف في الصفحات الأولى الرسائل المتبادلة بين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد وعاهل البلاد الملك حمد يوحي بأكثر من دلالة لا تخفى على المراقب الاقتصادي، حيث يمكن الوصول إلى نتيجة المراسلة بين ولي العهد وعاهل البلاد عبر تقديم البنود التشريعية الخاصة بتنظيم العلاقة بين المجلس والوزارات والهيئات الحكومية والتي أصدرها عاهل البلاد بعد ذلك من دون وضع المراسلات على صفحات الصحف، إلا أن الحكمة من ذلك أمور عديدة، منها الجهر بصوت صريح وشفاف والإشارة الواقعية إلى”الولايات”-آقصد الوزارات- التي أحاطت نفسها بهالة من البيروقراطية رافعة علم السلحفاة على مكاتبها، تلك الوزارات التي تمثل العقبات في سبيل لا مجال في ظل التغيرات بالمنطقة والعالم إلا الأخذ به، وهو سبيل الشفافية والتغيير من الداخل ووضع كل الوزارات والجهات الحكومية والقوى الاقتصادية تحت مظلة واحدة ورؤية واحدة تقودها راية واحدة، فلا مجال لتعدد الرايات بعد الآن. لقد تعامل المجلس في الفترة الأخيرة قبل أن “يطفح الكيل” مع بعض الجهات الحكومية وكأنها جزر متفرقة يصعب الوصول إليها، جزر تكوّن أرخبيل لم يستطع المجلس أن يفك طلاسمه، وكأن تياراً معارضاً يقود تلك الجزر في قبال ما يقوم به المجلس. لقد وصلت الأمور إلى حد لابد من إيقاف من يضع العصا في العجلة وذلك من خلال خطوتين هما الرفع و الدفع، تتمثل الأولى في مراجعة أصحاب المناصب ممن يتبعون سياسة السلحفاة الصماء، وذلك عبر ضمان ربط الجهات التي يتولونها برؤية موحدة تحت نظر مجلس التنمية الاقتصادية، وتوظيف الآليات المناسبة لترجمة تلك الرؤية. والثانية هي الدفع وقد اتخذها المجلس كخطوة صريحة نتجت عنها إصدار التشريعات والخطوات العملية لتفعيل خطط المجلس. بين تلك الخطوتين التي ستحد من طول أذرع بعض الوزارات، لابد من الوصول إلى “مأسسة” الرؤية الاقتصادية للبلاد، بدلاً من وجود ربانين في سفينة واحدة، وتداعيات ذلك في هدر الجهود والأموال وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي للمواطن ومركز البحرين الاقتصادي. وعلى اعتبار أن الخطوة العملية الأولى أتت من خلال بنود نظيمية للعلاقة بين المجلس والجهات الحكومية الأخرى، إلا أن ذلك هو نصف الحل، والنصف الثاني يتمثل في المصارحة والقراءة الجريئة لواقع بعض الوزارات من قمة رأسها إلى أخمص قدمها، والتي تمثل ولايات مستقلة وجزر متفرقة، ويتمثل ذلك عبر مكافحة الفساد والتمييز الوظيفي الذي يخلق حالة من الحكم الذاتي والاستقلال السلبي للوزارات، وبالتالي ابتعادها عن الرؤية الموحدة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ولئن كانت سياتل وواشنطن دي سي وميامي ولايات قائمة بذاتها إلا أن ما يجمعها دستور واحد ورؤية واحدة ضمن نطاق دولة واحدة، ونرى أن بعض الوزارات أخذت بتكوين “دولتها” الخاصة كرؤية وهدف بعيداً عن الرؤية الاقتصادية الموحدّة للوطن. فشتان بين ولاية وولاية.